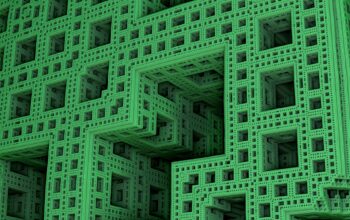نجلسُ اليومَ مُجتمعينَ في هذا الجوِّ البارد، إنَّها نهاياتُ شهر نوفمبر، والهواءُ في الخارجِ يشبهُ الهواءَ الذي يتبعُ عاصفةً ثلجيَّة، لكنَّنا ومع ذلك نجدُ من حديقةِ المكتبِ متنفَّساً بعد عدَّةِ ساعاتٍ مُتواصلةٍ من الجلوسِ على مقاعدَ خشبيَّة وأمامَنا أجهزةُ الحاسوب. نَخرجُ مُسرعينَ إلى الحديقةِ لِنبحثَ عن الشَّمسِ والدِّفء، نَستمتعُ ببعضِ المَشروباتِ السَّاخنة والوجبات الخفيفة، لِنُكملَ بعدَها رحلةَ تعلُّمنا في المَكتب، وخلالَ هذه الجَلسة التي تَستمرُّ من ساعةٍ إلى ساعات، حسبَ درجةِ احتدادِ النِّقاش، كثيراً ما تَشغلُ بالُنا أسئلةٌ غريبة، وغيرُ متوقَّعة. نُناقشُ هذه الأسئلةَ كمجموعةٍ باحترامٍ ونِظام، الجميعُ يستمعُ للآخرِ مهما كانت وُجهةُ نظرهِ مخالفةً له، وأحياناً تكونُ هذه الجَلسات مفيدةً أكثرَ من البحثِ لِساعاتٍ عن موضوعٍ معيَّن على الإنترنت، نجدُ المُتعة في الحصولِ على معلومة، من تَجربةِ إنسانٍ قد خاضَ الكثيرَ في حياتِه، ليَنقلها لنا كاملة، يساعدَنا على فهمِ وُجهةِ نظره.
بقينا أنا ولطيف جالسينَ بعدَ عودةِ الجميعِ إلى مكانهِ في المَكتب، مُتثاقلينَ منَ العودةِ ثانيةً إلى الصِّراع النَّفسيّ الذي نَخوضُه لاختيارِ موضوعِ المقالِ القادم، يأخذُنا الحديثُ من موضوعٍ إلى آخر، ويصلُ بِنا النِّقاشُ إلى التَّذمر من صعوبةِ القيادةِ مع أنظمةِ المرورِ السَّيئةِ في الأردن. يبدأُ لطيف بطَرح مجموعةٍ من القِصصِ عن رحلتِه إلى السُّويد، حيثُ أنَّ كاميرات مُراقبة السُّرعة، ليسَ الهَدفُ الأوَّل مِنها أن تُخالفَ الذينَ يَتجاوزونَ السُّرعة المُحدَّدة، و إنَّما هي وسيلة لِتضمنَ سلامةَ المُواطن. حيثُ أنَّ هنالك شاشاتٌ مُثبَّتة قبلَ الوصولِ لهذه الكاميرات، تَعرِضُ لكَ السُّرعة التي قد وصَلتَ لها عندَ مرورِك بها مع وجهٍ مُبتسم، إن كنتَ ضِمن السُّرعة المَطلوبة، ووجهٍ غاضبٍ إن كُنتَ قد أسرعتَ وتجاوزتَ هذهِ السُّرعة. أُُعجبُ أنا بِهذا الطَّرح، و أتذكَّر صديقي أنطونيو عِندما وصلَ إلى الأردن من إيطاليا، كيفَ كان يُواجهُ صعوبةً بالغة في عبورِ الشَّارع وخُصوصاً عند الدُّوَّار، لا أحد يعبىء لِلمُشاة، لا توجدُ إشاراتٌ تُنظِّمُ الحركة، حيثُ يصفُ هذه الرِّحلة بأنَّها رحلة الموت، مرَّتَين يوميّاً، عندَ قدومهِ ومُغادرتِه المَكتب، أَضحكُ بِداخلي، واستغربُ من قُدرتِنا على التَّعود على مثل هذه الأمور، وأنَّها أصبحت شيئاً عاديّاً جدّاً بالنِّسبةِ لنا، والشَّيءُ الطَّبيعيُّ في يومِنا، بل وشيئاً نستفقِدُه إن لم نَجِده.  الكثيرُ من هذه المُقارنات في القوانين يَخطُر على البال، والتي نَصِفُ بها المُجتمع الغَربيّ بالتَّحضُّر والرُّقي، هل لو كان القانونُ المُتَّبعُ في تلكَ الدُّولِ مُختلفاً، سيكونُ الوضعُ القائمُ أيضاً مختلف، أم أنَّ وازعَهم الأخلاقي هو الذي يَجعلهم يُطبِّقونها؟ كيف هو الحالُ لو أُبطلَت جميع هذه المخالفات و لم يكن هنالكَ أيُّ عقابٍ مُقابلَ الأفعالِ الخاطئة؟
الكثيرُ من هذه المُقارنات في القوانين يَخطُر على البال، والتي نَصِفُ بها المُجتمع الغَربيّ بالتَّحضُّر والرُّقي، هل لو كان القانونُ المُتَّبعُ في تلكَ الدُّولِ مُختلفاً، سيكونُ الوضعُ القائمُ أيضاً مختلف، أم أنَّ وازعَهم الأخلاقي هو الذي يَجعلهم يُطبِّقونها؟ كيف هو الحالُ لو أُبطلَت جميع هذه المخالفات و لم يكن هنالكَ أيُّ عقابٍ مُقابلَ الأفعالِ الخاطئة؟
بقيتُ أفكِّر في هذا الموضوعِ طوال اليوم، ماذا لو لم يَكُن هنالكَ قوانين تُنظِّم حياتَنا، كيفَ من المُمكن أن تَكونَ الحياةُ قبل وضعِ القوانين؟ وما الفرقُ بين تَصرُّف الإنسانِ الطَّبيعي و الذي يأتي بِالفطرة، بِوضعِنا الحالي؟ هل وجودُ القوانينِ يَمنعُ الجريمةَ أو الُمخالفة؟ أم أنَّ عدمَ وجوده لن يُحدث فرقًا يُذكر؟ أغمِض عينَيك لدقيقتَين وتخيَّل ماذا لو أنَّ مجموعةً من الأشخاصِ يعيشونَ في مكانٍ واحدٍ لِفترةٍ مُعيَّنة من الزَّمن، ما الذي سوفَ يتحكَّم في تَصرُّفاتِهم تجاهَ بعضهِم البعض؟ وهذا بالضَّبط كانَ السُّؤال الذي طَرحتُه خلالَ استراحةِ الغداء في اليومِ التَّالي، تقولُ لاورا: بأنَّ القانونَ ليسَ هو الشَّيء الذي يمنعُ الإنسانَ من ارتكابِ خطأٍ من عدمِ ارتكابِه. وتَعرضُ لنا هنا مقارنةً في الأنظمةِ المُتَّبعة في ألمانيا وإيطاليا، إنَّها قوانين مُتشابهه ولكنَّ النَّاس الذين يَعيشونَ في ألمانيا يتَّبعونَ هذه القوانين، أمَّا الأشخاصُ في إيطاليا –حسب ذكِرها-، فإنَّهم يَتفنَّنونَ في عدمِ اتِّباعِها ويَعتبرونَ عدمَ اتِّباعِها ذكاءً و قدرةً على العِصيان. تقولُ لاورا بأنَّ التَّعليم في المراحلِ الأولى هو الذي يُحدِّد المُمارسات التي يَتَّبعها الفرد، فإن بيَّنّا لطفلٍ خطرَ التَّصرفاتِ الخاطئةِ على حياتِه لاحقاً، سوفَ يستطيعُ التَّمييزَ عندما يكبُر، ولن يَرتكبَ هذه الأخطاء، حتَّى في غيابِ القانون.
تُضيف بأنَّ القوانين يجبُ أن تكونَ كحبَّة الدَّواء، نستخدِمها عندَ شعورِنا بالمرَض، ولكن لا حاجةَ لها في الوضعِ الطَّبيعي. بينما يقولُ أمير: بأنَّ المكانَ والزَّمان هما المُحدَّدان، واللَّذان ترتكزُ عليهِما تصرُّفاتُ الإنسانِ ومبادِئه، وأيضاً اتِّباعه لدينٍ معيَّن من عدمه، لأنَّ الدِّيانات والكُتب السَّماوية هي كالدُّستور الذي يُنظِّم حياةَ الفَرد، بينما سَنشهَد الكثيرَ من العبثيَّة وسيكونُ البقاءُ للأقوى في غيابِ القانون. تعرِض زين: حديثًّا نبويًّا شريفًا و تَقول “إذا كُنتم ثلاثةً فأمروا أحدَكم”، تُضيف هزار: بأنَّ الأسرة هي التي تُحدِّد سلوكَ أفرادِها، وتقولُ رزان: وإن كان هؤلاءِ الأبوَين سيِّئَين؟، أضحكُ وأُضيف: إذن سَيورِثونَه السُّوء. لكن بالتَّأكيد ليسَ كلُّ إنسانٍ سَيرثُ ما علَّمهُ أبواهُ إن كانَ خيراً أو شرّاً. تُشير نجوى: بأنَّ كلَّ الدُّول تَسعى اليوم لأن تَكونَ دولةَ حقٍّ وقانون، فالقانونُ يَحفظُ حقوقَ المُواطنين، وينظِّم سلوكَ الأفرادِ والجماعاتِ تنظيماً يُحقِّق الاستِقرارَ والأمنَ لِلجميع.
يقولُ أنطونيو: بأنَّ في كثيرٍ من الأحيانِ لا يكونُ النِّظامُ والقانونُ المتَّبع في الدَّولة مُتوافقاً مع ثقافةِ الشَّعب، وهذا الذي يدفعُ النَّاس إلى ارتكابِ الجرائمِ والمُخالفات، وإن كان ذلكَ سيجعلُهم يدفعون الثَّمن، مادِّياً أو بِطرقٍ أُخرى. تُضيف رزان: بأنَّ حسّ المسؤوليَّة هو الذي سيظهَر في غيابِ القانون، وتقولُ رُبى: بأنَّها فكرة مُرعبة ليفكِّر بها المرء، لأنَّ القانون هو الذي يدفعُ الأشخاصَ لتحمُّلِ بعضِهُم البَعض. في نهاية النِّقاش تقول كارولين: بأنَّ أوَّل كلمةٍ من الممكن أن تَخطرَ على بالِها هي الفوضويَّة، لأنَّ القانونَ حاجةٌ أساسيَّة لاحترامِ الآخرينَ و الطَّبيعة، ولن يكونَ بِالتَّأكيدِ عالماً مثاليًّا مبنيًّا على الحرِّيات بدونِ القانون، بل سيكونُ غير واقعيٍّ وغيرَ آمن، ولكن أيضاً وجودُ القوانين الصَّارمة قد تكونُ قاتلةً للإبداعِ والحريَّات هي الأُخرى، ولذلكَ وُجِدت الوسطيَّة والاعتِدال.
نُنهي الحديثَ بتوجُّسٍ من هذا السُّؤال، الذي دفَعَنا لِنُفكِّر أكثرَ في الاختِلاف من حَولِنا في اختلافِ الشَّخصيَّات والاحتياجات من شخصٍ لآخر، أَنظرُ أنا إلى الأمر من وُجهةِ نظرٍ أخرى، وأتخيَّل ماذا لو لم يكُن هناك قانون، الحياةُ مع وُجودِ القانونِ شيءٌ كارثي، بل ومُرعب، في أغلبِ الأحيان. فكيفَ هي الحياةُ مع عدمِ وجودِه، الجرائمُ سَتكثُر والحقوقُ سَتُستَنزف، كما لو أنَّنا طبَّقنا قانون الغاب، بأنَّ البقاء للأقوى، ولكنَّنا كرَّمنا الله بأنَّ لنا عقلاً يُميِّزنا عن كافَّة مخلوقات الأرض، وهو الشَّيء الذي سيقودُنا بِطبيعةِ الحالِ إلى إنشاء قانونٍ خاصٍّ بنا، وحتى وإن كان هذا القانون ليس مَكتوباً، ولكنَّه سيكونُ معروفاً ومُمارساً بطبيعةِ الحال، مع مرورِ الزَّمن، من المُمكن أن يكونَ ليسَ مُنصِفاً للبعض، ولكنَّه سيكونُ مُتَّبعاً ومُتوارثاً.
النَّشأةُ الأولى للقانون، هي عن طريقِ الأعرافِ والأخلاقِ المُتوارثة في المجتمع، أو المأخوذة من كتبٍ سماويَّة، تُبيِّن الصَّوابَ والخطأ، والطَّريقةَ المُتَّبعة في حدوثِِ خللٍ مُعيَّن، كيفيَّةَ التَّصرُّفِ معه، حيثُ تحوَّلت هذه الأحكامُ فيما بعد إلى مجموعةٍ من القواعدِ العُرفيَّة التي اعتادَ النَّاس على اتِّباعها بِتكرارِ الحوادِث، واتِّحادِ حُكمها أو تَماثُله للفكرِ الإنساني، ولكنَّ الإنسانَ بطبيعةِ الحال، لم يَتصوَّر في مرحلةِ طُفولتِه وجودَ قانونٍ ما، فليَكُن قانونَ الفِطرة السَّليمة، بأن لا نُؤذي ولا نُسبِّب الضَّرر لأيِّ مَخلوق، إن كان بشراً أو شجراً أو حيواناً، فلتكُن أنتَ الرَّقيب على أفعالِك، ولا تَنتَظر القانون لِيَردعَك.
إسراءْ مَنصورْ