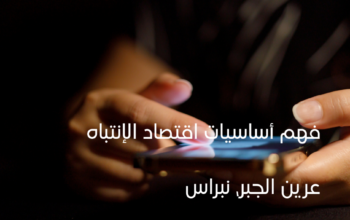بين الواقع الحقيقي والافتراضي هناك صراع قائم ومتجدد، ألا وهو صراع الهويات، الهوية عبارة عن مجموعة من المقومات الثابتة، المتحولة والمتغيرة، وتكون هذه المقومات الاساسية مكونة للخصوصية المميزة لكيان كل فرد عن الآخر، لكن قد تتقاطع في بعض الأحيان في قواسم مشتركة مع أشخاص آخرين. هذه المقومات تتكون من (الدين، الثقافة، اللغة، الجنس، الأرض والتاريخ). الهوية كاللوحة الفنية يرسمها كل فرد عن نفسه انطلاقاً من تجاربه وخبراته التي يبنيها من تفاعلاته مع الآخر. ولكن في ظل التكنولوجية الحديثة، تقوم هذه التكنولوجية على تعويض الهوية الحقيقة للفرد، وتنسج هويات له غير متعلقة بالحيز المكاني وتقلل من الشعور بالانتماء إليه. مع التناسل الغير المحدود من التقنيات وعولمة التكنولوجيا والإعلام، ظهرت على أرض الواقع الهويات الافتراضية، في رأي الكاتب عبد الحكيم أحمين عن مصطلح الهوية قال:
“الهوية هي معرفة وإدراك الذات القومية ومكوناتها من القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، وهي سمات وخصائص يتميز بها شعب ما عن غيره من الشعوب، وتربط هذه السمات بالسلوكيات العامة لمجموع الأفراد والعلاقات السائدة، والمنتج الفني والثقافي، لهذه المجموعة أو هذا المجتمع”.
الهوية الافتراضية نؤسسها كمستخدمين للإنترنت في المجتمعات الرقمية. هي المفتاح الذي يفتح بوابة المواقع الإلكترونية، تكون على شكلين: الأول أسماء حقيقة تدل على شخصياتنا الواقعية التي نتعامل بها على أرض الواقع، والشكل الثاني يكون قائم على أسماء مزيفة (مستعارة) لا تمس للواقع بصلة، و هذا الشكل يفضله أغلبية المستخدمين للمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت بأن يبقوا مجهولين الهوية. هي تتسلل إلى حياتنا اليومية بشكل مخيف، حيث اصبح كل شيء عن طريق الانترنت، من تسوق وشراء المنتجات في أي منطقة بالعالم إلى الخدمات الإلكترونية التي تحقق التسهيلات: (لعملاء البنوك، دفع الفواتير، تجديد الأوراق الثبوتية… إلخ). مما تعزز انتشار المتزايد للحكومات الإلكترونية، في الوزارات والتعاملات المالية وكذلك المؤسسات الأخرى، وتطورت هذه الهوية درجة استخدمها في التصويت في الانتخابات مثال عليها: (الانتخابات الأميركية)، وهنا يبرز دور أجهزة الدولة الرقابية من جديد على هذا الفضاء، من أجل الحد من الفوضى وحماية الخصوصية.
الهوية ليست ذات حدود جغرافية وتسبح في فضاء الإنترنت وتتفاعل مع الآخرين عبر النص أو الصوت أو الصورة أو الرموز. من هنا يمكننا أن نحدد للهوية الإلكترونية ثلاث خلفيات:
- الإطار الذاتي للشخصية (الهوية الوطنية الواقعية).
- الإطار الافتراضي للشخصية (الهوية الافتراضية العالمية).
- الإطار الثقافي الطبيعي.
إلا أن الهوية الافتراضية تنحصر ضمن ثلاثة مستويات:
- الهوية المعلنة؛ هي المعلومات التي يقدمها المستخدم قد تكون حقيقية أو مزيفة.
- الهوية النشطة؛ هي النشاط الذي يقوم به المستخدم في العالم الافتراضي.
- الهوية المحسوبة؛ هي حالة المستخدم في أثناء اتصاله بالإنترنت (أون- لاين) أو (أوف- لاين).
هي عبارة عن قوة جبارة في التجربة البشرية سواء كانت إيجابية أم سلبية حيث أنها تجذب المزيد من الأفراد نحو العصر الرقمي. لأهمية الدور الذي تلعبه الهوية في المجتمع الرقمي، يجعلنا رسم التصورات للمسارات التي تمر بها الهوية في هذه الفترة على الأقل. إن خياراتنا وقراراتنا بشأن تصميم وتنفيذ أنظمة الهوية الرقمية اليوم تحدد معالم المستقبلات الممكنة غدا. ما هذه المستقبلات؟
تنقسم هذه المستقبلات إلى 3 أقسام:
- المستقبل الأول: يحتوي على ظهور الفقراء والأثرياء الرقمين.
- المستقبل الثاني: عنوانه (لا خيار، ولا ثقة ولا حقوق)، حيث الحكومات أو الشركات التي تدير أنظمة الهوية والبيانات الشخصية تخاطر بفقدان ثقة العملاء والزبائن.
- المستقبل الثالث: عنوانه الإدماج التحولي فهو يتيح التحولات الشاملة، ويضمن الحريات الشخصية والأمن والاحترام والقيمة والفرصة.
من هنا يمكننا أن نصل إلى عناصر الهوية الرقمية، أي تلك التي تقدم قيمة حقيقية، تتضمن هذه العناصر: التناسق مع الهدف، والإدماج، والإفادة، وتوفر الخيارات، والأمن. برأي فاتن صبح بالهوية الرقمية قالت “فإذا أحسن الفرد تصميم هويته الرقمية، فهو بذلك يعزز الإدماج في كافة نواحي الحياة تقريباً وبطرق متغيرة”. وقالت أيضا، “أن هويتنا غالية، ولا بد لكل برنامج هوية رقمية أن يرتكز إلى تمكين الثقة والتحكم والمحاسبة المجدية“.
أيضا، هناك من يرى أن الهوية الافتراضية هي انعكاس للهوية الحقيقية (عندما تكون المعلومات المعطاة صحيحة). وتسمح بأن يكون الفرد أكثر نشاطًا عن الهوية الحقيقية، وذلك لأنها تتجاوز الحدود من دون القيود الموجودة في الواقع. إلا أن هذه المجتمعات تسمح لمجهولي الهوية بالنشاط والتفاعل. للهوية الافتراضية فوائد وسلبيات متعددة، فهي تمنح الحرية للمستخدم وكذلك توسع الواقع لديه من الناحية الإيجابية. إلا أن سلبياتها أكثر، المستخدم لا يبالي في الكشف عن خصوصياته وما يترتب عليه من عواقب، ازدواجية الشخصية أو انفصامها للفرد بين الواقع والافتراض، احتمال تعرض الهوية الافتراضية للقرصنة، فيضان من المعلومات التي تؤثر في تفكير المستخدم. الهوية الإلكترونية ليست مجالًا للمناقشة الفكرية، بل هي أسلوب حياة ضرورية لكثير من الناس، فهل ستعيش الهوية الافتراضية الصراعات والتناحرات الموجودة للهويات الواقعية.
سوزان غرينفيلد (مواليد 1950)، عالمة وكاتبة بريطانية متخصصة في فسيولوجيا العقل. كتبت (غرينفيلد) العديد من الكتب العلمية المبسطة عن الدماغ البشري لغير المتخصصين، وتعمل حاليا زميلًا بحثيا أول في كلية لينكولن بجامعة أكسفورد، وتترأس فريقًا يبحث في تأثير تكنولوجيا القرن ال21 على الدماغ، والآليات الدماغية المتعلقة بالأمراض التنكُّسِية العصبية مثل؛ الزهايمر والباركنسون. نشرت العديد من الكتب حول العقل والدماغ، منها كتاب (تغيّر العقل: كيف تترك التقنيات الرقمية بصمتها على أدمغتنا)، الذي ترجمه إلى العربية (إيهاب عبدالرحيم علي، ونشره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت في فبراير 2017. في الكتاب ناقشت (غرينفيلد) تأثير التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هوية الإنسان فتقول:
شبكة الإنترنت توفر للأفراد فرصة فريدة للتعبير عن الذات، والتي تشجع الناس على الكشف عن ذواتهم الحقيقية، بما في ذلك الجوانب التي لا يعبّر عنها بشكل مريح وجها لوجه. وبسبب هذا التأثير، يمكن النظر إلى التواصل عبر الانترنت على أنه أكثر حميمية وشخصية من الاتصال وجها لوجه… وخلافًا لما يحدث في العالم الحقيقي، تكون هوية الفيسبوك ضمنية أكثر من كونها صريحة؛ يُظهر المستخدمون مشاعرهم بدلًا من أن يقولوها، من خلال تأكيد ما يحبونه وما يكرهونه بدلا من التوسع في سرد سيرة حياتهم، واستراتيجيتاتهم والسبل التي يستخدمونها للتعامل مع المشكلات وخيبات الأمل، وجميع الأمتعة الأخرى للحياة الطبيعية. وتحدثت عن الفرق بين الذات الحقيقية “وراء الكواليس” والذات الشبكية في “المشهد الأمامي” فتقول:
تُظهر الأبحاث أن الهوية التي تُصوَر على الفيسبوك هي ذات مشيدة عن عمد ومرغوبة إجتماعيا، يطمح إليها الأفراد لم يتكمنوا حتى الآن من تحقيقها. ومما يثير الدهشة أن التواصل عبر الشبكات الاجتماعية قد أدى الآن إلى ثلاث ذوات محتملة:
- الذات الحقيقية true self، التي يُعبّر عنها في البيئات المجهولة الهوية من دون قيود القيود التي تفرضها الضغوط الاجتماعية.
- الذات الفعلية real self، أي الفرد المتوافق المقيد بالأعراف الاجتماعية للتفاعلات التي تتم وجها لوجه.
- الذات المحتملة possible self، والتي تظهر لأول مرة، والمأمولة، التي تُعرض على مواقع الشبكات الاجتماعية.
وقالت أيضا إن التفاعل من خلال ملف على الإنترنت يمثل فرصة للإعلان عن نفسك من دون تحد من قيود الواقع، بحيث تصبح نسخة مثالية منقحة من ذاتك “الفعلية“. يخشى اختصاصي علم النفس السريري (لاري روزين) أن ثمة فجوة خطيرة قد تنمو بين هذا “المشهد الأمامي” المثالي لذاتك وذاتك الفعلية “وراء الكواليس“، مما يؤدي إلى الشعور بالإنفصال والوحدة. وتكمل حديثها عن الضغوط النفسية التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي فتقول:
من الممكن أن يفتح الفيسبوك عالما بديلا يستطيع الفرد فيه الهروب من الواقع وأن يكون الشخص الذي يود أن يكونه. وكذلك فنحن نتعرض للحياة “المثالية” ونحن نقرأ عن الناس الذي يبدو أنهم يمتلكون كل شيئ والذين يبتسمون دائمًا. تزيد هذه الحياة، التي تبدو رائعة، من الضغط الواقع علينا لكي نصبح مثاليين، ومثيرين للإعجاب، وناجحين: وهو هدف يؤول مصيره حتمًا إلى الفشل… من خلال الاعتماد على الفيسبوك لتلبية هذه الحاجة إلى الاستحسان، فإن نظرة المستخدمين إلى أنفسهم لا تتضاءل بصورة مطردة فقط، لكنهم يتوقون أيضًا باستماتة إلى أن يلاحظ الآخرون وجودهم ويتفاعلوا معهم. وهذا بدوره يساعد على اكتساب هوية مبالغ فيها أو مختلفة تمامًا: أي الذات المأمولة والمحتملة.
وناقشت كيف أن ثقافة التواصل الاجتماعي قد تؤهل المستخدمين لامتلاك عقلية نرجسية فتقول:
يبدو الفيسبوك أداة تحويل كل من المعارف والمقربين والآخرين غير المعروفين إلى جمهور للعروض الذاتية التي تتسم بالفردانية… قد يمثل العرض الذاتي الجماهيري على مواقع الشبكات الاجتماعية واحدة من الطرق التي يقوم بها الشبان اليوم بتفعيل القيم المتزايدة للحصول على الشهرة والاهتمام.
رزان الظاهر