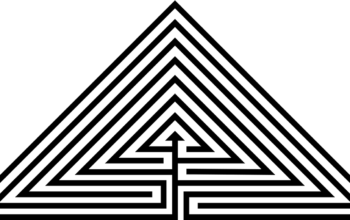لطالما فكَّرتُ في هذهِ المواقعِ التي نَنتَقِدُها دائِمًا ونقولُ أنَّنا كنَّا بِخيرٍ من قَبلِها، مواقعُ التَّواصلِ الاجتماعيِّ التي يَكرهُها كثيرونَ رغمَ استِخدامِهم لها، وأحيانًا إدمانِهم عَليها. لكن إذا انغمَسنا في التَّفكيرِ سَنجدُها رغمَ ذلكَ ذاتَ أثرٍ عظيمٍ على مُجتمعِنا ولها فَضلٌ كبيرٌ في نُضوجِ الفِكر العام. يَكفي أنَّها وفَّرت لنا مساحةً كبيرةً لِطرحِ جميعِ الأفكارِ ولكَ حُريَّة الاختيارِ في تَبنِّي بَعضِها أو لا. مَن منَّا لم يَستفِد من هذه المواقعِ في شيءٍ واحدٍ على الأقلِّ انعكسَ على حياتِه؟ الطَّبخ، الفن، التَّنظيمُ والتَّرتيب، تَطويرُ الذَّات، والكثيرُ من المواضيعِ الحياتيَّة المُهمَّة والتي جَميعُنا نَحتاجُ أن نَعرِفَها بل نَعرفُ ما نَجهلُه عَنها بالذَّات!
مُعظمُنا لم يَكُن يَتقبَّلُ الكثيرَ من الأفكارِ الجَديدة، خُصوصًا لو شاهدَ أحدُهم يُخبِرَه بِها أو يَفعلها، لا فكانَ عليهِ أن يَفهمَها ويَتشبَّع بِها حتَّى يؤمن بِمَنطقيَّتِها. الثَّقافة الإعلاميَّة لها معنى ومَدلول أشملُ وأعمُّ من مُجرَّدِ مَجموعةِ أخبار، أو حوادِث، أو حتَّى أفلام وإعلانات، أو تواصُلٍ عبرَ الفيسبوك. من هذا المُنطلقِ تَوجَّه العالم إلى المزجِ والدَّمج بينَ استخداماتِ الكمبيوتر، وبينَ العُلومِ الاجتماعيَّة أي مَجالات الدِّراسة والبَحث الجَديدة. تتَّجهُ لأن يبدأَ الباحِثونَ والدَّارسونَ فى تطويعِ التِّكنولوجيا للاستِخداماتِ الإعلاميَّة ودمجِ الذَّكاءِ الاصطِناعيِّ مع الذَّكاءِ البَشريِّ بِمعنى أنَّ جامعةً مثلَ جامعةِ أكسفورد أن تُنشِأَ معهدًا مُتخصِّصًا فى علومِ الإنترنت وكيفيَّة استِخدامِ الحُكوماتِ أو بعضِ المُنظَّماتِ للإنترنت وشبكاتِ التَّواصل فى تحريكِ الشُّعوبِ والتَّأثيرِ عَليها سَلبًا وتوجيهِها نحوَ سياساتٍ وسلوكيَّاتٍ مُعيَّنة.
من هذا الصَّدد عَلينا أن نبدأَ فى الاهتِمامِ والانتِباهِ والالتِفاتِ إلى أهمِّيَّة محوِ الأمِّيَّة الإعلاميَّة خاصَّةً بعدَ أن أصبحَت السَّمواتُ مفتوحةً ولا حدودَ ولا قيودَ على استِخداماتِ الإنترنت ووسائِل التَّواصُلِ الاجتماعي. وكيف أنَّ هُناكَ كتائِب إلكترونيَّة مُتخصِّصة فى نشرِ الشَّائِعاتِ والأخبارِ الكاذبةِ والتى تَخلقُ حالةً من التَّوتُّر والبَلبلةِ والقلقِ وعدمِ الاستِقرارِ الاجتماعيِّ بجانبِ أنَّ هناكَ أيضًا كتائبٌ تعملُ على زَعزعةِ الثِّقةِ فى الدَّولةِ والنِّظامِ والسُّلطة. لِذا فإنَّ علومَ الحاسبِ عَليها أن تُدمجَ مع علومِ الإعلامِ والاجتِماعِ والفنِّ لِنصلَ إلى صيغةٍ علميَّة وأكاديميَّة قادرة على إعلامِ وتنويرِ مُتابِعي الإعلامِ والمُتلقِّي. محوُ الأمِّيَّة الفِعليَّةِ كتابةً وقراءةً لأنَّ العصرَ الحاليَّ هو عَصرُ المعلوماتِ والسَّموات المَفتوحةِ كذلكَ على الدَّولة البِدءُ فى إنشاءِ مَرصدٍ إلكترونيٍّ من قِبلِ جهاتٍ علميَّة لِمُتابعةِ الكتائبِ الإلكترونيَّة وتحليلِ المَضمونِ وعرضِ النَّتائجِ والأكاذيبِ والمَعلوماتِ الكاذِبةِ على الرَّأي العامِّ بِالسُّرعةِ والدِّقَّة والشَّفافيَّة التى تَتناسبُ مع سُرعةِ هذا الوحشِ الإلكترونيِّ الفضائيِّ المُسمَّى بالإنترنت. إذا كنَّا نُعاني فى الماضي من الأميَّة؛ فإنَّنا اليوم أصبَحنا فريسةً لأكبرِ عمليَّةِ مسحٍ بشريٍّ تَجري على العقولِ وعلى النُّفوسِ عبرَ تلكَ الأميَّة الإعلاميَّة التى عَلينا أن نُواجِهَها ونعرفَ معناها، ومَغزاها، ومدى خُطورتِها السِّياسيَّة والاجتِماعيَّة.
نَحتاجُ إلى تَعزيزِ الاتِّصالِ ومحوِ الأميَّة المَعلوماتيَّة، وصياغةِ شراكاتٍ مَلموسةٍ لِدَفعِ عمليَّة تنميةِ الاتِّصال، إضافةً إلى السَّعي لِتحقيقِ التَّكامُلِ في المناهجِ التَّعليميَّة في ما يخصُّ مفهومَ التَّربيةِ الإعلاميَّة، وتَدشينِ الفرعِ العربيِّ من التَّحالفِ العالميِّ من أجلِ الشَّراكاتِ حولَ الاتِّصالِ ومحوِ الأميَّة المعلوماتيَّة. كما أنَّ هناكَ عددًا من الإشكاليَّات في الوقتِ الرَّاهن أهمُّها أنَّ المواطنينَ العرب أصبَحوا يَلهثونَ وراءَ التِّكنولوجيا لدرجةٍ قُد تُضيِّع هذه المُجتمعات، وتَطمُس هويَّتها في إطارِ مَفهومِ استِهلاكِ المعرفةِ أو الاستِخدامِ غير المسؤولِ لَها. سببُ انتِشارِ الأميَّة الإعلاميَّة الرَّقميَّة المُباشر هو عدمُ وجودِ الوعيِ الكافي لدى الجُمهور، ممَّن لا يُحسِنونَ استِخدامَ وسائل الإعلامِ الرَّقمية، ولا يَعرِفونَ تأثيرَها، والتي بدأَتْ تأخُذ مَنحًى كبيرًا بعد انتِشارِ مواقعِ التَّواصلِ الاجتِماعيّ.
هناكَ أيضًا إشكاليَّةُ العِنايةِ بالوعيِ الإعلامي، وخلقُ ثقافةِ التَّفكيرِ النَّقديّ التأمُّلي. إذ أنَّنا نعيشُ في بيئةٍ مُشبعةٍ بالمواد الإعلاميَّة، وينبغي لنا أن نعي أنَّ وسائلَ الإعلامِ لا تُقدِّمُ مجرَّد عرضٍ بسيطٍ للواقعِ الخارجيّ. بل هي تَعرِضُ تراكيبًا مُصاغةً بعنايةٍ تُعبِّرُ عن طائفةٍ من القراراتِ والمصالحِ المُختلِفة، والوعي الإعلاميّ يساعدُنا على تفكيكِ عمليَّة تَصنيعِ المواد الإعلاميَّة، وعلى فهمِ المُنتجاتِ الإعلاميَّة، وكيفيَّة استِخدامِها. هذا ما دفعَ مربِّينَ أمثال جورج لوكاس إلى القول إذا لم يَعلم الطَّلبة لغةَ الصَّوتِ والصُّورة، فإنَّنا نَعتبرُهم أمِّيِّينَ تمامًا، كما لو تَركوا المَدرسةَ دونَ معرفةِ القراءةِ والكِتابة. فَنحنُ مُجتمعٌ أمِّيٌّ بصريًّا لا نعرفُ أنَّ الصُّورةَ نصٌّ مُجرَّد، يجبُ أن تُقرأَ بِعناية، وأنَّ لا معنى للصُّورةِ دونَ قراءة، وفهمُ الصُّورةِ يعني فهمَ ألوانِها، ورُموزِها وتاريخِها ودرجةِ إضاءتِها. فالطَّالبُ النَّاجحُ هو طالبٌ ناشِط، ناقد، يفهمُ لغةَ الإعلامِ من صورٍ ونصوص، ومحتوى.
لا وسيلةٌ طبعاً لصدِّ هذا المدِّ الرَّقميِّ بل العكسُ صحيح، فَعلينا أن نَتزوَّدَ بكلِّ المهاراتِ الحديثةِ لتعلُّمِ ركوبِ هذا المدِّ والخوضِ فيه بكلِّ براعة. هذا يُحتِّم على كلِّ المُجتمعِ ومؤسَّساتِه وبالأخصِّ مؤسَّساتِ التَّعليمِ والتَّدريبِ لِتطويرِ برامِجها لِمحوِ الأميَّةِ الرَّقميَّة وجَسرِ الفجوةِ بينَ أبناءِ هذا الجيلِ والأجيالِ السَّابقة، وبينَنا وبينَ التَّطوُّرِ الرَّقمي الهائلِ الذي نُعاصِره، والذي سوفَ نُدركُه في المُستقبل. كما حُتِّمَ علينا التَّطوُّر الرَّقمي مَحوَ الأميَّة الرَّقميَّة، على الجامعاتِ وبُحوثِها العلميَّة أن تكونَ نِبراساً للابتكار وقادرةً على تجهيزِ المُتعلِّمينَ لما يُخفيهِ لهم المُستقبلُ بينَ طيَّاتهِ والتَّنبُّؤِ بصورةِ العالمِ في المُستقبلِ وتوقُّعِ مُتطلَّباتِ الأميَّة القادِمة والاستِعدادِ لها. سَنجدُ تلوُّثاً معلوماتيًّا هائِلاً وتَلوُّثاً فِكريًّا يجبُ التَّخلُّص منهُما أولاً قبلَ التَّفكيرِ في الدُّخولِ إلى عصرِ المعرفةِ أو بِكلمةٍ أدقُّ إلى العصرِ الذي يَعتمدُ في اقتِصادِه على المَعرفةِ بِمعناها الأوسَع.
نعم سوفَ نجدُ المُحتوى التَّافِه الذي لا معنى له، سَتجدُ فراغًا عظيمًا في حِساباتِ بعضِ المشاهير، وسَتشعُر بانعكاساتٍ سلبيَّة على حياتكَ سبَّبتها السوشال ميديا، لكن في حقيقةِ الأمرِ يجبُ أن نُراجعَ جميعَنا طريقةَ استِخدامِنا لها، من نُتابع؟ ولم؟ مالذي أبحثُ عنهُ هُنا؟ وأينَ أجِده؟ وكيفَ أجعلُ هذا المكانَ صحِّيًّا أكثرَ لي؟ إنَّ التَّخلُّصَ من هذه المُشكلة لا يُمكن أن يتمَّ إلا عبرَ وجودِ ثقافةٍ إعلاميَّة مجتمعيَّة ومؤسَّساتيَّة. يُمكنُنا القولُ إنَّ الأميَّة التِّكنولوجيَّة يُمكنُ تجاوُزُها في الدُّولِ الفقيرة، لكن لا جَدوى من ذلكَ إذا لم يُفهم من تِلكَ العمليَّة أنَّها من أجلِ استِخدامِ التِّكنولوجيا في سبيلِ اكتِسابِ المَعرفةِ والاستِمرارِ في مشوارِ العلمِ والتَّعلُّم، وأنَّ التِّكنولوجيا ليسَت سِوى أداة فَقط لِتسهيلِ عمليَّةِ التَّواصُلِ مع العالمِ والاستِفادةِ من معارف وخبراتِ الآخرين وتَجارُبهِم، وليسَت التِّكنولوجيا غايةً في ذاتِها كَما يَفهمُها الكثيرُ توهُّماً وخَطأً.
عَدا ذلكَ تُواجهُ الكثيرُ من الدُّولِ النَّامية العديدَ من التَّحدِّياتِ تَتمثَّلُ في القضاءِ على الأمِّيَّة التَّقليديَّة من جِهة، والأمِّيَّتَين المَعلوماتيَّة والمَعرفيَّة من جِهةِ أُخرى، هذا يَتطلَّبُ بناءَ بيئةٍ مَعرفيَّة. ولا نَنسى ضرورَةَ تَغييرِ الدَّورِ التَّقليديِّ لِلجامِعات، ليسَ فقط على صعيدِ البَحثِ العِلمي، بل على صعيدِ الابتِكارِ أيضا. فَفيما يُؤدِّي البحثُ العِلميُّ إلى توليدِ مَعرفةٍ جديدة، فإنَّ الابتكارَ يؤدِّي إلى إنتاجِ سِلَعٍ وخدماتٍ جديدَةٍ مبنيَّة على تِلكَ المَعرفة..
هَزارْ مَسعودْ