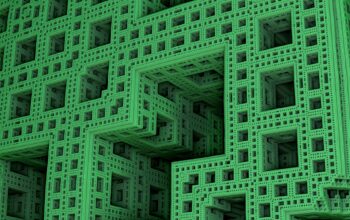غُرفةٌ صفيَّةٌ مليئةٌ بالألوان، هي بيئةٌ تُحفِّزُ الإبداعَ والابتكار، فيها رفوفٌ تحملُ مهاراتِ الحياة، ومُستقبلاً مُبهراً يختبئُ بينَ الأدوات. هناك معلِّمٌ يرقصُ نغماً على تَفاعلِ الأطفال، وكلُّ هذا بعيداً عن نِظام الاختبارات، وثقلِ الواجبات، فهل نحنُ في مدرسةِ الأحلام؟! العالمُ في تطوُّر سريع، ومواكبةُ هذا التَّغيُّر الملحوظ يتطلَّب التِّقنيَّة العالية والابتكار المستمر. مع هذه التَّغيُّرات يُصبح هناك فرصٌ جديدةٌ متاحةٌ للتَّعليم وامتلاكِ المعرفةِ يُحقِّق فائدةً كبيرةً في مُختلفِ مجالاتِ الحياة، وتُتيح للشَّخص زيادةً في الوعي والإدراك، واتِّساع الآفاق.
لكن، أصبحَ النِّظام التَّعليمي حِملاً ثقيلاً على الأطفال، وغيرَ ذلك هو أيضاً نِظامٌ جامدٌ غير مُمتع، ويُشكِّل عِبءاً عليهم في تفاعُلاتهم مع الحياةِ ومعَ البيئةِ التَّعليميَّة المُحيطة بهم، ممَّا يَجعلُ التَّعليمَ عمليةً اعتياديَّةً مؤقَّتة يَنتظرُ الأطفالُ الانتهاءَ مِنها بأسرَعِ وقتٍ مُمكِن. وهذا ما يَجعلُهم يَنتقلونَ من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ دونَ اكتِسابِ أيِّ من المهاراتِ العِلميَّة والعَمليَّة الصَّحيحة بِشكلِها الطَّبيعي، وبالتَّالي سوفَ يتعرَّضون إلى صَدماتٍ مُتتاليةٍ عند انخراطِهم في المجتمعِ بشكلٍ أوسعٍ ومُباشر. كين روبنسون عِندما تَطرَّق لِموضوع التَّعليم في مُحاضرته، ناقشَ مدى اهتمامِه بالتَّعليم، والتي كانت بِعُنوان “كيف تقتُلُ المدارِس الإبداع”. كانت من أشهرِ مُحاضراته وكانت تَتمحورُ حولَ جدالِه بأنَّه لكي يَزدهِرَ اقتصادُ القرنِ الواحدِ والعشرين، فإنَّ أهمَّ المهارات التي يجبُ تَنميتُها هي الاستقلاليَّة، والفُضول، والذَّكاء الاجتماعي، خاصّةً أنَّ هذهِ المهارات تُعتبر الأهمَّ في الوظائفِ مرتفعة الرَّواتب في ظلِّ اقتصادٍ قائمٍ أساسًا على المعرفة.
عبَّرَ عن التَّعليم قائِلاً “أنَّ لدَينا اهتمامٌ كبيرٌ بالتَّعليم وراسخٌ فيه، جُزئيّاً لأنَّ التَّعليم هو الذي سَيحمِلنا إلى هذا المُستقبل غيرِ الملموس”. وتَحدَّث عن مدى أنَّه لا يستطيعُ تكوينَ أدنى فكرةٍ عمَّا سيحدثُ في المستقبلِ من النَّاحية التَّعليمية. مُعظمُ إصلاحيِّي التَّعليم مُتَّفقونَ أنَّ نِظامَ التَّعليم العام لا يقومُ بتعليمِ الطَّلبة على كيفيَّة الابتكار. لكن المشكلة الرئيسية أن في بيئة تعليم تشجع الإجابات الصحيحة ضمن إختبارات موحدة، يصبح الفشل غير مرحب به، بخلاف المطابقة (إجابات كما ينص الكتاب) والتي تعتبر من علامات النبوغ بهذا النظام التعليمي.
ما الفرق بين طريقة مونتيسوري ونُظم التعليم الحالية؟!
يخبو بريق عينه، الشعلة الموقدة المغرمة بالتعلم قد انطفأت، والرغبة والحماس للذهاب إلى المدرسة يتلاشى شيئاً فشيئاً، ويذهب بلا عزيمة ولا نشاط. يذهب لمجاراة والديه، وأصبحت المدرسة روتين يومي فقط لا غير، كل هذا ما يشعر به الطفل، اتجاه النظام الحالي للتعليم. لكن طريقة المونتيسوري، لا تجبر الأطفال على التعلم، وفي الحقيقة أن الأطفال بطبيعتهم يحبون التعلم، يلمسون كل شيء، يرفعونه، يفككونه، وحتى يقومون بتكسيره. كل هذا بدافع الفضول والمعرفة.
طريقة مونتيسوري كل ما تفعله هي أنها تزيد من هذه الشعلة الموجودة للتعلُم. إنها تزيد من التفكير الحر، بدلا من التفكير المقيد، إنها تشجع على ابتكار الجديد بدلًا من التقيد بالموجود. تفعل كل ذلك بدون الإستعانة بالدرجات والتقييمات. هذه الفصول تسمح للأطفال الأكبر عمرًا بأن يتعلموا القيادة والتدريب والمساعدة في تعليم الأصغر سنًا، في حين أن الأطفال الأصغر ستكون لديهم خبرة التعلم مع الأكبر سنًا. وليس دور المعلم هنا أن يقف بجانب السبورة يشرح مع ضمان أن يفهم العشرون تلميذًا ما يقول بنفس الطريقة. بل يتحرك المعلم بجوانب الفصل، يعمل مع الطلبة على إيجاد الحلول واختبار المشكلات التي يواجهونها، واحدًا لواحد، أو ضمن مجموعات صغيرة.
الإستفادة من هذا الإهتمام وتحفيزه أكثر وأكثر، معلمة لطريقة مونتيسوري أخبرت أنها بعدما كانت تُعلّم الأطفال القسمة المطولة وشرح بعض الأمثلة لاحظت طفلة صغيرة تقوم بحل مسألة بسيطة من تأليفها، وكلما وجدتها سهلة زادت رقمًا للمقسوم، حتى تزايد الرقم من المئات، الألاف، عشرة ألاف، مائة ألاف وحتى الملايين والمليارات، ولم يعد في الورق متسع لحل البقية، ماذا فعلت المعلمة؟! أسرعت المعلمة بجلب ورق إضافي وبعض اللصق للطفلة، ثم بدأت الطفلة بزيادة الأرقام من جديد. بعدما أخبرت الطفلة المعلمة أنها انتهت، مدت المعلمة سلسلة الورق المتصلة باللصق لأعلى حتى وصلت أول ورقة للسقف وآخر ورقة تلامس الأرض. الأطفال مع طريقة مونتيسوري يتبعوا اهتماماتهم وشغفهم، أينما اتجه هذا الإهتمام والشغف. هل يمكنك تخيل مدى المهارات التي تعلمتها الطفلة بالقيام بحل مسألة مثل هذه في الثامنة من عمرها، هل يمكنك تخيُل تلك النظرة على وجهها بعدما أنجزت حل المسألة.(1)
يتميز منهج مونتيسوري التعليمي عن باقي البرامج المعروفة و المتداولة:
- يعلم أو يلقن الأفراد كما المجموعات في التدريس على طريقة مونتيسوري يقدم المعلم/المعلمة الدروس للأطفال بشكل منفرد ويكون بإمكان الأطفال الآخرين المراقبة في حال كانوا مهتمين .
- ليس على الطفل أن يشارك في عمل غير مستعد له حيث تبقى الرغبة في التعلم هي المحرك الرئيسي لكل نشاط .
- الأطفال يتعلمون من خلال العمل أكثر من الاستماع والتذكر: يتعلم الأطفال من خلال التدريب على أدوات تعليمية وهي تجسد المبادئ التي يجب على الطفل تعلمها أو إتقانها. مثلاً عندما يتعرف الأطفال على الأشكال الهندسية كالمثلثات والمربعات والدوائر، فهم يقومون بذلك من خلال الأشكال الحقيقية ويستخدمونها من خلال ابتكار التصاميم.
- نظام المونتيسوري يقوم على حرية الاختيار و ليس على تحديد أوقات نشاطات معدة : بما أن كل شيء في بيئة مونتيسوري مصمم ليكون مفيدا وتعليميا، فإن الطفل حر في اختيار ما يناسب رغباته واهتمامه.
- شمولية منهج مونتيسوري التعليمي: فهو يعلم أكثر من مجرد الأساسيات حيث أنه يطور:قدرة الطفل العقلية، قدرته في السيطرة على الحركة، استعمال الحواس (تطور الملاحظة)، التفكير (تطور الإدراك)، العزيمة (التطور الإرادي)، وعيه و إدراكه وسيطرته على عواطفه (التطور العاطفي)، القدرة على التمييز بين التصرف الحسن والتصرف السيء (التطور الأخلاقي)، آلية الحصول على الأصدقاء و أن يكون عضواً مساهماً في المجموعة (التطور الاجتماعي)، واستعمال اللغة (تطور اللغة).
هل البيئة الوحيدة للمونتيسوري هي المدرسة؟!
ينتقل الطفل من بيئة المنزل ومن رعاية والديه إلى المدرسة، فبيئة المنزل يكتسب الطفل منها بدايات كل شيء؛ الشغف للتعلم، وبداية تشكل اللغة لديه، وبداية لنموه العقلي والجسدي، فهل لهذه البيئة منهجا مونتيسوري؟! نعم بالتأكيد، فمنهجية مونتيسوري تقسّم الأطفال إلى فئات عمرية يُعتمد عليها في عملية التعلم، بالتالي سيحتاج الأهل إلى التعرف على نظرة منهج مونتيسوري للفئة التي ينتمي إليها أطفالهم، إنها نظرة مبنية على التحليل الجسدي والعقلي والفيزيائي والعاطفي لهذه الفئة والبناء على ذلك في تصميم بيئة التعلم، ونوع الأنشطة التعليمية التي يمكن تنفيذها، وكيفية التدرج في استخدام هذه الأنشطة، إلى جانب فهم أهمية وفائدة كل نشاط وتأثيره على عملية “التعلم مدى الحياة” التي يسعى المنهج لإرساء أسسها لدى الطفل. (2)
ربما كانت هذه المرة الأولى التي عبرت على مسامعكم فيها منهجية المونتيسوري، لكن مقال واحد لا يكفي …. الجزء الأول.
رزان الظاهر
المراجع
(1) محمد إبراهيم – اراجيك – AraGeek مجلة تعليمية شبابية لجيل الألفية 2016
(2) هالة أبو لبدة محررة تعليم وجامعات – ميدان