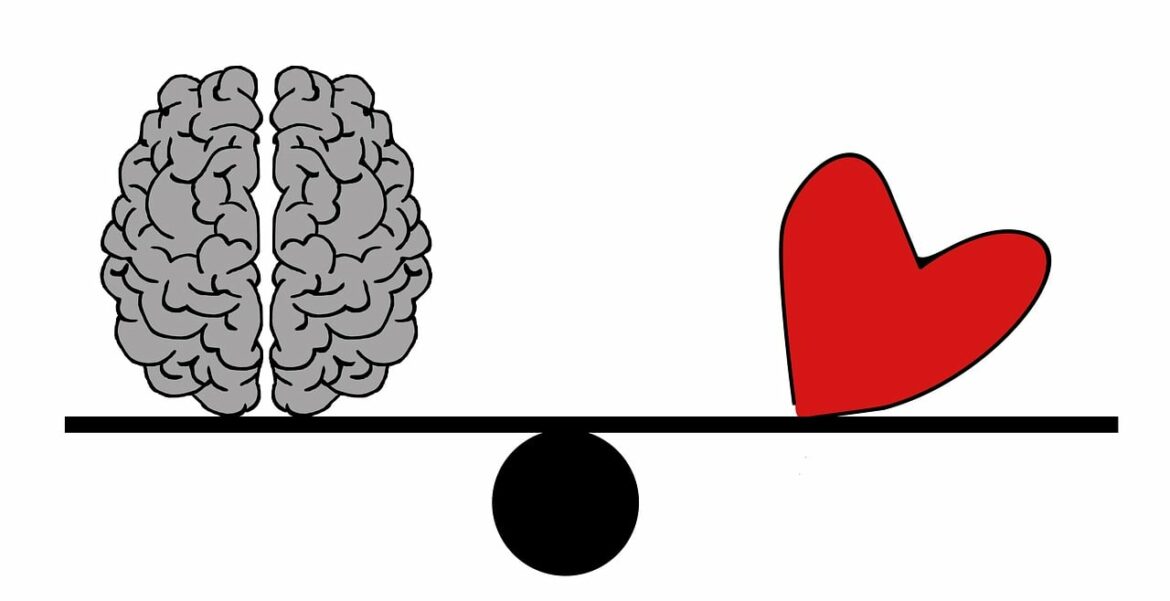إنسانٌ يملك نفسه، ويَسُوس قلبه وعقله ونفسه بحكمةٍ وعدلٍ ونور
تأصيل نموذج المعرفة
ورقة المعرفة وما تتضمّنه من نقاشات ومضامين، ينبغي أن تكون متجذّرة في ثقافتنا، منبثقة من منظومتنا الفكرية والاجتماعية الأصيلة، لا مستوردةً أو مقتبسةً بصورة عشوائية. نحن بحاجة إلى نموذج فكري يصدر عنّا، ينبثق من معاني حياتنا، ويعبّر عن بيئتنا، وتاريخنا، وتجاربنا الروحية والاجتماعية. نموذجٌ فكريٌّ ينتمي إلينا، لا غريبٌ عنّا؛ نموذجٌ يشبهنا، يفهمنا، وينطلق من حاجاتنا الحقيقية، وقيمنا العميقة. لهذا السبب، كان لا بدّ من تأصيل المفاهيم التي نعالجها (لا سيما مفاهيم مثل السيادة والسيادة على الذات) وفق مرجعيتنا الفكرية والروحية، بحيث يكون حديثنا عنها حديثًا نابضًا بمعاني الأصالة، لا تقليدا. عندما نتناول مفهومًا كالسيادة في سياقاتنا المجتمعية، فإننا لا نرغب في إسقاط نماذج مستوردة فوق واقعنا، بل نطمح إلى تفكيك المفهوم وإعادة بنائه انطلاقًا من وعينا الذاتي وهويتنا الثقافية. السيادة هنا لا تعني مجرد حرية شكلية أو استقلال تنظيمي، بل تعني؛ السيادة على القرار، السيادة على بناء المفهوم، والسيادة على طريقة الفهم والتطبيق، بما يتلاءم مع الإنسان والمكان والسياق.
استكشاف أبعاد السيادة: نحو فهم متكامل للذات والمجتمع
في الاجتماعات القادمة، سنقوم بالتعمق في مناقشة أبعاد السيادة الستة، حيث سنستكشف كل بُعدٍ منها بشكل تفصيلي لفهم علاقته بالذات والمجتمع والواقع الذي نعيشه. سنبدأ بـالسيادة على الذات، حيث نتناول قدرة الإنسان على إدارة جسده وصحته وحالته النفسية بشكل واعٍ بما يضمن توازنه الداخلي وقدرته على الصمود أمام التحديات. ثم ننتقل إلى السيادة المالية والاقتصادية، والتي تتمثل في قدرة الفرد أو المجتمع على تحقيق الاستقلال المالي، وضمان موارده بما يكفل له حرية اتخاذ القرار بعيدًا عن الضغوط الاقتصادية الخارجية. بعد ذلك، سنتناول السيادة الفكرية، والتي تتعلق بالقدرة على إنتاج المعرفة، والتحرر من الهيمنة الفكرية الوافدة، وتشكيل رؤى ذاتية منبثقة من ثقافتنا وتجربتنا الخاصة. سوف نناقش كذلك السيادة السياسية، من حيث فهم دور الفرد والمجتمع في صنع القرار السياسي، والمشاركة الفاعلة في إدارة الشأن العام، بما يضمن تمثيل الإرادة الحرة والحفاظ على الكرامة. كما سنتوقف عند السيادة الاجتماعية والثقافية، التي تتمثل في الحفاظ على الهوية الثقافية، وتطوير النسيج الاجتماعي بما يعكس قيمنا الأصيلة ويعزز التماسك الاجتماعي. وأخيرًا، سنبحث في سيادة تلبية الاحتياجات الإنسانية، من خلال القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الاحتياجات الأساسية، وتوفير الظروف الكريمة التي تضمن النمو الشامل للفرد والمجتمع.
بناء السيادة على الذات
لهذا كلّه، فإن ما نناقشه ليس مجرد تصورات عابرة، بل محاولة جادة لصناعة نموذج فكري ينبثق من ذواتنا، ويخدمنا نحن قبل أن يخدم غيرنا. حين نتحدث اليوم عن مفاهيم مثل السيادة على الذات والوعي بالكيان الإنساني، لا نسعى إلى استيراد نماذج فكرية جاهزة، ولا إلى اجترار مفاهيم وُلدت في سياقاتٍ مغايرة لواقعنا وهويتنا. نحن بحاجة إلى نموذج فكري ينبثق من ذواتنا ويتغذى من تجربتنا التاريخية والثقافية والروحية؛ نموذج يعكس واقعنا، ويعالج قضايا مجتمعنا، ويُعبّر عن احتياجاتنا الحقيقية. هذا النموذج الذي نبنيه، ينبغي أن يكون متجذرًا في مرجعيتنا الثقافية المحلية، مستلهَمًا من عُمق تراثنا الفكري. نحن لا نبحث عن قوالب فكرية جاهزة نستوردها، بل نصنع نموذجنا الخاص، مستنيرين بموروثنا الغني. التأصيل ضرورة، والسيادة على الذات محور أساس لهذا التأصيل. فنحن لا نتحدث عن السيادة كمجرد استقلال تنظيمي أو حريات شكلية؛ بل نتحدث عن سيادة أعمق: سيادة الفكر، سيادة الشعور، سيادة القرار، سيادة البناء القيمي والمعرفي. وعلى سبيل المثال، حين نتحدث عن دور مؤسسة مجتمع مدني ما في محافظة ما، نحن لا نبحث عن وصفة جاهزة لما ينبغي أن تكون عليه، بل نؤسس الفهم بناءً على احتياجات المجتمع، وهويته، وعلاقته بثقافته وقيمه.
مفهوم تأسيسي
السيادة على الذات: السيادة على الذات تقوم على ضبط قوى النفس بالعقل والقلب. فـ”السيادة” بحسب الجذر الصوتي العربي تدلّ على السكون (سين) والتحرّك القوي (دال)، مما يشير إلى أن السيادة هي تحقيق توازن بين الرزانة والفعالية. السيادة على الذات تعني إحكام السيطرة على مختلف قوى الكيان الإنساني: النفس، القلب، العقل، الروح، والجسم، وفق ميزان دقيق قوامه الاعتدال.
ممارسات تدل على السيادة على الذات
من خلال الحوار مع المجموعة تبيّن لنا أن النقاط التالية هي أوجه تحقيق أو الوصول للسيادة على الذات:
- تطوير المهارات والقدرات الذاتية: تمثل تطوير المهارات والقدرات الذاتية اللبنة الأساسية لبناء السيادة على الذات. فكلما نمّى الإنسان قدراته العقلية والعملية والمعرفية ازدادت ثقته بنفسه وتعزّزت استقلاليته. التطوير الذاتي يشمل مهارات التفكير الناقد، التواصل الفعال، إدارة الوقت، حل المشكلات، والمهارات التقنية والفنية التي ترتبط بمجال عمله أو اهتمامه. إن الاستثمار في الذات ليس ترفًا بل هو فعلٌ واعٍ يبني شخصية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بمرونة وقوة.
- السيطرة على الانفعالات كالغضب والعصبية: السيطرة على الانفعالات -خاصة الغضب والعصبية- شرطٌ جوهري لتحقيق السيادة الداخلية. الغضب إذا لم يُضبط، أخرج الإنسان عن طوره وحكمته وأوقعه في سفاسف الأقوال والأعمال. أما السيادة الحقة فتَعني أن تكون الانفعالات تحت سلطة العقل المستنير والقلب المطمئن. الإنسان السيد لنفسه هو من يمتلك زمام مشاعره، يطلقها إذا وجب ويكبحها إذا لزم، وفق ضوابط الحكمة لا جموح الهوى.
- ضبط العادات اليومية (كالنوم والأكل والرياضة): ضبط العادات اليومية هو مظهر عمليّ للسيادة على الجسد والنفس. فمن يملك إدارة تفاصيل يومه يملك زمام حياته. النوم المعتدل يمنح البدن راحته دون تواكل، والأكل المتوازن يحفظ الصحة دون شراهة، وممارسة الرياضة تنشّط الجسد وتعزز القوة والإرادة. السيادة تبدأ من الانتصار في معركة التفاصيل اليومية الصغيرة التي تبدو عادية لكنها ترسم ملامح الذات على المدى البعيد.
- محاسبة النفس وتقييم/ تقويم السلوك: محاسبة النفس ركن ركين في بناء السيادة الداخلية لأن النفس بطبعها أمّارة بالسوء تحتاج إلى مراقبة دائمة وتقييم مستمر. المحاسبة تعني مراجعة الأعمال والأقوال والنوايا ومقارنتها بالمعايير التي يضعها الإنسان لنفسه بناءً على قيمه ومبادئه. لذا كانت المراجعة اليومية للنفس ومساءلتها عن مواطن التقصير والنجاح علامة على النضج والسيادة الذاتية. ومن دون هذه المراقبة يتحول الإنسان إلى تابع لأهوائه، غافل عن وجهته، منفلت من زمام ذاته.
- اتخاذ قرارات حرة مستقلّة مبنيّة على قناعة ووعي: اتخاذ القرار الحرّ الواعي هو أبرز مظهر من مظاهر السيادة على الذات. الإنسان الحر هو من يصنع قراراته بنفسه بعد دراسة متأنية للمعطيات، ووزن الخيارات، وتحكيم العقل والقِيم لا من ينساق وراء ضغوط أو تقليد أعمى. القرار الحر يعني أن يتحمل الإنسان مسؤولية اختياراته عن وعي كامل، وأن يكون مستعدًا لتبعات أفعاله مما يعزز نضجه وقوة شخصيته. والسيادة الحقيقية تنكشف لحظة اتخاذ القرار دون رهبة ولا تبعيّة.
- الحفاظ على الحرية الشخصية دون خضوع لضغوط خارجية: الحفاظ على الحرية الشخصية هو التاج الذي تتوَّج به السيادة على الذات. الحريّة هنا ليست انفلاتًا من الضوابط بل هي قدرة على العيش وفق قناعات الشخص العميقة مع احترام الآخرين ودون خضوع لضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية تفرض عليه سلوكًا لا يرضاه. السيادة على الذات تعني أن تكون حرًا في ضميرك، مسؤولًا عن نفسك، مختارًا لخطواتك، لا متَحكَّماً بك من قِبَل مؤثرات خارجية تتحكم بك دون وعي.
تحديات السيادة على الذات
رغم أن بناء السيادة على الذات هو الغاية النبيلة، إلا أن الطريق إليها محفوف بتحديات جذرّية تُعيق الإنسان عن تحقيق الانسجام الداخلي والحرية الحقيقية. ومن أبرز هذه التحديات وفقا لوجهة نظر المجموعة:
١. ضعف الإرادة: هو التحدي الأول والأكبر أمام السيادة على الذات. الإرادة هي القوة المحركة للنفس نحو الكمال، وضعفها يجعل الإنسان عرضة للتقاعس والتردد تابعًا للظروف بدلًا من أن يكون صانعًا لها. الإرادة هي ما يجعل القلب ينهض للجهاد الداخلي فيكبح النفس ويضبط الغضب. وعندما تضعف الإرادة يصبح الإنسان كسولًا مترددًا في اتخاذ القرار عاجزًا عن مقاومة شهواته. بلا إرادة قوية، تذوي أحلام السيادة على الذات في تيارات الهوى والكسل، ويصبح الحديث عن الحرية الشخصية حديثًا أجوفاً لا رصيد له. لهذا تحتاج الإرادة إلى مجاهدة وتمرين مستمر حتى تتقوى وتصبح عادة راسخة في النفس.
٢. الاضطراب في ترتيب الأولويات: السيادة على الذات لا تتعلق فقط بقوة الإرادة بل تتطلب أيضًا حكمةً في ترتيب الأولويات. الاضطراب في إدراك ما هو أهمّ وما هو ثانوي يؤدي إلى تشتيت الطاقة وانصراف الجهود إلى أعمال قليلة النفع وإهمال المهام الكبرى. إن ترتيب الأولويات مهارة قلبية عقلية، تبدأ من معرفة الغاية العليا للإنسان ثم تنعكس على كيفية اختيار الأعمال والأوقات والجهود بما يخدم تلك الغاية. السيادة لا تتحقق إلا لمن يحسن معرفة الأهم فالأهم، ويضبط خطواته وفق ميزان الحكمة.
٣. الاعتماد على قوالب فكرية مستوردة لا تعبّر عن الذات: من أخطر تحديات السيادة الفكرية أن يعتمد الإنسان على نماذج وقوالب مستوردة لا تعبّر عن واقعه ولا تنسجم مع جذور ثقافته وهويته. حين يستورد الإنسان طريقة تفكيره من ثقافات أخرى دون تمحيص، يصبح تابعًا ذهنيًا، يفكر بلسان غيره، ويقيّم العالم بمعايير لا تخصه. الإنسان الذي يُبني وعيه بمعايير لا تخصه يفقد سيادته الفكرية ويصبح قابلًا للذوبان في ثقافات لا تنتمي إليه. لهذا فإن من جوهر السيادة على الذات أن يستقي الإنسان وعيه من مصادره الأصيلة، أن يبني نموذجه الفكري من تجربته وتاريخه ودينه، لا أن يكون مستهلكًا لنماذج الآخرين بلا وعي.
٤. ضغوط السياق الاجتماعي والاقتصادي: حتى مع وجود إرادة قوية وعقل مرتب، يبقى السياق الاجتماعي والاقتصادي قوة ضاغطة يمكن أن تُعيق السيادة إن لم يتعامل معها الإنسان بوعي. الضغوط قد تتمثل في الأعراف الاجتماعية الخانقة أو في متطلبات مادية ترهق الإنسان أو في سياسات اقتصادية تصنع التبعية بدلًا من الاستقلال. من هنا، كان من السيادة الحقيقية أن يتعلم الإنسان كيف يتفاعل مع ضغوط السياق بطريقة حرة؛ إن كان فقيرًا، لا يجعل فقره سببًا لبيع قيمه و إن كان غنيًا، لا يجعل غناه سببًا للغفلة والكِبَر. وإن كان محاطًا بأعراف فاسدة، يبني وعيه بمعزل عن تلك الأعراف، ويظل ثابتًا على بصيرته.
٥. غَلَبة النفس: أخطر أعداء السيادة على الإطلاق هو النفس! النفس بطبيعتها تميل إلى الراحة واللذة والأنانية والشهوة. فإذا تُركت دون ترويض استعبدَت الإنسان وحولته إلى مُنقادِ لشهواته ومخاوفه. هنا تتبدد السيادة على الذات ويتحول القلب من ملك عادل إلى تابع ذليل لنزوات النفس. مجاهدة النفس تعني تعويدها على مقاومة الشهوات وتحمّل المكاره ومحاسبة الذات يوميًا حتى تصفو. من دون هذه المجاهدة، لا يمكن للإنسان أن يدّعي امتلاك سيادة حقيقية على قلبه أو عقله أو سلوكه.
عوامل تعزيز السيادة على الذات
من وجهة نظر المجموعة، فيما يلي العوامل التي تُمكّّن الإنسان من ترسيخ جذورها في كيانه وهي مرتكزات جوهرية لبناء الإنسان الحر الذي يُدير نفسه بوعي وقوة.
١. تقوية الوازع الروحاني: الوازع الروحاني يخلق في الإنسان رقابة داخلية تحفزّه للخير وتمنعه من الانحراف، دون انتظار رقيب خارجي. أيضا، عبر الممارسات الروحانيّة يتجدد حضور هذا الوازع يوميًا في قلب الإنسان، مما يعزز سيادته على نفسه ويُثبّت إرادته أمام نوازع الهوى.
٢. تنمية الوعي الذاتي: المقصود بالوعي الذاتي هنا هو أن يعرف الإنسان نفسه: يعرف نقاط قوته وضعفه، يدرك ميوله وشهواته، ويفهم دوافعه وخفايا نواياه. إن من لا يعرف نفسه يبقى أسيرًا لها دون أن يدري؛ يظن أنه يختار بحرية، بينما هو واقع تحت تأثيرات خفية من طبعه أو بيئته. كلما زاد وعي الإنسان بنفسه، زادت قدرته على قيادتها بذكاء، بدل أن تجرّه أهواؤه حيث شاءت. تنمية الوعي الذاتي تمر عبر محاسبة النفس اليومية، التأمل في الدوافع وراء الأفعال، الاعتراف بالعيوب دون مكابرة، و مراجعة الأهداف والنوايا باستمرار.
٣. ترتيب الأولويات بوعي وحكمة: ترتيب الأولويات هو مهارة عقلية روحية لا غنى عنها لتعزيز السيادة الذاتية. الإنسان الذي يخلط بين الأهم والمهم، يضيع جهده في أعمال لا أثر لها ويفقد بوصلته وسط زحام الحياة. وهكذا تصبح حياة الإنسان مركزة وذات مغزى، لا متناثرة على هامش الأحداث. ترتيب الأولويات يقتضي أن يقدم الإنسان بناء نفسه الروحي والأخلاقي على ما دون ذلك وأن يوازن بين حاجاته الجسمية والنفسية والعقلية والروحية، وأن يعطي الوقت والجهد لما يُثمر أثرًا مستدامًا، لا لما يُشبِع نزوة عابرة.
٤. الاستقلال المالي الجزئي أو الكامل: وهو أحد أعمدة الحرية الشخصية والسيادة الذاتية. الاستقلال المالي لا يعني الغنى الفاحش، بل يعني أن يملك الإنسان حد الكفاية الذي يغنيه عن الناس، ويمكنه من اتخاذ قراراته بحرية. فمن لا يحتاج إلى مد يد العون لغيره، يملك قوة القرار. ومن يحقق اكتفاءه الذاتي أو الجزئي يخفف من خضوعه للضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
٥. احترام الذات وتنمية الشعور بالكرامة: احترام الذات هو الشعور الداخلي بالقيمة والاستحقاق والكرامة. من يحترم ذاته يرفض الإهانة من نفسه أو من غيره، يطالب بما يستحق دون خنوع، ولا يسمح لذاته أن تكون رخيصة أمام المال أو الشهوة. احترام الذات يغذّي الشعور بالكرامة، والكرامة تدفع الإنسان إلى الالتزام بمبادئه، وعدم التفريط في سيادته ولو واجه التحديات. هكذا يصبح الإنسان سدًّا منيعًا أمام كل محاولات الهيمنة الخارجية أو الداخلية عليه.
الملحق:
مفاهيم الجِسْم والرُّوح والعَقْل والنَّفْس والقَلْب عند الإمام الغزالي
تناول الإمام أبو حامد الغزاليُّ (505هـ) في كتبه مفاهيم الإنسان الأساسية (الجسم، والروح، والعقل، والنفس، والقلب) بوصفها لبنات فلسفته الروحية والأخلاقية. وقد اعتمد في بيانها على مزيج من الأسس الدينية (نصوص الشرع ومصطلحات القرآن والحديث) والمفاهيم الفلسفية (كما في التراث اليوناني والإسلامي السابق) ( إحياء علوم الدين – الغزالي، أبو حامد). حرص الغزالي على تعريف دقيق لكل مفهوم وشرح خصائصه ووظيفته، ثم بيّن علاقاتها المتبادلة وكيفية تفاعُلها في تكوين الإنسان السلوكي والمعرفي. وقد تتبّع الغزالي تطوّر نظرته لهذه المفاهيم عبر مؤلَّفاته المختلفة من مقاصد الفلاسفة وميزان العمل إلى قمّة نضجها في إحياء علوم الدين وما تلاه. فيما يلي عرض منظم لكل مفهوم على حدة، يتبعه توضيح العلاقات بينها، ثم كيفية توظيفها في مشروع الغزالي التربوي والأخلاقي والمعرفي، مع إشارة ختامية إلى تطوّر فهمه بين مراحل حياته الفكرية. سنعتمد في ذلك على نصوص الغزالي الأصليّة لإبراز مراده، مستعينين بالشواهد المناسبة.
- مفهوم الجِسْم: الجسم عند الغزالي هو البُعد المادّي من الكيان الإنساني، وهو وعاء النفس وروحها وأداتها لتنفيذ الأفعال في العالم المحسوس. ويُعرّف الغزالي الجسم الإنساني بأنه التركيب العضوي المشهود الذي ينتمي إلى عالم المُلك والشهادة (عالم المادة). فالجسم هو الجزء الظاهر من الإنسان الذي تُدركه الحواس، ويشترك الإنسان فيه مع سائر الحيوانات من جهة كونه مادّة قابلة للفناء. وقد وصف الغزالي القلب الجسماني – وهو عضو من أعضاء الجسم – أنه قطعة لحم صنوبريّ الشكل مودَعٌ في الجانب الأيسر من الصدر، وفي باطنه تجويف فيه دم أسود هو مصدر الحياة الحيوانية (ماهية القلب، والفرق بينه وبين الروح). وظيفة الجسم الأساسية عند الغزالي هي خدمة اللطيفة الروحية (القلب/النفس الناطقة) كأداة ووسيلة تتحقق بها الأفعال والتجارب الدنيوية. فهو مَركَب الروح الذي يمكّن الإنسان من السفر في عالم التراب وأداء مهامه الحياتية. ومن ثَمَّ، ينظر الغزالي إلى الجسم على أنه مملكة تدور فيها قوى الإنسان المختلفة: فالقلب سلطان هذه المملكة، والعقل وزيرها، والحواس جنودها التي تجمع الأخبار من العالم الخارجي. بالتالي، صلاح الإنسان أو فساده الأخلاقي ينعكس على بدنه وجوارحه؛ إذ «القلب ملكٌ والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده» كما يروى في الأثر. خلاصة القول: الجسم عند الغزالي عنصر ضروري لكنه غير مستقل، فهو خادم للروح والقلب ومطيّةٌ تسخّرها النفس في ارتقاء الإنسان أو انحداره أخلاقياً.
- مفهوم الرُّوح: الرُّوح في اصطلاح الغزالي مفهوم متعدّد الطبقات، يحمل معانيَ مادية وأخرى روحانية تبعاً للسياق. يميّز الغزالي بين معنيين أساسيين للروح:
المعنى الأوّل (روح الحياة أو البخار اللطيف): هو جسمٌ لطيف ينبع من جوف القلب الجسماني، ويسري عبر العروق الضوارب (الأوعية الدموية) إلى سائر أجزاء البدن. هذا الروح بالمعنى الحياتي يقترن بالدم والمادة، فهو الذي يفيض منه نور الحياة والحسّ في الأعضاء، كفيض نور السراج في زوايا البيت: فما من جزء من البيت إلا وصله نور السراج، كذلك لا يبلغ جزءٌ من البدن إلا وقد بلغه تيار الحياة بواسطة هذا الروح . وقد أشار الأطباء والفلاسفة إلى هذا المعنى بوصفه البخار الحار اللطيف المنبعث من القلب. وظيفة هذا الروح أنه واسطة الحياة الجسمانية: بانتشاره في الجسد تحصل قوى الحس والحركة. ويؤكد الغزالي أن هذا المعنى طبيعي مادي ليس هو المقصود عند علماء الدين إلا من جهة كونه آلة تحمل النفس.
المعنى الثاني (الروح اللطيفة الربانية): هو جوهر روحاني ربّاني يتعلق بالقلب تعلُّقًا خاصًّا. قد سمّاه الغزالي لطيفة عالمة مُدْرِكة وهو حقيقة الإنسان التي بها يعرف ربّه ويدرك العلوم. هذه الروح أمرٌ إلهيّ عجيب أشار إليه القرآن بقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، فهي من عالم الأمر السماوي لا من عالم الخلق المادي. يصرّح الغزالي بأن العقول البشرية تعجز عن إدراك كنه هذه الروح؛ إذ هي سرّ ربّاني تجاوز طور العقل والتخيل. وظيفة الروح بهذا المعنى أنها الأصل في الإدراك والمعرفة والتكليف، فهي التي “تعلم وتعرف” حقائق الأمور، وبها يكون الإنسان إنسانًا مكلَّفًا مكرَّمًا.
الغزالي بهذا يربط بين المعنيين: فالمعنَى الأول جسداني بهيمي يربط الروح بالبدن للحياة الدنيوية، والمعنى الثاني روحاني ملكوتي يربط الإنسان بعالم الغيب والمعرفة الإلهية. فإذا أُطلق لفظ الروح لدى علماء الشريعة قصدوا به في الغالب النفس الناطقة الربانية إلا فيما يتعلّق بأمور الطب والبنية الجسدية. وقد تعمّد الغزالي عدم الخوض في كُنه الروح الربانية التزامًا بالأدب مع السرّ الإلهي الذي لم يشرح النبيُّ ﷺ تفاصيله. ومن منظور تربية النفس، “الروح الأمّارة” (إن فُهمت بمعنى النفس الحيوانية) تجب مجاهدتها وضبطها، بينما “الروح المطمئنّة” (بمعنى الجوهر الرباني حين يصفو) فهي غاية السلوك الصوفي.
- مفهوم العَقْل: العقل عند الغزالي مفهومٌ مرنٌ متعدد المعاني، وهو يشير تارةً إلى القوة المدركة المميِّزة في الإنسان، وتارةً إلى حصيلة المعرفة والإدراك ذاتها. قد أوضح الغزالي أن لفظ العقل مشترك بين معانٍ مختلفة، أهمّها معنيان يرتبطان ببحثه:
المعنى الأوّل (العقل كصفةٍ وإدراك): يراد به العلم بحقائق الأمور؛ أي نور المعرفة الذي يميّز به الإنسان بين الحق والباطل. بهذا المعنى يكون العقل صفةً من صفات الإنسان، محلُّها القلب (الروح اللطيفة). العقل هو ذلك النور المعنوي الذي يهتدي به القلب إلى المعارف، وهو أشرف الصفات الإنسانية إذ يختصّ به الإنسان عن سائر الحيوان. وقد شبّهه الغزالي بـالنور الإلهي الذي يضيء طريق طلب الحقيقة (العقل).
المعنى الثاني (العقل كجوهر ومدرك): يراد به ذات المُدرِك؛ أي محل الإدراك نفسه وهو اللطيفة الربانية التي تدرك العلوم. العقل هنا هو القلب الروحاني باعتباره أداة الفهم. ويستشهد الغزالي على هذا المعنى بالحديث النبوي: «أوَّلُ ما خلق الله العقل»، موضّحًا أن المقصود هو جوهر الإدراك الأول لا العلم نفسه؛ لأن العلم عَرَضٌ لا يُخلق أولًا، بل يسبقه وجود العاقل المدرك. إذًا فالعقل بهذا المعنى هو أصل الروح الإنسانية من حيث قدرتها على التفكير والتلقي.
يظهر الغزالي احترامًا كبيرًا للعقل باعتباره موهبة إلهية عظيمة منحها الله للإنسان ليميزه عن البهائم. وقد أفرد فصلًا في إحياء علوم الدين لبيان شرف العقل وعلوّ قدره. إلا أنه في الوقت نفسه يضع العقل ضمن حدود طاقته: فعمل العقل مرتبط بصفاء القلب وانكشاف نور الإيمان. لذلك يصف العقلَ بأنّه خادم للقلب ووزيرٌ له في مملكة الإنسان (من كنوز الامام الغزالي: وظيفة القلب)؛ يقوم بتوجيه الملك (القلب) ونصحه، لكنّه ليس الحاكم الأعلى. فمتى تنور القلب بالإيمان والعرفان أدرك العقل حقائقَ تتجاوز مداركه المجردة، ومتى تكدّر القلب بالشهوات عجز نور العقل عن الإضاءة. باختصار: العقل عند الغزالي وسيلة معرفية جليلة لكنه ليس مستقلًا عن نور الله في القلب؛ فهو نورٌ مقتبس كالبصر يحتاج إلى ضياء يُظهر له المرئيات. وقد انتقد الغزالي الفلاسفة الذين غلوا في تعظيم العقل وحده، كما ناقش الصوفية الذين همّشوا دوره؛ سعيًا منه إلى تحقيق التوازن بين العقل والوحي في منهجية المعرفة الحقة.
- مفهوم النَّفْس: النَّفس في استخدامات الغزالي لها دلالات متعددة، وهي من أكثر المصطلحات التي يختلف معناها باختلاف المقام. يميّز الغزالي بين معنيين رئيسيين للنفس:
المعنى الأوّل (النفس الأمّارة، مجموعة الصفات الشهوانية والغضبية): يُقصد به الجانب الغريزي في الإنسان، أي الأصل الجامع للصفات المذمومة وشهوات الإنسان وغضبه. هذه هي النفس التي يُشار إليها عند أهل التصوف في سياق المجاهدة، فيقولون: “لا بد من مجاهدة النفس وكسرها”. فهي مركز الرغبات والهوى والأنانية في الإنسان، وتُسمّى في القرآن النفس الأمَّارة بالسوء إن أطلقت لشهواتها، وقد جاء في الحديث: «أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك» إشارةً إلى خطورة هذا الجانب إن تُرك بلا تهذيب. وظيفة النفس بهذا المعنى وظيفة ابتلائية؛ إذ على الإنسان أن يضبط دوافعها ويهذبها من أجل الارتقاء الروحي. فهي موطن المجاهدة: إن غلبت الإنسان قادته إلى موارد الهلكة، وإن قهرها وصيّرها مطيعة ارتقى في مدارج السالكين.
المعنى الثاني (النفس الإنسانية بمعنى الذات والروح): يُقصد به الذات الإنسانية نفسها، أي اللطيفة التي هي الإنسان بالحقيقة. هذه النفس هي عين ما أطلق عليه سابقًا القلب أو الروح الربانية؛ إذ هي الجوهر العاقل المكلَّف في الإنسان. لكنها تُوصف بأوصاف مختلفة حسب أحوالها الأخلاقية: فإن استكانت لأمر الله وخضعت واطمأنّت سُمّيت النفس المطمئنّة، وقد خاطبها الله بقوله: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾. وإن تردّدت بين الخير والشر وأخذت تلوم صاحبها عند الخطأ سُمّيت النفس اللوّامة. أمّا إذا استسلمت للشهوة والشيطان وانقادت لهما، سُمّيت النفس الأمّارة بالسوء (وهذا في الحقيقة عَوْدٌ إلى المعنى الأول للنفس). وظيفة النفس بهذا المعنى الثاني أنها محل المسؤولية والتكليف؛ فهي التي تُثاب وتُعاقب، وهي مخاطَبة الشرع. وإذا زكيت النفس بالمعنى الثاني صارت مصدر الفضائل، وإذا أهملت وانغمست في مقتضيات المعنى الأول غرقت في الرذائل.
نلاحظ أن الغزالي يستخدم كلمة “النفس” تارةً بمعنى مذموم (الهوى والشهوة)، وتارةً بمعنى ممدوح (الروح الإنسانية). ولرفع الالتباس يبين أن النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذمّ، وبالمعنى الثاني محمودة. لذلك يُكثر في كتبه من عبارات مثل “تهذيب النفس” و “مجاهدتها”، قاصدًا النفس الشهوانية السفلية. وفي المقابل يتحدث عن كرامة النفس الإنسانية وضرورة صونها، قاصدًا النفس بمعنى الروح العاقلة. وهكذا يتّسق استعمال الغزالي مع سياق الكلام: فإن كان الحديث عن عيوب الأخلاق وجب حمل النفس على المعنى الأول، وإن كان عن الذات والهوية الإنسانية فهو المعنى الثاني. وفي كلا الحالين، يبقى جوهر النفس عند الغزالي شيئًا شريفًا في الأصل، قابلًا للسموّ إذا تزكّى، وللهبوط إذا تدنّس. وقد جعل هدفه التربوي في إحياء علوم الدين “إصلاح النفس” عبر الرياضات والخلوات وكسر الهوى، حتى تعود النفس المتمردة مطمئنّةً طائعةً لله.
- مفهوم القَلْب: القلب هو أهمّ مفاهيم الغزالي وأعقدها، إذ يراه لبّ حقيقة الإنسان وروح روحه. وقد خصّص له كتابًا كاملًا بعنوان “عجائب القلب” ضمن إحياء علوم الدين. يوضّح الغزالي ابتداءً أن لفظ القلب يُطلَق على معنيين اثنين:
المعنى الأوّل (القلب العضوي الحسّي): وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودَع في الصدر من جهة اليسار. هذا القلب جسمٌ مادي من عالم المُلك، تضخّ عبره الدماء وتنتشر الحياة في الجسد. وظيفته الحيوية جعلته محور اهتمام الأطباء، لكنه ليس المقصود الأساسي في خطاب الشرع عند ذكر “القلوب”، إلا على سبيل المجاز أو باعتباره مقرًّا للروح الحيوانية. يقرّر الغزالي صراحةً: «نحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعْنِ به ذلك [القطعة اللحميّة]، فإنه قطعة لحم لا قدر لها… تُدرِكها البهائمُ بحاسة البصر». أي أن القلب الجسدي مشترك بين الأحياء (حتى البهائم تمتلكه) فلا يختصّ به شرف الإنسان. ومن ثَمَّ فإن الغزالي يهيّئ القارئ للانتقال من الظاهر إلى باطن المعنى.
المعنى الثاني (القلب الروحاني اللطيفة الربانية): وهو المقصود الحقيقي عند الغزالي: لطيفةٌ ربّانية روحانية لها تعلّقٌ بالعضو القلباني الحسي. هذه اللطيفة هي حقيقة الإنسان نفسها، «وهو المُدرِك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمطالب والمعاقب». يُشير الغزالي هنا إلى جوهر روحاني يسمّيه القلب تارةً والروح تارةً والنفس تارةً بحسب الاعتبار. هذا القلب الروحاني هو مَحلُّ معرفة الله في الإنسان؛ به يفقه الحقائق الإيمانية ويتلقّى أنوار الهداية. يصفه الغزالي بأنه يشبه المرآة الصافية المستعدة لأن تنطبع فيها صور الحقائق كلها إذا تجلّى عليها نور الحق. وهو أيضًا محل التقوى والقسوة المذكورَيْن في القرآن: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ إشارةً إلى تعطيل هذه اللطيفة، و ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ إشارةً إلى من انتفع بهذا الجوهر. خصائص القلب الروحاني أنه متقلّب الأحوال (ومن هنا جاء اسمه “قلب” لتقلّبه) بين الإشراق والظلمة، بناءً على صلته بالله أو ابتعاده بالمعاصي. فإذا صفا وتجلى صار مرآةً للمعرفة، وإذا صدأ بالذنوب غدا غافلًا مظلمًا.
لقد أكّد الغزالي خصوصية العلاقة بين القلب بمعناه الروحي والبدن المادي؛ إذ يرى أن هذه اللطيفة الربانية لها علاقةٌ خاصّة بالقلب الجسماني ومن خلاله بسائر الجسد. فهي مُدبِّرة البدن، تتعلق أولًا بالعضو القلباني كقاعدة ومحطٍّ أول، ثم تتفرع منه لإدارة بقية الأعضاء. وقد استعان ببعض استعارات الصوفية لشرح ذلك، فنقل عن سهل التُستري قوله: «القلب هو العرش، والصدر هو الكرسي» تشبيهًا لمقام القلب في جسد الإنسان بالنسبة للروح، بعرش الرحمن بالنسبة لتدبير الخلق. فالقلب سُلطان الجسد ومَلِيكُه، وباقي القوى جنودٌ وأعوان له. وظيفة القلب الروحي أنه مَحلّ نظر الله من العبد، وهو الموضع الذي “يَقبل الفيض الإلهي” من الحكمة والإيمان. روى الغزالي الحديث القدسي: «لا يسعني أرضي ولا سمائي، وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن» للإشارة إلى عظمة القلب عندما يطهّر ويُهيّأ لمعرفة الله. ومن هنا كانت تربية القلب وتزكيته محور مشروع الغزالي بأكمله؛ إذ اعتنى برياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب، مرجعًا كل الفضائل والرذائل إلى ما يعتلج في هذا الجوهر الداخلي من أنوار أو ظلمات.
العلاقات المتبادلة بين هذه المفاهيم
بعد فهم كل مفهوم بمفرده، تبرز رؤية الغزالي التكاملية لهذه العناصر الخمسة في نسيج واحد هو الكيان الإنساني. فهو لا ينظر إليها كجزر معزولة، بل يصفها ضمن منظومةٍ متفاعلة يحكمها ترتيب هرمي وتناغم وظيفي دقيق:
- القلب الروحاني (اللطيفة الربانية) عند الغزالي هو مركز الدائرة وملك المملكة الإنسانية. فهو الجوهر الذي تتوارد عليه سائر الأسماء: فمرةً يُسمَّى روحًا، ومرة نفسًا، ومرة عقلًا بحسب اعتبار وظيفته. فالقلب هو ذات الإنسان العارفة التي تتلقى المعارف وتوجّه القوى.
- العقل بالنسبة للقلب هو وزيرٌ ناصح ومستشار أمين. وظيفة العقل أن يضيء للقلب طريقه ويدلّه على الحق مستعينًا بقوة النظر والتفكير. ولكن لا ينبغي للوزير أن يغتصب مكان الملك؛ فإن تجاوز سلطان العقل حدّه بأن استقلّ عن نور الإيمان، اضطرب نظام النفس. التناغم المثالي عند الغزالي أن يكون العقل خادمًا مطيعًا للقلب، “يقود الجوارح تحت راية الإيمان”. لذا يوازن الغزالي بين دور الشرع (الوحي الإلهي الهادي للقلوب) ودور العقل (الأداة المفسّرة والمطبّقة لأحكام الشرع)، فكلاهما يتعاضدان في تحقيق معرفة الله وسلوك طريق الآخرة.
- النفس (بمعناها السفلي) تمثل في المملكة الإنسانية قوى الشهوة والغضب – وقد شبّهها الغزالي بالوالي الخائن (الشهوة) والشُرطيّ العنيف (الغضب). النفس الأمارة إذا تُركت حرةً أحدثت الفساد في المملكة؛ إذ تميل إلى الملذات العاجلة ولو على حساب العاقبة. الدور المطلوب: كبح جماح هذه النفس وترويضها لتخضع لأوامر العقل والقلب. فإن قام القلب (الروح العاقلة) بثني عنان النفس وكسر شرِّها، تحوّلت من عدوٍ داخلي إلى مركبٍ ذلول يحمل الإنسان إلى مدارج الكمال. وهذا التصور واضح في قول الغزالي: «وجعلنا النفس مَركَبَه [أي مركب القلب] حتى يسافر عليه من عالم التراب إلى أعلى عليين». أي أن النفس بطبعها الأرضيّة يمكن أن ترتقي وتُسخَّر لخدمة الروح متى ما انضبطت بشرع الله.
- الروح بالمعنى الحيوي (البخار اللطيف المنتشر في البدن) يمثل صلة الوصل بين القلب الجسماني (العضو) واللطيفة الربانية. فهو واسطة تنفيذ الأوامر: يحمل تأثيرات القلب الروحي ويعمّمها على الجسد حِسًّا وحركة، ويعكس أيضًا حالات الجسد على القلب (فمثلاً، ضعف هذا الروح بالبخار يؤثر على صفاء الذهن وإدراك القلب). بعبارة أخرى، الروح الحيوانية أقرب الجنود إلى القلب، بها يحيا البدن وينفعل. والغزالي يعتبر معرفتها مهمة للأطباء المداوين للأبدان، لكنها ليست شغلًا شاغلًا لأطباء القلوب إلا لفهم مركب الإنسان.
- الجسم بكل أعضائه وحواسه هو مجال عمل هذه القوى جميعًا ومحلّ ظهور نتائجها. فالجوارح “جنود تنفيذ” لأوامر القلب والعقل أو للنزوات الصادرة عن النفس. العين والأذن وبقية الحواس سماها الغزالي جواسيس الملك، تحمل الأخبار والمعلومات إلى القلب (الملك) ليحكم عليها. فإذا كان الملك صالحًا (القلب العامر بالإيمان) والعقل وزير صدق، والنفس منقادة، جاءت الأوامر إلى الجوارح بالخير فانقادت للجهاد والعمل الصالح. أمّا إذا فسد القلب أو ضُيّع العقل وتسلطت الأهواء، انعكس ذلك في سلوك الجوارح الخاطئ ومعاصي البدن. ولهذا شدّد الغزالي على أن إصلاح الظاهر فرعٌ عن إصلاح الباطن، وأن سيطرة الشهوة أو الغضب على الإنسان تعني اختلال نظامه الداخلي: إذ يتمرد الوالي (الشهوة) على الملك، ويعزل الوزير (العقل)، فيعمّ الاضطراب والفوضى أخلاق المرء.
بهذا التصور المتكامل، قدّم الغزالي فهمًا نفسيًا وروحيًا عميقًا للإنسان يسبق زمانه. تظهر فيه وحدة الإنسان رغم تعدد قواه: فجوهره واحد (القلب/الروح الناطقة) وتدور حوله القوى والمدارك كالكواكب حول الشمس. كما تظهر هرميّة يتصدّرها القلب ثم العقل ثم النفس ثم الجسم، فينبغي أن يقود الأعلى الأدنى لا العكس. وغاية التربية الروحية عند الغزالي إقامة هذا النظام على الوضع الصحيح: نور القلب مُهَيْمِن، تبعُه نور العقل، وكبح النفس، وصلاح البدن. فإذا تحقق ذلك، صار الإنسان قلبًا حيًّا يمشي على الأرض كما عبّر الغزالي (8 أسباب للعناية بالقلب – مجلة المجتمع)، أي تجسيدًا حيًا للمعرفة الربانية والأخلاق الفاضلة.
د. سهى عياش