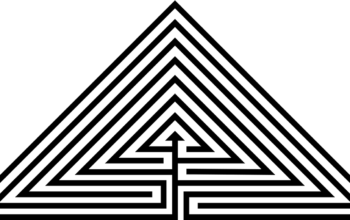وسائل الإعلام لم تنزل من السماء مع الملائكة، إنها ملك لشركات وأشخاص أو جمعيات، تقوم ببيع المعلومات والأخبار. بالتالي ليست هناك وسيلة إعلامية واحدة مستقلة تمامًا أو “نقية”، سنناقش في هذا المقال التحيز الإعلامي في ضوء تغطية الحقيقة. التحيّز الإعلامي قد يدفع الصحفيّ لاستباق الأحداث والنتائج، وإطلاق الأحكام المُسبقة، كما قد يدفعه لتَبْرئة أشخاص أو اتّهام آخرين، كما أنه يؤدّي إلى التّنميط، وإطلاق الأوصاف جُزافاً، ثم أنه قد يؤدّي إلى حصر المصادر والشخصيّات التي يتمّ مقابلتها في فئةٍ ما يتحيّز لها الصحفيّ، فلا يَعرض وجهات النظر المختلفة، بل قد يؤدّي إلى تحييد أشخاصٍ هم أكثر ملاءمةً لملء المكان.[1]
مثلاً نشرت عدة وسائل إعلام لبنانية تغطيات متحيزة ضد اللاجئين السوريين، مما ساهم في خلق نظرة سيئة تجاههم داخل المجتمع، ففي موقع تابع لإحدى القنوات اللبنانية تم نشر تقرير يربط بين انتشار السرطان في لبنان وبين زيادة أعداد اللاجئين، استنادا إلى رأي أحد الأطباء ودون سرد أدلة تؤكد ذلك. وفي هذا السياق، يسبب التحيز الإعلامي ذعرا أخلاقيا تتخذ فيه وسائل الإعلام موقفا تتعدى فيه المخاوف العامة، وتتعدى التهديد الموضوعي الذي يشكله المجتمع تجاه فرد أو جماعة. درجت بعض وسائل الإعلام طوال عقود على بث الذعر من بعض العصابات ومظاهر العنف المدرسي، لتصل مؤخرا إلى تنميط المهاجرين واللاجئين بصفتهم مصدرا للجرائم والأمراض والفقر والكثير من مشاكل المجتمع. وبحسب “دليل تجنب التمييز وخطاب الكراهية في الإعلام”، الذي يعد من أحدث إصدارات معهد الجزيرة للإعلام، يأخذ التحيز في الإعلام ثلاثة أشكال رئيسة، هي:[2]
- التحيز التحريفي: الذي يشمل الأخبار التي تسعى لتحريف الحقيقة.
- التحيز المتعلق بالسياق: عندما يبرز في الخبر توجه سياسي أو أيديولوجي محدد.
- التحيز في قرار التحرير: دوافع المحرر التي توجهه لاتخاذ موقف مسبق فينتج محتوى متحيزا.
قد يأتي التحيز بناء على مواقف وقناعات الصحفي نفسه، أو بسبب الأجندات التي تفرضها الجهة الممولة للوسيلة الإعلامية. أو حتى بناء على توجهات الشريحة المستهدفة من المتابعين، مع العلم بأن الوظيفة الأساسية للإعلام هي “الإخبار”. لذلك نجد أن الجماهير ترى في المنابر الإعلامية قنوات للإخبار وتنتظر منها نقل الحقيقة وتبليغ الأخبار والمعلومات بأمانة ودقة [3] . هل تنقل المنابر الإعلامية على اختلافها وتعدد أشكالها الحقيقة فعلاً للجمهور المتابع؟ وهل يقصد بها المطابقة الدالة عليها وبين الأشياء كما هي عليه في الواقع، أم أن الأمر يتعلق بحقيقةٍ من نوع آخر ينبغي كشفها وتسليط الضوء عليها؟. قد تعددت الآراء واختلفت حول الحقيقة التي تعتبر من المعايير المهنية التي لا بدَّ أن تلتزم بها المؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين فيها، وتكوّنت مدراس فكرية، كلّ واحدة منها تنظر إلى “الحقيقة” نظرةً مختلفة.
هناك من يربط الحقيقة بالوقائع مباشرةً وآخر يربطها بالخطاب الصحفي والإعلامي المنتج حول هذه الوقائع. يرى أصحاب التوجه الأول المذكور أعلاه أن وظيفة الإعلام الأساسية تتجسد في نقل الوقائع كما هي بالفعل وكما تقع في مسرح الأحداث، أي بموضوعيةٍ وحيادٍ ومن دون تحيز أو إدراج رأي أو تعليق. من المدافعين عن هذا التوجه، نجد دانييل كورني الذي دائماً ما يطالب الصحفيين بالاقتصار على الوقائع كما هي من دون تمرير أي رأي -لأن كل رأي- في اعتقاد كورني لن يكون إلا ذاتيًّا، ويعتبر كورني أن الخبر هو محصلة لتضافر ثلاث آليات في ممارسة الصحفي لمهمتهِ تتمثلُ في الملاحظة (لحظة الوصول إلى موقع الحدث) والتأويل (لحظة البدأ بتوثيق الحدث) ثم التبليغ (لحظة إذاعة الحدث)، وهي آلياتٌ تكشف بطريقةٍ أو بأخرى عن تدخل “الذات” بشكلٍ من الأشكال في مسار تحول الحدث إلى خبر.[4]
يستمرُ السجال حول خطاب الحقيقة مع “جيل غوتيي”، فهو يقر أن الحقيقة هي هدف ضروري بالنسبة إلى الصحافة، وتسعى إليه كلّ المؤسسات الصحفية والإعلامية بطرقٍ وأساليبٍ مختلفة. يطرح غوتيي مصطلح “القبلية الإخبارية” ويعني به أن الصحافة ملزمة بإنتاج إثباتات صحيحة انطلاقا من توجهها صوب الواقع الخام أي “الحدث” كما يقع على أرض الواقع دون تدخل “الذاتية” فيه [5] . هذا يعني أن الصحافة تنقل معرفة من نوع ما لها “صلة” بالأحداث الجارية، الأمر الذي يؤكد وجود واقع خام آخر، أي معطى، منه تُستنبط الأخبار التي ينصب عليها العمل الصحفي. القبلية الإخبارية تفترض أن الوظيفة المناطة بالصحافة تكمن في إنتاج إثباتات صحيحة تفترض أن أداء هذه الوظيفة يقوم أساساً على واقع خام مستقل، وبموجب ذلك تصبح علاقة الصحافة بالحقيقة مرتبطة بعلاقتها بالواقع، إذ هي لا تستهدف الواقع إلا بحثاً عن الحقيقة الكامنة داخله. نستنتج من ذلك. أن الصحافة لا تتعامل مع واقع مثالي وبالتالي فهي غير قادرة على إنتاج الحقيقة، الصحفيون لا يسجلون الواقع كما هو؛ لأن ذلك ليس في متناولهم، بل يقومون بتوصيف خاص له، انطلاقاً من اختياراتهم الذاتية ومن توجههم الأيديولوجي، وانطلاقاً كذلك من انتقاء عناصر دون أخرى داخل الوضع المرصود.
مع الإشارة إلى أن هناك حالات تفرض على الصحفي الانزياح عن معيار الحياد (توظف في بعض الأحيان كلمة انحراف للدلالة على المعنى بشكل أقوى)، في مواجهة مواضيع معينة، من الصعب كبح العواطف والامتناع عن مشاركة الغضب مع السكان (مجازر الاحتلال الإسرائيلي، هجوم مسلح يقتل الأبرياء، الكوارث الطبيعية التي تخلّف الخراب والجرحى والموتى، عنصرية اليمين المتطرف…)، وفي مثل هذه الحالات، يمكن “تبرئة” الصحفيين من “افتقارهم إلى الحياد” لأن “انحرافهم” هو موضوع إجماع اجتماعي وإنساني واسع، إن عدم الحياد في هذه المواقف بالتحديد، يحظى بكثير من التسامح خاصة في التجارب الأنجلو سكسونية لأنه مرتبط بشعور إنساني عميق لا يمكن مداراته ولا تجنبه. [6]
في النهاية، يتبين لن أن لكل قاعدة استثناءات، لكن يتوجب علينا أن نعمل على الاستثناء بحدوده أي ألا نتوسع فيه، ويتوجب على الصحافة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي دائما وأبدا.
فرحان الحسبان
المصادر
[1] أفنان الماضي، التحيّز اللاواعي وتأثيره في الصحافة، الرابط ، تاريخ أخر مشاهدة: ١٩-٩-٢٠٢١.
[2] كيف يتجنب الصحفيون التمييز والكراهية؟ إصدار جديد لمعهد الجزيرة، الرابط ، تاريخ أخر مشاهدة: ١٩-٩-٢٠٢١.
[3] بشير الكبيسي، للحقيقة وجوه عدة، الرابط ، تاريخ أخر مشاهدة: ٢٠-٩-٢٠٢١.
[4] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الصحافة والتظليل، ٢٠٢٠، الرابط ، تاريخ أخر مشاهدة ٢٠-٩-٢٠٢١.
[5] خالدية مداح، القيود الواردة على حرية الصحافة، الرابط ، تاريخ أخر مشاهدة ٢١-٩-٢٠٢١.
[6] محمد أحداد، ضد الحياد في الصحافة، الرابط ، تاريخ أخر مشاهدة: ٢٠-٩-٢٠٢١.