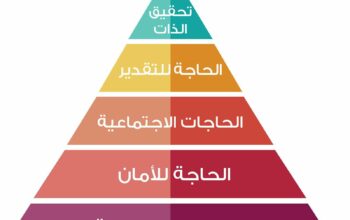تحمل لنا الصحف يوميا مئات الأخبار التي تحمل في طياتها فقدان الإحساس بالطمأنينة مما أدى إلى سيطرة موجة سلبية على شعورنا وإحساسنا تجاه الأشياء. انعكست ردود الفعل هذه على حياتنا الخاصة ونحن أيضا نعكسها على حياة المقربين منا وأسرنا. شهد العقد الأخير سلسلة مهولة للتقارير التي تنذر بخطر سيطرة المشاعر السلبية على الإنسان وخطر شعور الكبح في عكسه على تصرفات سلبية في حياته. منذ قديم الحضارات عرف الإنسان قوانين ومواثيق أخلاقية كوصايا العبرانيين العشر وقانون حامو رابي والتي يمكن أن نصنفها محاولات استئناس وإخضاع للشعور عند الإنسان. أو كما قال فرويد في كتابه الحضارة ومضارها أن تعين على المجتمع أن يفرض قواعد من خارجه لكبح الانفعالات الجامحة التي تنفلت فيه دون مرجع لها داخله. شهد العالم ومنذ عقد الثمانينات ثورة علمية في الدراسات التي تتعلق بمشاعر الإنسان. ربما تمثلت أهمها حين استطاع الإنسان أن يربط قدرته البصرية بالغموض الذي انتابه قرونا واستطاع أن يرى في عينه كيف يعمل المخ والأجزاء المسؤولة عن الإحساس عن طريق التكنولوجيات المصورة. بمعرفة الإنسان وفهمه للبيانات العصبية دور في فهمه كيف تحركنا مراكز الشعور بالمخ والتصرف وفقا لها.
عن طريق دراستنا لكيفية نشوء الشعور وآليته نستطيع البدء بفهم كيف يؤثر هذا على حياة الإنسان وتصرفاته وبه يمكن أن نحسن أداء أنفسنا وأداء أبناءنا في الحياة وزيادة القدرة على التعامل مع الظروف المختلفة واستيعاب طبيعة الشعور وتأثيره. في صدد هذا الفهم حاول العالم روبرت بولتشيك فهم الإطار العام للمشاعر ووضعها في عجلة واحدة تضم ستة مشاعر أساسية تنتاب كل واحد منا ويختبرها طيلة حياته. صنف بولتشيك هذه المشاعر إلى مشاعر تتسبب بالحب للنفس وهي السعادة، القوة والطمأنينة. في حين قابل هذه المشاعر، مشاعر أخرى وصفت بالعار وهي الإهمال، الخوف والكبح. استطاع التعبير من خلال شدة اللون المرتبط بكل شعور، التصرفات التي تبنى عليه والجذور التي تسببت به. وفقا لبولتشيك فإن الإنسان ينتقل من مرحلة العار للحب عبر مرحلة الغفران لنفسه وللمسببات. وضح بولتشيك أن كل هذه المشاعر هي تلقائية ويعرفها كل إنسان بغض النظر عن التفصيلات الأخرى كالجنس أو العمر. علينا أن نعرف كيف نتعامل معها لتحسن حياتنا وكيف نتصرف لا أن نزجرها أو نخجل منها.
يوصف الكبح على أنه إخضاع وجذب الشيء إليك. شعور الكبح يوصف بأنه رد الإرادة ومنعها وفقا لمحرك أقوى. حسب عجلة بولتشيك، شعور الكبح هو أحد المشاعر الأساسية التي تتسبب بشعور العار ووفقا له فإن الكبح له ستة مظاهر سلوكية تدل على شعور الإنسان به وهي اليأس، الحيرة، العجز، التخوف، القلق والخضوع. يوصف الخضوع على أنه استسلام دون مقاومة أو بعدها لقوة أعظم تمنعك من إرادتك الحقيقية وتعمل على انصياع سلوكك وفقا لرغبة لا توافق رغباتك الحقيقية. حسب بولتشيك فإن شعور الخضوع له جذران أولهما شعور الإنسان غير كفؤ. يشعر الإنسان أنه غير كفؤ حين ينتابه الخوف أن يكون محط سخرية للآخرين أو أن يكون منبوذ أو مكروه. ويشعر الإنسان بالدونية، الحساسية المفرطة تجاه التقييم السلبي والخجل من المواقف الإجتماعية. قد ترتبط أسباب الخضوع بشعور الإنسان بعدم القدرة على اتخاذ القرار والقلق من الفشل أو شعور الإنسان بعدم القدرة على التغيير وقد يرتبط بميل الإنسان لعدم الخروج من دائرة الراحة التي يرسمها لنفسه يرضخ لشعور الراحة الذي ينتابه ويرفض التجديد.
أذكر كيف كنت أقول لنفسي لن تستطيع على مجاراة هذا حين عرض علي أستاذ الفيزياء الإندماج في برنامج لدعم اليافعين لمساعدتهم على الإبتكار. زيادة معرفتهم وانفتاحهم على الثقافات الأخرى، رفدهم بالمهارات اللازمة لمستقبل أفضل. تبدو فرصة لا تعوض!، قاطع هذا الحماس كتحذير من أستاذة التاريخ بخطورة هذه الخطوة على شخص في سني خصوصا أنه وحسب ما حدثتني في ذلك الوقت، أن كل من خاض هذه التجربة عاد منها غير راض عن ما أضاع من أيام. ولا عن القيمة المعرفية المكللة بالنقص على حد تعبيرها والأهم من هذا كله فقدان الهوية الثقافية وضياعها لسنوات. سيطرت كلمات هذه الآنسة عليّ حينها، فرفضت أن أدخل التجربة حتى. لسنوات لم أستطع تفسير هذا التصرف لكن إن جعلنا عجلة المشاعر مرجعنا في هذا الحدث فإن ما انتابني حينها هو كبح لجموحي وقدرتي على التغيير، تسبب لي بخضوع لفكرة منعتني من معرفة قدراتي وتقديرها فشعرت أني غير كفؤ لهذه المهمة.
أما عن الجذر الثاني للخضوع فهو أن يشعر الإنسان أنه راضخ لرغبة في نفسه أو لرغبة في نفس أخرى أو قوة تفوقه. جميعنا نستذكر مواقف اختار فيها شخص آخر القرار بدلا منا بدافع أننا نجهل الشيء رغم معرفتنا به متجاهلا مشاعرنا وما نفكر. يروي أحد الأطفال تأثير سلوك حدث في طفولته عليه فيقول، أستذكر شعوري ين اختارت والدتي رداء الشتاء الجديد لي، كنت غضا حينها ولم يكن ذوقي نضج كما الآن حتى اخترت رداءا أحمرا يضج بالحياة والرسومات التي أحب؟. حملته فرحا إلى والدتي، جاء الرد حينها أن هذه الزركشات لا تناسب صبيا وليست لمن هو في عمري حاولت كفتى عنيد أن أحدثها بما يجول في رأسي لكن ردا واحدا غاضبا أخبرتني فيه والدتي أن الجميع سيضحك من مظهري حين أرتديه خصوصا زملائي الذين حتما سيسخرون حين يرونني. بنبرة تهكمية، حازمة أخضعت والدتي رغبتي لشراء رداء اخر لا يعجبني ولبسته طوال ذاك الشتاء.
إن تركيب اجزاء الدماغ والتلافيف المحيطة به تعطي انطباعا سيئا إذا شعر الإنسان بالكبت لشعوره وأن هناك من يتحكم به سواءً كان المؤثر خارجي أم داخلي من الإنسان نفسه. حتى لو حاول الإنسان كبح دموعه، فإن هذا يجعله لا يفلح في تسكين وتخفيف الشعور. من هنا تظهر أهمية الحوار الحقيقية التي تكمن في فتح خط تبادل المعلومات وطرق الأفكار والإنصات إلى ما يعتقده الآخرين وزيادة فهمهم للمشاعر وكيف يكون التعبير عنها وأسباب التصرفات التي يقومون بها. هذا من شأنه تعزيز ثقتهم بما يشعرون وأنه من الطبيعي على أي إنسان أن يشعر به وإعادة التفكير بما يجول في أذهانهم. من هنا نجعل أبناءنا يؤمنون أن مشاعرهم ليست عارا وأن كل إنسان يمر بالمشاعر السيئة قبل الجيدة. مهمتنا الأساسية تكمن في أن نشعرهم بأهميتهم وبانجازاتهم التي حققوها. أيضا، يقع على كاهلنا أن لا نهاجم أفكارهم أو ننتقدها بصورة لاذعة أو ساخرة. من هنا يمكنهم تحريك دوافعهم الذاتية ويجعلهم يؤمنون أن المحاولة مفتاح الحياة ونؤن بما يؤمنون كي نعلم ما وقر في نفوسهم.
لا يمكننا إهداء عقول إضافية لأبناءنا ليتسنى لهم فهم الحياة دفعة واحدة وحشو تجاربنا جلها في أدمغتهم كي يعقلون بها. لكن يتسنى لنا أن نكون حاضرين وفعالين في حياة أبناءنا ومن يهموننا وأن نفهم ما يحدث حولنا وكيف يمكن أن نساعدهم. نشعر بما يشعرون ونظهر طبيعيته وتلقائيته، ونعلمهم تقدير ذواتهم لا زجرها. فهمها كوحدة متكاملة ليصل بهم المطاف لحياة يتوازن فيها فهمهم لعواطفهم ومشاعرهم ليصلوا إلى السلام بين القلب والدماغ ليستقر هذا في الروح.
مريم رمزي
المصادر: كتاب الذكاء العاطفي، 2001، دانييل جولمان