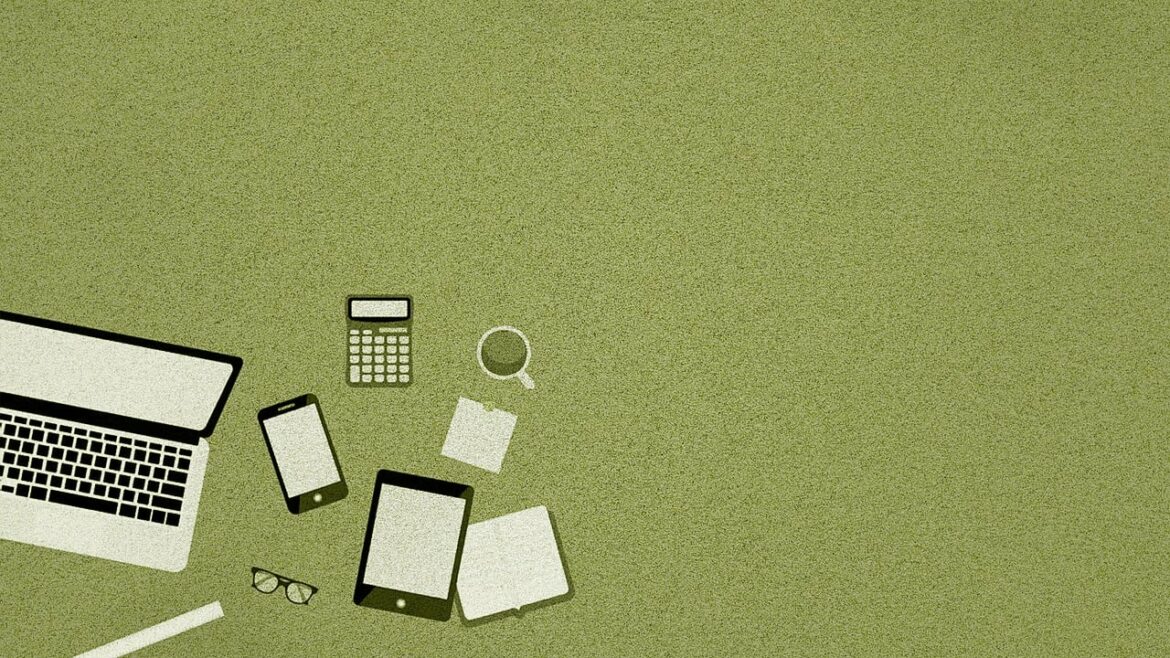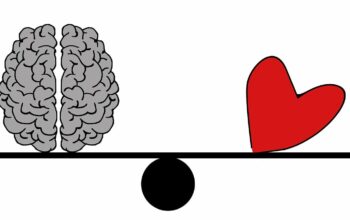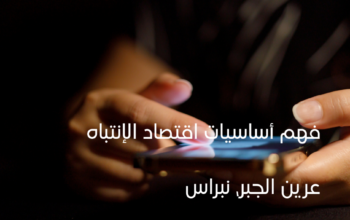النموذج المعرفي العربي
في اللغة العربية، هناك مفهوم يُعرف بـ”النموذج المعرفي”، وهو الإطار الفكري أو المرجعية الثقافية التي تستند إليها في صياغة الأفكار وفهم الظواهر. عندما نكتب عن خطاب الكراهية على الإنترنت باللغة العربية، يجب أن يكون المحتوى نابعا من سياق الثقافة العربية وليس مجرد ترجمة مباشرة من لغة آخرى، خاصة الإنجليزية. النموذج المعرفي العربي يعني التفكير باللغة العربية، والتعبير عن المفاهيم بما يتماشى مع قيم ومفردات هذه الثقافة. من المهم جدًا أن نحرر المعرفة والمصطلحات من هيمنة المرجعيات الأجنبية، وأن نصوغها بطريقة تعكس خصوصية مجتمعاتنا وسياقاتنا المحلية. وعندما نتحدث عن مفهوم خطاب الكراهية من منظور وطني أو محلي، يجب أن يكون هذا المفهوم مبنيًا على نموذج معرفي ينبع من بيئتنا وثقافتنا، وليس مجرد استنساخ لفكرة مأخوذة من كتاب مترجم أو إطار معرفي أجنبي.
مفهوم الخطاب: أبعاد لغوية ودلالات اجتماعية
الخطاب في اللغة العربية يحمل دلالات عميقة تتجاوز كونه مجرد “كلام”. فهو فعل مركب يجمع بين التوجيه والمَقصِدية، ويُعبر عن عملية تواصل منظمة تهدف إلى إيصال فكرة أو تأثير محدد. من الناحية الاصطلاحية، يُعرّف الخطاب باعتباره أداءً لغويًا يتسم بمنهجية وشدة تعكس أهمية الموضوع الذي يُطرح. ولا يُفهم الخطاب على أنه مجرد تعبير عفوي، بل هو بناء لغوي يتطلب الإعداد والتوجيه نحو الآخر. وزن “خِطاب” في اللغة يعكس بنية تعبيرية غنية (فعل ذو دلالة مزدوجة، اسم لوصف العملية أو الأداء، الخطاب كأداة)، حيث يرتبط أحيانًا بالفعل نفسه كما في “صراع” أو “قتال”، وأحيانًا أخرى يُضفي عنصر الشدة والمبالغة كما في “جهاد”، الذي لا يقتصر على وصف الفعل بل يتعداه ليُشير إلى طبيعته المكثفة. على هذا النحو، يشكل الخطاب جزءًا من فئة لغوية تتضمن كلمات تصف أدوات أو وسائل تُستخدم لتحقيق غايات معينة، مثل “سِراج” الذي يشير إلى أداة الإضاءة، أو “خِمار” الذي يرمز إلى غطاء للرأس.
الخطاب ليس مجرد نقل للكلام، بل هو سيرورة توجيهية تتطلب منهجية مدروسة. فهو يوجه الآخرين نحو فكرة أو موقف محدد، ويستخدم آليات تعبيرية تعكس البُعد الجمالي والوظيفي للغة العربية. هذا التوجيه يتسم بالمبالغة أحيانًا، حيث يستخدم الخطاب قوة لغوية لإحداث تأثير عاطفي أو معرفي على المُتلقي. الشدة والمبالغة ليست بالضرورة سلبية، بل يمكن أن تكون أداة فعّالة لتعزيز الرسائل المهمة. في الاستخدام الاصطلاحي، يُستخدم الخطاب لوصف العمل أو الأداء. فعندما نقول “خِطاب”، فإننا لا نعني فقط الكلام الذي يُقال، بل نعني أيضًا العملية التي يتم فيها إنتاج هذا الكلام، والطريقة التي يُوجه بها إلى المتلقين. وهذا المعنى يجعل الخطاب أكثر من مجرد فعل لحظي؛ إنه سلسلة من الأحداث التي تترابط لتكوّن تأثيرًا شاملًا. بهذا الفهم، يظهر الخطاب ككيان لغوي واجتماعي يتشابك مع الأبعاد الثقافية والمعرفية للمجتمع. إنه أداة لنقل الأفكار، ووسيلة لتشكيل العلاقات، ومجال للتعبير عن الذات والهوية. وهذا ما يجعل الخطاب، بمعناه الاصطلاحي واللغوي، عنصرًا أساسيًا في بناء التفاهم والتواصل في المجتمع العربي.
يتكرر استخدام وزن “فِعال” في اللغة العربية ليحمل دلالات مزدوجة تُبرز عمق المفهوم الذي يُشار إليه. فمن جهة، يشير هذا الوزن إلى الفعل نفسه كما يظهر في كلمات مثل “صراع” و”قتال”، حيث يعبّر عن حركة مزدوجة بين طرفين. ومن جهة أخرى، يُبرز وزن “فِعال” دلالة على الشدة أو المبالغة كما يظهر في كلمات مثل “جهاد” و”نضال”، حيث يُستخدم لتكثيف المعنى والإشارة إلى الجهد أو الكثافة المصاحبة للفعل. وبهذا، يصبح الخطاب أكثر من مجرد كلمة تُقال؛ إنه مفهوم يعكس عمقًا وشدة تجعل منه أكثر من تفاعل عابر.
العناصر الأساسية للخطاب
الخطاب، ليس مجرد تعبير عن فكرة أو قول. بل هو عملية معقدة تمزج بين التوجيه والشدة والمنهجية، مما يجعله أداة فعّالة تُستخدم لتحقيق التأثير في الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
- يمتاز الخطاب بعدة عناصر تُشكّل جوهره وتجعل منه فعلًا مركبًا ذا تأثير عميق. أول هذه العناصر هو التوجيه نحو الآخر. فالخطاب ليس فعلاً منعزلًا، بل هو رسالة موجّهة بوعي إلى طرف آخر، سواء كان فردًا أو جماعة. وهذا البُعد التواصلي يجعل الخطاب فعلًا اجتماعيًا بامتياز، حيث يسعى إلى التأثير على المتلقي وتحقيق غايات مختلفة.
- العنصر الثاني هو الشدة والمبالغة التي ترافق الخطاب. فهو ليس مجرد كلام يُقال عفويًا أو لحظيًا، بل هو تفاعل لغوي يأخذ منحى مقصودًا يتسم بالشدة أحيانًا. هذه الشدة قد تُبرز الفكرة وتزيد من تأثيرها على المتلقي، مما يجعل الخطاب وسيلة فعّالة لنقل المعاني وإحداث التغيير.
- أما العنصر الثالث فهو المنهجية. فالخطاب ليس عشوائيًا أو ارتجاليًا، بل هو عملية مدروسة ومنظمة تمتد عبر مراحل محددة. يتم تصميمه ليخدم غرضًا معينًا، سواء كان غرضًا إيجابيًا مثل التعليم والتثقيف أو غرضًا سلبيًا مثل التحريض في سياق خطاب الكراهية. وبهذا، يتحول الخطاب إلى أداة محورية في تشكيل السلوكيات وصناعة التغيير.
خطاب الكراهية على الإنترنت
خطاب الكراهية على الإنترنت يُعد جزءًا من الظاهرة العامة لخطاب الكراهية، لكنه يتميز بخصائص فريدة ترتبط بالفضاء الإلكتروني. في هذا السياق، لا يُختزل خطاب الكراهية في التحريض العلني فقط، بل يتعدى ذلك إلى التوجيه المباشر نحو العنف أو الكراهية. يمكن أن يشمل ذلك التحريض على الكراهية ضد مجموعة كاملة أو أحد أفرادها، بناءً على عوامل مثل العرق، اللون، الدين، المعتقد، الأصل القومي، أو الانتماء الإثني. خصوصية خطاب الكراهية على الإنترنت تكمن في البيئة التي يحدث فيها. الإنترنت، باعتباره فضاءً إلكترونيًا واسع النطاق يتيح للأفراد نشر محتوياتهم بشكل مجهول أو شبه مجهول. هذه المجهولية تُعطي مثيري خطاب الكراهية شعورًا بالأمان من العقاب، حيث يكونون مختبئين خلف شاشات أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة. هذا الإحساس الزائف بالحصانة قد يشجعهم على أن يكونوا أكثر قسوة وعدوانية مقارنة بالتعبير عن الكراهية وجهًا لوجه، حيث قد تكون هناك قيود اجتماعية أو خوف من العواقب الفورية. على الرغم من أن خطاب الكراهية قد يظهر أيضًا في التواصل المباشر، إلا أن الإنترنت يوفر منصة واسعة ومنتشرة تُمكن من إيصال الرسائل إلى جمهور كبير بسرعة، مما يزيد من تأثيرها السلبي. هذا السياق الإلكتروني يضع تحديات جديدة أمام جهود التصدي لخطاب الكراهية، إذ يتطلب ذلك فهمًا دقيقًا للطبيعة الخاصة لهذا النوع من الخطاب وكيفية مكافحته بفعالية.
عناصر خطاب الكراهية على الإنترنت: قراءة معمّقة
خطاب الكراهية على الإنترنت هو ظاهرة معقدة تتألف من عدة عناصر مترابطة، تساهم معًا في تشكيل مخاطره وآثاره. لفهم هذه الظاهرة بعمق، ينبغي تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية، مع تسليط الضوء على التفاعل بين النية، المحتوى، السياق، والنتائج المحتملة.
-
النية: المحرك الأساسي لخطاب الكراهية
النية تُعد أحد أهم العناصر في تحديد ما إذا كان تعبير معين يقع ضمن خطاب الكراهية. غير أن استيضاح النية يمثل تحديًا قانونيًا وأخلاقيًا؛ إذ أن إثبات وجود نية للتحريض على الكراهية يتطلب دراسة متأنية للأفعال والمحتوى المعبّر عنه. هنا يظهر دور الجهات القضائية والهيئات المختصة، التي تحتاج إلى تقييم العنصر البشري بعمق: هل كان هناك قصد فعلي لتوجيه الكراهية ضد مجموعة معينة؟ وما مدى وعي المتحدث بالعواقب المحتملة لتعبيره؟ هذا العنصر يسلط الضوء على أهمية تطوير أدوات تحليلية دقيقة تسهم في كشف النية المضمرة خلف الخطاب.
-
المحتوى وسياق التعبير: المفتاح لفهم الخطاب
لا يمكن فصل محتوى خطاب الكراهية عن سياقه. فالتعبير الذي قد يبدو عاديًا في سياق معين قد يتحول إلى خطاب كراهية في سياق آخر. على سبيل المثال، استخدام كلمات أو رموز تحمل دلالات مهينة أو تحريضية يعتمد بشكل كبير على الظروف المحيطة؛ مثل الجغرافيا، الأحداث الراهنة، العلاقات الاجتماعية بين المجموعات المستهدفة، والوسيلة المستخدمة للتعبير. هذا يبرز أهمية تقييم الخطاب ككل، بما في ذلك فهم خلفيات المتحدث والجمهور المستهدف، لتمييزه عن حرية التعبير المشروعة.
-
النتائج المحظورة: الأثر الاجتماعي الخطير
لا يتوقف خطر خطاب الكراهية عند حدود الإساءة اللفظية، بل يمتد ليهدد السلم الاجتماعي والنظام العام. يمكن لخطاب الكراهية أن يؤدي إلى نتائج فورية، مثل التحريض على العنف أو إثارة الفتن بين الفئات المختلفة في المجتمع. وعندما يُترك دون رادع، يمكن أن يتحول إلى جرائم كراهية تُمارس ضد الأشخاص أو المجموعات المستهدفة. تشمل النتائج المحظورة جميع العواقب الاجتماعية الضارة، بدءًا من التأثير النفسي على الأفراد وحتى الإخلال بالأمن المجتمعي. هذه الآثار ليست مجرد احتمالات نظرية، بل واقع شهدته مجتمعات تعرضت لخطاب كراهية أدى إلى انقسامات عميقة وصراعات مدمرة.
-
النية في التحريض ضد مجموعة معينة
جوهر خطاب الكراهية هو التعبير الذي يحمل في طياته نية واضحة للتحريض على الكراهية ضد مجموعة محددة، سواء كانت هذه المجموعة عرقية، دينية، إثنية، أو مرتبطة بأي خاصية مميزة. هذه النية تتجاوز مجرد النقد أو المعارضة لتتحول إلى حملة موجهة لخلق أجواء عدائية وتدمير روابط العيش المشترك.
إشكالية النية في خطاب الكراهية
إشكالية النية في خطاب الكراهية على الإنترنت تنبع من طبيعتها المعقدة والمتشابكة، حيث يصعب تحديدها بوضوح وإثباتها قانونياً أو اجتماعياً. هناك عدة أوجه لهذه الإشكالية:
1. الصعوبة في إثبات النية: النية هي عنصر ذاتي يعتمد على ما كان يقصده المتحدث عند صياغة أو نشر محتوى معين. قد يكون من الصعب للغاية إثبات أن النية كانت للتحريض على الكراهية وليس مجرد التعبير عن رأي شخصي أو الانتقاد المشروع. غالباً ما يدّعي المتحدثون أن تصريحاتهم أُسيء فهمها أو أنها كانت مجرد “دعابة”، مما يجعل النية غامضة وغير واضحة. ومع ذلك فمن الناحية القانونيّة يمكن رصد مؤشرات تشير للنيّة وتساهم بإثباتها.
2. التداخل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية: التمييز بين التعبير المشروع وخطاب الكراهية يرتبط غالباً بنيّة المتحدث. هذه الإشكالية تعني أن النية قد تُستخدم كذريعة لحماية المتحدثين الذين ينشرون خطاباً محرضاً على الكراهية، خاصة إذا تم تقديمه كتعليق فكاهي أو انتقاد مشروع.
3. النية الخفية أو غير المباشرة: أحياناً يكون خطاب الكراهية مموهاً بطريقة لا تظهر النية العَدائية بوضوح. على سبيل المثال، قد يتم استخدام رموز، إيحاءات، أو تعبيرات ذات دلالة عدائية في ثقافات معينة، لكن يصعب إثبات نية الكراهية إذا لم يتم التصريح بها بشكل مباشر.
4. تأثير الجمهور والسياق: حتى إذا كانت نية المتحدث غير واضحة، فإن الجمهور المستهدف أو سياق النشر قد يُحوّل خطاباً ظاهرياً بريئاً إلى خطاب كراهية بناءً على كيفية تلقيه أو استخدامه. المشكلة هنا أن النية الأصلية للمتحدث قد تصبح أقل أهمية من التأثير الفعلي للخطاب.
5. المسؤولية القانونية: في القانون، قد تتطلب بعض التشريعات إثبات النية للتحريض على الكراهية كشرط لتجريم خطاب معين. هذه المتطلبات تجعل من الصعب محاسبة الأفراد الذين يستخدمون خطاب الكراهية بذكاء لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، على الرغم من الأثر السلبي لخطابهم.
6. الإشكاليات الأخلاقية والاجتماعية: التركيز على النية وحدها قد يؤدي إلى التغاضي عن العواقب العملية للخطاب. حتى إذا لم تكن هناك نية واضحة لنشر الكراهية، فإن الخطاب قد يؤدي إلى تفاقم التمييز أو العنف. هذا يطرح السؤال: هل يجب أن تكون النية شرطاً ضرورياً في تقييم خطاب الكراهية، أم أن التركيز يجب أن يكون على الأثر الفعلي؟
المحتوى، السياق والأثر
التمييز بين النقد المشروع وخطاب الكراهية يتطلب مراعاة عوامل متعددة تتعلق بالمحتوى، النية، والسياق. على سبيل المثال، إذا قام شخص بانتقاد سلوك معين مرتبط بدين يشكل الأغلبية في منطقة معينة، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه محاولة للإصلاح أو النقد البنّاء. ومع ذلك، إذا كان هذا الدين يمثل “أقلية” في المنطقة نفسها، فقد يتم تفسير النقد على أنه استهداف أو تحريض ضد هذه المجموعة ما يخلق حساسية خاصة. حساسية الموضوع تعتمد بشكل كبير على المنطقة الجغرافية، السياق الثقافي، والأحداث الراهنة المحيطة بالنقاش. هذه العناصر تؤثر على كيفية استقبال الخطاب وتفسيره. ومن هنا يصبح من الضرورة التفكير في النية الكامنة وراء التعبير ومحتوى الخطاب والسياق الذي قُدم فيه.
العوامل الثلاثة (النية، المحتوى، والسياق) تشكل الأساس الذي يجب أخذه في الاعتبار قبل تصنيف أي تعبير على أنه خطاب كراهية. إضافة إلى ذلك، فإن خطاب الكراهية عادة ما يكون موجهاً ومقصوداً بطريقة منهجية، ما يعزز احتمالية أن يؤدي إلى نتائج خطيرة، بما في ذلك التحريض على جرائم الكراهية. وعندما يتحول الخطاب إلى أفعال أو جرائم كراهية، فإنه ينتقل إلى مستوى أخطر، له تبعات قانونية واجتماعية عميقة.
في المسيرات والاحتجاجات، قد يظهر خطاب الكراهية من خلال رفع رموز مثل الصليب المعقوف، أو من خلال أفعال مثل حرق المصاحف أو الأعلام، والتي تُعتبر تعبيرات عن ازدراء مُوجّه لجماعة دينية أو وطنية بعينها. كذلك، يُعدّ الرسم على الجدران (الجرافيتي) وسيلة ممكنة لنشر رسائل مسيئة سواء عبر كلمات تحمل إهانة مباشرة أو صور ورموز موجهة ضد جماعة معينة. كما قد يتجلى خطاب الكراهية أيضًا في وسائل أخرى مثل وضع الملصقات التي تحتوي على مضامين مسيئة وتوزيع المنشورات التي تعزز الكراهية واستخدام وسائل الإعلام التقليدية كالتلفاز والراديو لنشر محتويات تحريضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنترنت يشكل اليوم منصة رئيسية لانتشار خطاب الكراهية، حيث يُستخدم للتعبير عن الكراهية أو التمييز بطرق تتجاوز الزمان والمكان.
هذه الأمثلة تبرز أن خطاب الكراهية ليس مقتصرًا على الكلمات، بل يمتد ليشمل مجموعة من السلوكيات والوسائل التعبيرية التي يمكن أن تكون أكثر تأثيرًا وانتشارًا في بعض الأحيان. حيث يتجاوز خطاب الكراهية حدود الكلمات المنطوقة أو المكتوبة، ليشمل العديد من الأشكال التعبيرية الأخرى التي يمكن أن تحمل معانٍ عدائية أو تحريضية. من أبرز مظاهر خطاب الكراهية استخدام الرموز والإشارات المهينة أو المستفزة في الفضاء العام، والتي قد تكون مقصودة لإثارة الكراهية أو التمييز ضد أفراد أو جماعات معينة. لمواجهة هذه الإشكالية، يمكن التركيز على “العناصر الموضوعية” إلى جانب النية. من وسع هذا النهج يمكن أن يقلل من الاعتماد على النية وحدها، مما يساهم في التصدي لخطاب الكراهية بشكل أكثر فعالية. مثل:
- المحتوى: الكلمات المستخدمة، الرموز، والصور.
- السياق: الظروف التي أُنتج فيها الخطاب.
- الأثر: النتائج المترتبة على نشر الخطاب.
تعريفات خطاب الكراهية الرقمي: رؤية متكاملة من الجهات الدولية
تجمع هذه التعريفات بين العناصر الأساسية لخطاب الكراهية، بما في ذلك التحريض، النشر، الترويج، والتبرير، مع التركيز على خصائص محددة مثل العرق والدين والأصل. السياق الإلكتروني يضيف بُعدًا خاصًا، حيث يكون الخطاب أقل تعرضًا للمساءلة وأكثر خطورة في تأثيره الاجتماعي.
تعريف مجلس أوروبا: يتناول مجلس أوروبا خطاب الكراهية باعتباره مصطلحًا شاملاً يغطي جميع أشكال التعبير التي تعمل على نشر الكراهية العنصرية، أو كراهية الأجانب، أو معاداة السامية، أو غيرها من أشكال الكراهية التي تستند إلى التعصب. يشمل ذلك التحريض والترويج والتبرير للكراهية. كما أن التعصب، وفق هذا السياق، يتمثل في القومية العدوانية، النزعات العرقية، التمييز، والعداء تجاه الأقليات والمهاجرين.
بروتوكول مجلس أوروبا للجريمة السيبرانية: في البروتوكول الإضافي الخاص بالجريمة السيبرانية، يُعرّف خطاب الكراهية الرقمي على أنه “أي مادة مكتوبة، صورة، أو تمثيل آخر للأفكار والنظريات التي تدعو إلى الكراهية أو التمييز أو العنف، أو تروج لها أو تحرض عليها ضد فرد أو مجموعة بناءً على العرق، اللون، النسب، الأصل القومي، الإثني، أو الدين في حال كان الدين يُستخدم كذريعة لهذه العوامل”.
تعريف الاتحاد الأوروبي (القرار الإطاري لعام 2008): وفقًا للاتحاد الأوروبي، يُعرّف خطاب الكراهية بأنه “التحريض العلني على العنف أو الكراهية الموجهة ضد مجموعة من الأشخاص أو فرد منهم بناءً على العرق، اللون، الدين، النسب، أو الأصل القومي والإثني”.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: تستند المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تعاملها مع قضايا خطاب الكراهية إلى تعريفه كأي شكل من أشكال التعبير الذي ينشر أو يحرض أو يبرر الكراهية العنصرية، كراهية الأجانب، معاداة السامية، أو غيرها من أشكال الكراهية المرتبطة بالتعصب. تستخدم المحكمة هذا التعريف كإطار مرجعي لحسم النزاعات المرتبطة بخطاب الكراهية.
رؤية مقارنة لخطاب الكراهية في السياق الأوروبي والأردني
مجلس أوروبا يعرّف خطاب الكراهية، خاصة على الإنترنت، بأنه يشمل أشكال التعبير التي تقوم على التحريض أو الترويج أو التبرير للكراهية تجاه الآخرين. هذا التعريف ينبع من السياق الأوروبي الذي يتميز بحساسية خاصة تجاه قضايا مثل التعصب، نظرًا لكونها جزءًا من نسيج تاريخي مرتبط بصراعات قومية وعدوانية أثرت على الأقليات والمهاجرين. أوروبا لديها تجربة طويلة مع قضايا الأقليات والمهاجرين، حيث تستقبل موجات مستمرة من الهجرة، سواء من البحر المتوسط أو مناطق نزاع أخرى، مما يزيد من تعقيد القضية.
في السياق الأوروبي، يُلاحظ أن التعامل مع المهاجرين يتأثر أحيانًا بالمظهر أو الأصل. فمثلاً، المهاجر الذي يُعتبر “أوروبيًا” أو يتمتع بمظهر معين قد يواجه تعاملاً مختلفًا عن الآخرين، مما يُبرز وجود تحيزات عميقة داخل المجتمعات الأوروبية. لذلك، تم تطوير بروتوكولات قانونية واجتماعية لمواجهة خطاب الكراهية المرتبط بهذه الظواهر، بما في ذلك الجرائم السيبرانية.
أما في الأردن، فإن مفهوم خطاب الكراهية يحتاج إلى تأطير ضمن سياق مختلف. هنا، ينبغي فهم المصطلحات بدقة: هل كلمة “الأقليات” مستخدمة، وهل لها مكان في السياق الأردني؟ الأردن لا يواجه نفس الظروف التي تعيشها أوروبا من حيث طبيعة تدفق المهاجرين، وبالتالي فإن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يُبنى على سياق محلي يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي. الاختلاف الأساسي بين السياقين يكمن في كيفية تعريف السلطة لمظاهر خطاب الكراهية. في أوروبا، يتم التركيز على المواد العنصرية أو المعادية للأجانب، سواء كانت مكتوبة أو مصورة أو تمثيلية. أما في الأردن، فإن التعامل مع خطاب الكراهية قد يحتاج إلى فهم أعمق للظروف المحلية، مع مراعاة التمييز في التعامل مع “الأقليات” واللاجئين بطريقة تعكس الاحتياجات والحقائق المحلية.
ملخص قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية في الجزائر (2020)
الجزائر قد أصدرت قانونًا خاصًا بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وهو القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أبريل 2020. يهدف هذا القانون إلى منع ومكافحة جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ويشمل ذلك التعبيرات التي تروج أو تبرر التمييز أو تتضمن احتقارًا أو عداءً أو تحريضًا على العنف.بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الجزائر القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أغسطس 2009، الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. يهدف هذا القانون إلى وضع آليات للرقابة على الإنترنت ومحاربة الجنح المرتبطة بالشبكة الافتراضية.
توصيات ضمن إطار مشروع “نبراس”
أوصى التقرير بتعريف ودمج مفاهيم التمييز وخطاب الكراهية في القوانين ذات العلاقة. عُرِّف التمييز بأنّه “أي تمييزٍ أو استبعادٍ أو تفضيلٍ يستند إلى اللون، الدين، العرق، النسب، اللغة، الانتماء الجغرافي أو الحالة الصحية، بهدف التأثير على التمتع أو ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بشكل متساوٍ”. أما خطاب الكراهية، فقد عُرِّف بأنّه “أي تعبيرٍ متعمد يُثير الكراهية بين الأفراد، سواءً كان عبر الكلام، الكتابة، النشر، الرسم، الإشارة، التصوير، الأداء أو أي شكلٍ من أشكال التعبير، بغض النظر عن الوسائل المستخدمة؛ سواءً كان ذلك بين أفراد المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة”.
هرم الكراهية كتَأصيل نظريّ
هرم الكراهية هو إطار تحليلي يوضح كيفية تصاعد الكراهية داخل المجتمع عبر مراحل تدريجية تبدأ من التحاملات البسيطة وتتصاعد إلى العنف الممنهج. يُستخدم هذا الهرم في مناهج الأمم المتحدة لتحليل النزاعات وتحويلها، حيث يساعد على فهم جذور الكراهية ومظاهرها المختلفة وكيفية معالجتها. تبدأ قاعدة الهرم بممارسات التحيز، وهي المواقف السلبية أو الصور النمطية التي يحملها الأفراد تجاه جماعات معينة. هذه الممارسات تبدو غير مؤذية في البداية، مثل النكات أو الافتراضات المسبقة، لكنها تغذي ثقافة الإقصاء وتبرر سلوكيات أكثر خطورة. من هنا، يتقدم الأمر إلى التمييز، وهو ترجمة تلك التحيزات إلى أفعال ملموسة أو سياسات تضر بحقوق وحريات الجماعات المستهدفة. التمييز قد يكون فرديًا، مثل رفض شخص تقديم خدمة بناءً على انتماء الآخر، أو مؤسسيًا، حيث تتبنى المؤسسات قوانين وسياسات تؤدي إلى الإقصاء الممنهج لجماعات معينة.
مع مرور الوقت، يؤدي التحيز والتمييز إلى تمهيد الطريق لخطاب الكراهية، وهو المستوى التالي في الهرم. يتمثل خطاب الكراهية في التعبير اللفظي أو الكتابي أو السلوكي الذي يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز تجاه مجموعة معينة. خطاب الكراهية لا يقتصر فقط على التعبيرات المباشرة، بل يشمل النشر والإعلان في الفضاء العام أو الرقمي الذي يعزز مشاعر العداء ويهدد السلم الاجتماعي. إذا لم تتم معالجة هذه المستويات الأولية، يمكن أن يتصاعد الوضع إلى مستويات أعلى في الهرم، وهي العنف الفردي ضد أفراد من الجماعات المستهدفة. في النهاية، قد يصل الوضع إلى أعلى مستويات الكراهية في الهرم: العنف الجماعي أو الممنهج، والذي يشمل التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية، حيث تصبح الكراهية أداة للسيطرة والقضاء على جماعات بأكملها.
التحيز والتمييز هما عنصران رئيسيان في هرم الكراهية، ويُعد فهمهما أساسيًا لفهم كيفية تصاعد النزاعات والكراهية. إن مواجهة التحيز والتمييز في مراحلهما الأولى أمر حاسم لمنع تصاعد الكراهية داخل المجتمع. عبر تعزيز القيم الإنسانية والمساواة والعيش المشترك، يمكن الحد من تأثير الكراهية قبل أن تتطور إلى عنف أو جرائم كبرى.
التحيز هو المستوى الأولي للكراهية، ويتمثل في المواقف السلبية أو الافتراضات المسبقة التي يحملها الأفراد تجاه جماعات معينة. قد يظهر التحيز في أشكال بسيطة، مثل النكات التي تعزز الصور النمطية، أو التعليقات التي تعكس عدم المساواة بشكل غير مباشر. على الرغم من أن التحيز يبدو غير ضار في البداية، إلا أنه يغرس ثقافة الإقصاء ويخلق بيئة تبرر سلوكيات أكثر خطورة. أما التمييز هو خطوة تصعيدية تُترجم فيها التحيزات إلى أفعال أو سياسات تضر بالجماعات المستهدفة. يتمثل التمييز في منع الحقوق أو الحريات الأساسية بناءً على الانتماء لجماعة معينة، مثل حجب فرص التعليم أو العمل أو الخدمات الاجتماعية. قد يكون التمييز فرديًا، عندما يمارسه شخص تجاه آخر، أو مؤسسيًا، عندما تكون السياسات والقوانين مصممة لتهميش جماعات معينة. بمعنى آخر، التحيز يغذي العقلية التي تبرر التمييز، بينما التمييز ينقل هذه العقلية إلى أفعال تُرسخ عدم المساواة والاضطهاد. إذا لم يتم التصدي لهذين العنصرين في مراحلهما المبكرة، فإنهما يمهدان الطريق لمزيد من التصعيد داخل هرم الكراهية، وصولًا إلى خطاب الكراهية والعنف الممنهج.
التفريق بين التحيز والتمييز وأهمية الخصائص المحمية
الخصائص المحمية: خطاب الكراهية يمكن أن يستهدف فردًا أو مجموعة بناءً على خصائص محددة تشترك فيها هذه المجموعة، مثل العرق، الدين، الجنسية، أو أي عامل آخر أساسي يعرّف الهوية الجماعية. تُعرف هذه الخصائص بـ”الخصائص المحمية”، وهي العناصر التي تُستخدم كأسباب للتمييز أو الاضطهاد. لفهم الخصائص المحمية، يجب أخذ السياق الاجتماعي والتاريخي بعين الاعتبار. يتطلب ذلك التعرف على تاريخ التمييز والاضطهاد في دولة معينة، إضافة إلى مشكلاتها الاجتماعية الراهنة. وبالتالي، الخصائص المحمية تشمل ليس فقط السمات التي كانت أساسًا للتمييز أو الاضطهاد في الماضي، بل أيضًا السمات التي تُستخدم حاليًا كأساس لحوادث التمييز أو الاضطهاد.
التمييز: التمييز هو فعل أو سياسة تميز بين الأفراد أو الجماعات بناءً على خصائصهم المحمية، مثل الجنس، العرق، الدين، أو اللغة. يتم تناول هذه الخصائص المحمية في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، حيث توفر حماية واسعة النطاق ضد التمييز. على سبيل المثال، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تُحدد قائمة مفتوحة بالخصائص المحمية التي يُحظر التمييز بناءً عليها، مثل:
- الجنس
- العرق
- اللون
- اللغة
- الدين
- الرأي السياسي أو غير السياسي
- الأصل القومي أو الاجتماعي
- الانتماء إلى “أقلية قومية”
- الممتلكات أو الولادة أو أي وضع آخر
الفارق بين التحيز والتمييز
- التحيز: هو موقف أو تصرف داخلي يتسم بالسلبية تجاه مجموعة أو فرد بناءً على خصائص محمية. غالبًا ما يظهر التحيز في شكل مواقف أو أفكار مسبقة دون أي إجراء ملموس.
- التمييز: هو التصرف الفعلي الذي ينتج عن التحيز، حيث يتحول إلى سياسات أو ممارسات عملية تضر بحقوق الأفراد أو الجماعات بناءً على خصائصهم المحمية.
معالجة التحيز قبل أن يتحول إلى تمييز هي الخطوة الأساسية لتحقيق المساواة وتعزيز احترام حقوق الإنسان. الخصائص المحمية ترتبط بمفهوم التمييز، لكنها تقدم منظورًا مختلفًا للتعامل معه. من هذا المنظور، التمييز لا يُنظر إليه بناءً على مرجعيته أو شكله أو لونه، بل على أساس تأثيره على الفئات المستهدفة. الخصائص المحمية تُحدد المجموعات أو الأفراد الذين يحتاجون إلى حماية خاصة بناءً على عوامل مثل الجنس، العرق، أو العمر. مثلًا، حماية النساء والأطفال تكون بهدف تأمين حقوقهم وتعزيز العدالة. هناك مدرستان فكريتان في التعامل مع هذه القضية. الأولى تركز على حماية الأقليات والمجموعات المحمية، التي قد تواجه تحديات خاصة مقارنة بالأغلبية، مما يستدعي دعمًا خاصًا لضمان حصولها على حقوق متساوية. أما المدرسة الثانية، فتنظر إلى التمييز كظاهرة شاملة -كمبدأ- تتطلب معالجة بغض النظر عن طبيعة المجموعة المتأثرة. هذا التوازن بين المدرستين يهدف إلى بناء مجتمع عادل يشمل الجميع، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بحقوق الآخرين.
تعاريف لخطاب الكراهية على الإنترنت في الأردن
ما نتحدث عنه ليس مجرد تعريف بل مفهوم أوسع يعكس النموذج المعرفي الجمعي الذي يتطلب منا رؤية أعمق وأكثر شمولية. إذا كنا نعمل على إعداد خطة وطنية تهدف إلى تعزيز تقبل المجتمع للاختلاف والتعددية الثقافية، فإن الهدف ليس السعي لجعل الجميع متشابهين في التفكير أو المظهر، بل خلق بيئة تعزز التفاهم والاحترام للاختلافات كجزء أساسي من العيش المشترك. في هذا السياق، ينبغي أن تشمل الجهود حماية الضحايا من تأثيرات خطاب الكراهية، مع مراعاة الأثر والنتائج المحتملة لهذا الخطاب، خاصة الرقمي. الإنترنت يوفر مساحة مفتوحة قد تُستغل في نشر الكراهية والتحريض بسبب قلة القيود وضعف آليات المساءلة. يجب أن تتوازن حماية الحرية الشخصية مع إطار قانوني واجتماعي يضمن عدم استغلال هذه الحرية لنشر خطاب يهدد السلم المجتمعي. كل جهة معنية ترى خطاب الكراهية من زاوية معينة: قانونية، اجتماعية، أو ثقافية، ويجب أن تُدمج هذه الزوايا في صياغة استراتيجية شاملة. وهنا مجموعة من النقاط لأخذها بعين الإعتبار:
- عند صياغة تعريف شامل لخطاب الكراهية، ينبغي النظر إلى تعريفاته من أكثر من منظور. أولاً، من الضروري وضع تعريف اصطلاحي يوضح المفهوم بشكل مجرد. ثانيًا، يُفضل تضمين تعريف لغوي يشرح المصطلح بطريقة أكثر تجريدًا وارتباطًا بجذوره الثقافية واللغوية. وأخيرًا، يجب أن يتوج ذلك بتعريف إجرائي يُستخدم عمليًا لتطبيق القوانين والمعايير المتعلقة بخطاب الكراهية في السياقات المختلفة.
- تعريف خطاب الكراهية يمكن تلخيصه على أنه جميع أشكال التعبير أو الأنماط التي تحرض على العنف أو تثير الكراهية أو تروج لها أو تميز بين الأفراد أو الجماعات على أساس العرق، الدين، اللغة، الحالة الصحية، أو أي خصائص أخرى. هذه الأفعال قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم المجتمعي، تقويض النظام العام، أو إشعال العنف داخل المجتمع. خطاب الكراهية يُعرف بأنه كل قول، فعل، كتابة، أو حتى صورة، رسم، أو رمز (كاركتر) يُقصد منه التحريض على الكراهية أو إثارة الفتنة بين فئات المجتمع. وعند التطرق إلى مفهوم “الفتنة”، من الضروري تحديد تعريف واضح لها، لتجنب اللبس وضمان الدقة في تطبيق هذا المصطلح.
- فهم تعريف خطاب الكراهية وأسباب تعريفه بدقة أمر بالغ الأهمية لتجنب الالتباس الذي قد يحدث بينه وبين مفاهيم أخرى، مثل التنمر. على سبيل المثال، قد يسأل البعض عن العلاقة بين التنمر وخطاب الكراهية، وهذا يُبرز الحاجة إلى تعريف واضح يميز بينهما. يهدف تعريف خطاب الكراهية إلى توضيح المفاهيم بشكل دقيق للمجتمع، مما يساعد على تحديد أوجه الاختلاف بينه وبين أشكال أخرى من السلوكيات مثل التنمر. فبينما يُعتبر التنمر سلوكًا عدوانيًا يستهدف أفرادًا محددين في مواقف محدودة، فإن خطاب الكراهية يتجه نحو استهداف جماعات أو فئات بأكملها بشكل قد يسبب ضررًا أوسع. لهذا السبب، يعد توضيح هذه الفروقات أمرًا حاسمًا لتوعية الأفراد بالمخاطر المحتملة لكل منهما.
- قد يحدث خلط بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، حيث قد يدعي البعض أنهم فقط يعبرون عن آرائهم. ومع ذلك، تختلف معايير حرية التعبير وحدودها بين المجتمعات، وذلك بناءً على الخصائص الثقافية والقانونية لكل مجتمع. على سبيل المثال، قد يُنظر إلى تعبير معين في دولة ما على أنه ممارسة مشروعة لحرية التعبير، بناءً على التشريعات السائدة فيها. بينما في دولة أخرى، قد يُعتبر نفس التعبير خطاب كراهية لأنه يتعارض مع القوانين التي تهدف إلى حماية المساواة أو منع التحريض. هذا التباين في التشريعات يعكس اختلاف الأولويات والقيم بين المجتمعات، مما يجعل من الضروري فهم السياقات القانونية والثقافية عند تقييم التعبيرات المختلفة.
- تتنوع الدوافع التي تؤدي إلى إطلاق خطاب الكراهية على الإنترنت، حيث يمكن أن تكون مرتبطة بالتمييز بناءً على الجنس، العرق، أو أي خاصية أخرى تُستغل كوسيلة لتبرير العداء. هذه الدوافع لا تقتصر على الجهل فقط، بل قد تتضمن تحيزات شخصية أو اجتماعية تهدف إلى إثارة النعرات داخل المجتمع.
- تتضح أهمية تضمين عنصر النتيجة في تعريف خطاب الكراهية، حيث يُعتبر تأثير التعبير على حريات الآخرين وأمن المجتمع معيارًا أساسيًا في تمييزه عن الأفعال الأخرى. فعلى سبيل المثال، قد يتجاوز خطاب الكراهية حدود التعبير الشخصي ليشكل تهديدًا مباشرًا على حرية الآخرين أو سلامتهم، مما يجعله أقرب إلى جريمة الكراهية.
- كما أن خطاب الكراهية لا يقتصر على النصوص أو المنشورات الأصلية، بل يمكن أن يظهر في التعليقات المرتبطة بها على منصات الإنترنت. كثيرًا ما تتضمن هذه التعليقات تبريرات أو تعزيزًا للكراهية، مما يجعل إضافة مصطلحات مثل “التبرير” و”التمييز” إلى التعريف أمرًا بالغ الأهمية.
- في السياق الأردني، يُلاحظ أن قانون العقوبات لم يتناول بشكل كافٍ مسألة “التمييز”، حيث ورد ذكره بشكل محدود جدًا. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التشريعات لتغطي هذا الجانب المهم من خطاب الكراهية.
- عند الحديث عن خطاب الكراهية، تبرز أهمية اللغة المستخدمة ودقتها. مصطلح “فئة” مثلًا، قد يحمل دلالات حساسة تشير إلى مجتمع أكبر يتضمن مكونات قد تُعتبر ظالمة أو مستضعفة، وهذا يعتمد على السياق. عندما نستخدم مصطلح “فئة ذوي الإعاقة”، فإننا نشير إلى شريحة محددة من المجتمع، ولكن ينبغي تجنب استخدام لغة تزيد من الحساسية أو تعزز الانقسامات.
- خطاب الكراهية قد ينشر الفتنة بشكل مباشر أو يكون مقدمة محتملة لها. ليس بالضرورة أن يؤدي كل خطاب كراهية إلى إثارة الجريمة فورًا، ولكنه يهيئ البيئة لذلك. من هنا، يصبح هذا النوع من الخطاب مكونًا رئيسيًا في قضايا التحريض والتأجيج الاجتماعي، خاصة عندما يكون السياق حساسًا كما ويمكن أن يكون تأثير خطاب الكراهية محدودًا لدى البعض، لكنه يتفاقم عند مجموعات أخرى بسبب اختلاف البيئة الاجتماعية أو الثقافية.
خلال مجموعات العمل الأربعة، خلصنا بأربع تعريفات اجرائيّة لخطاب الكراهية على الإنترنت ضمن السياق الأردني
خطاب الكراهية يشمل كافة أشكال وأنماط التعبير، سواء المكتوبة أو المنطوقة أو السلوكية، التي تهدف إلى التحريض أو الإثارة أو الترويج أو التبرير أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع. ويستند هذا الخطاب إلى أسس مثل اللون، العرق، النسب، الدين، اللغة، الجغرافيا، الحالة الصحية، المعتقد، أو النزعات. يؤدي هذا النوع من التعبير إلى تهديد السلم المجتمعي، الإخلال بالنظام العام، وإثارة العنف في المجتمع. قد يبدو أن التعريف الأول هو الأكثر ملاءمة ليُصنف كتعريف مناسب لخطاب الكراهية على الإنترنت في الأردن.
السبب:
- التحديد الشامل: يشمل كافة أشكال وأنماط التعبير (المكتوبة، المنطوقة، والسلوكية) مع الإشارة إلى الأهداف (التحريض، الإثارة، الترويج، التمييز) والعواقب (الإخلال بالنظام العام وإثارة العنف).
- التفصيل: يوضح الأسس التي يقوم عليها خطاب الكراهية (اللون، العرق، النسب، الدين، اللغة، الجغرافيا، الحالة الصحية، المعتقد، أو النزعات).
- الربط بالنتائج: يبرز الأثر المباشر لخطاب الكراهية في تهديد السلم المجتمعي وإثارة الفوضى.
التعريف الثاني: يحتوي على الكثير من الشرح المضاف ويتجاوز كونه تعريفًا ليشمل أركان ودوافع خطاب الكراهية، مما يجعله أقرب إلى تحليل موسع بدلًا من تعريف محدد. خطاب الكراهية هو أي تعبير، سواء كان لفظيًا أو مكتوبًا أو سلوكيًا، يهدف إلى التحريض على الكراهية أو التمييز أو إثارة الفتنة بين الأفراد أو الجماعات. يمكن تعريفه بشكل أفضل من خلال تحديد أركانه الأساسية التي تشمل: النية والقصد وراء التعبير، الفئة المستهدفة التي يتوجه إليها الخطاب، الوسيلة المستخدمة لنشره، المحتوى الذي يحمله، والتأثير المتوقع الناتج عنه. تتعدد صور وأشكال خطاب الكراهية، حيث يمكن أن يظهر في الأقوال، الكتابة، أو السلوكيات. وتنبع دوافع هذا الخطاب من عدة عوامل، مثل التعصب أو التطرف أو الجهل أو البيئة الاجتماعية والتعليمية، وأحيانًا القوانين أو الممارسات التي تتيح انتشار مثل هذا الخطاب. أما خصائص خطاب الكراهية، فهي ترتبط بالقضايا الحساسة التي تمس المجتمع، مثل العرق، الدين، الجنسية، واللغة. وبصورة عامة، يمكن اعتباره أي قول أو فعل أو كتابة تسعى إلى زرع الانقسام وإثارة الفتنة داخل المجتمع.
التعريف الثالث: يركز على التحريض والتأجيج بشكل خاص، لكنه يفتقر إلى الشمولية والتفصيل فيما يتعلق بالعناصر الأساسية التي تميز خطاب الكراهية. خطاب الكراهية هو أي شكل من أشكال النشر أو التعبير، سواء في فضاء عام واقعي أو رقمي يهدف إلى التحريض أو التأجيج ضد “الآخر”. يتجلى ذلك من خلال الإساءة إليهم، التحقير من قيمتهم، أو التقليل من شأنهم. يشمل “التأجيج” في هذا السياق إثارة مشاعر عدائية أو تحريض مجموعة معينة على اتخاذ موقف عدائي أو عدواني تجاه فرد أو جماعة أخرى، مما يعزز الانقسام الاجتماعي ويهدد التماسك المجتمعي.
التعريف الرابع: يقترب من كونه شرحًا تطبيقيًا بدلًا من تعريف شامل، لأنه يفصل في كيفية حدوث خطاب الكراهية وآثاره أكثر من كونه يحدد ماهيته. تعريف خطاب الكراهية على الإنترنت يشمل مجموعة من العناصر الأساسية: أولها النشر، الذي يمكن أن يكون مكتوبًا، مرئيًا، أو حتى نصوص التعليقات. ثانيها المحتوى، الذي يتسم بالإساءة أو التشهير أو التحريض، ويستهدف فئة معينة بناءً على معايير مثل الدين، العرق، الطائفة، الأصل، أو الثقافة. يهدف هذا النوع من الخطاب إلى التمييز ضد هذه الفئة. خطاب الكراهية على الإنترنت قد يؤدي إلى نشر الفتنة بشكل فوري أو في وقت لاحق، مما يهدد الوحدة المجتمعية ويؤثر على العيش المشترك. يمكن أن يحرض على العنف بأشكاله المختلفة، سواء بالفعل أو القول، ويعمل على إيقاظ النعرات العنصرية. أما الأثر السلبي على من يتعرض لخطاب الكراهية على الإنترنت، فيتجلى غالبًا في الشعور بالاستهداف والإقصاء، مما يعزز الإحساس بعدم الانتماء إلى المجتمع.
التعريف النهائي المقترح اعتماده حيث أخذ بعين الإعتبار الأربع تعاريف السابقة الذكر:
خطاب الكراهية هو جميع أشكال التعبير، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة أو مرئية أو سلوكية المبني على النيّة والتمييز، والذي يثير أو ينشر أو يروج أو يحرض أو يبرر الكراهية أو العداء بين الأفراد أو الجماعات في المجتمع على أسس مثل اللون، العرق، النسب، الدين، اللغة، الجغرافيا، الحالة الصحية، المعتقد، أو الجنس، مما يؤدي إلى الإخلال بالسلم المجتمعي وإحداث العنف داخل المجتمع.
د. إياد الجبر و د. سهى عياش