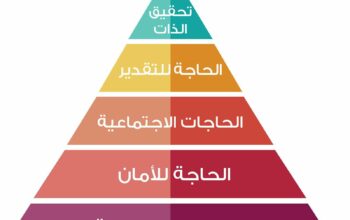الخوف هو الشعور الناجم عن الخطر أو التهديد المتصور ويقوم بإحداث تغيير في الوظائف الأيضية والعضوية ويؤدي إلى تغيير في السلوك مثل الهروب، الإختباء أو التجمد تجاه الأحداث المؤلمة التي يتصورها الفرد. قد يحدث الخوف ردا على تحفيز معين يحدث في الوقت الحاضر أو تحسبا لتوقع تهديد محتمل في المستقبل. تنشأ استجابة الخوف من تصور لوجود خطر ما، مما يؤدي إلى مواجهته أو الهروب منه وتجنبه. كثيرة هي الأمثلة على أحداث أو أزمات وقعت سببت خوف وذعر لدى الناس ولكن تم احتواء ذلك الخوف وإدراة تلك الأزمة، وهذا ما سنتطرق له في هذا المقال. إدارة الأزمات هي الإستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث. على مر الزمان، انتهجت القيادات إما أسلوب الهرم القيادي أو التصدي المرتجل في التعامل مع الأزمات، الأسلوب الأول اعتمد على فرق خاصة وكفوءة في التعامل مع الأزمات واتباع منهجية علمية واضحة غير ارتجالية وبالتالي كانت أصلب عودا وأكثرطواعية وإستمرارية من الإسلوب الثاني الذي اعتمد على الإرتجال والطرق الغير مدروسة.
في البداية، يجب على الحكومات أن تستثمر في مجال الوقاية والتأهب وهذا أكثر فاعلية وأقل تكلفة من جهود الإنعاش، وهذا الأمر يتجلى في تحديث قوانين البناء والمباني الغير آمنة مثلا، أو تنسيق السياسات الاقليمية النقدية. للأزمات أشكال عدة ولها طرائق متعددة للتعامل معها، هنالك الأزمات الطبيعية والتي تنجم عن كوارث طبيعية، والأزمات الاقتصادية، وأزمات الغذاء وغيرها العديد. لنتمكن من السيطرة على هذه الأزمات التي قد تدب الذعر لدى المواطنين، الأمر الذي لا يساعد بتاتا على السيطرة على الأزمة، قامت العديد من الدول بإنشاء مراكز إدارة الأزمات والذي يُعنى بإدارة توازنات القوى والتكييف مع المتغيرات وتجنب وقوع الأخطاء أو تخفيض درجة الخطر وتقليل الخسائر.
الأزمات من حيث حدوثها لها خمس مراحل تتسم بها منعطفات أو نقاط تغير الهيئة العامة للأزمة، وهي:
- مرحلة الميلاد: هي المرحلة التي تنشأ بها الأزمة وتبدأ بالظهور للرائي وتتم ملاحظتها فور تلك المرحلة،
- مرحلة النمو: هي المرحلة التي تتصعد فيها الأزمة وتصبح أكثر تعقيدا مما هي عليه في المرحلة السابقة،
- مرحلة النضج: هي المرحلة التي تصل فيها الأزمات الى أوجها والتي تكون هي أعلى نقطة تصل اليها الأزمة ومن بعدها تبدأ الأزمة بالتراجع تدريجيا وبالتالي فالمرحلة التالية هي؛
- مرحلة الإنحسار: هنا نرى أن الأمور بدأت في العودة لطبيعتها وأن الأمر باتت تحت السيطرة؛
- انتهاءً بمرحلة الإختفاء: والتي من الواضح أنها تعني اختفاء الأزمة والتغلب عليها وتجاوزها أو التكيف معها. تختلف الأزمات من حيث عمق تأثيرها فإما أن تكون سطحية وهامشية أو عميقة وجوهرية الأمر الذي يدل على اختلاف الإستراجيات المعتمدة للتعامل مع الأزمات وطريقة تخفيف الآثار السلبية والنفسية التي تخلفها الأزمة، الأمر الذي نتطرق له في مقالنا عند ذكر الخوف فهو مرتبط بطريقة التعامل ذاتيا أو نفسيا مع التهديدات المحيطة والتي هنا هي الأزمات، ليس الخسائر الناجمة عن الأزمات هي فقط مادية بل معنوية أيضا.
من الجدير بالذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن لاقت تغطية إعلامية ومتابعة صحفية بعد أن قامت بالتعامل بكفاءة وسرعة عالية في عدة حالات كانت تصنف أزمات، منها حادثة هجوم كرايستشيرتش والذي قتل فيه خمسون شخصا على الأقل بدم بارد وتم بث ذلك مباشرة. قامت جاسيندا فورا بتقديم التعازي للعائلات وذكر أن الهجوم تم من قبل متطرف ولا وجود لأمثالهم في نيوزيلندا وعزمت على مراجعة قانون حيازة الأسلحة الذي لعب دورا مهما في الهجوم وأعلنت حدادً وطنيا وقامت بالسفر الى كرايستشيرتش لمؤازرة العائلات والنظر لموقع الهجوم. في مقابلة لها على التلفاز حدثت هزة أرضية أثناء تلك المقابلة وكان من الواضح أنها على قدر عالٍ من التحكم بالأعصاب وضبط النفس وكذلك كان واضحًا كيف تأكدت من سلامة الجميع في المنطقة.
بما أننا تطرقنا لضبط النفس، من الجدير بالذكر نظرية السيطرة على الخوف التي تقترح أن صراعا نفسيا أساسيا ينتج عن امتلاك غريزة لحفظ الذات لأثناء ادراك الموت، وينتج عن هذا الصراع خوف و يُسيطر عليه بمعتقدات ثقافية/دينية أو أنظمة رمزية تعمل على التصدي للواقع الحيوي بأشكال راسخة وأكثر ثباتًا للمعنى والقيمة. تضاعف عدد الكوارث المسجلة على مدى العقدين الماضيين، من زهاء 200 كارثة الى ما يربو على 400 كارثة في السنة. وكانت 9 من بين كل 10 من هذه الكوارث تتعلق بالمناخ، وأصبح الخوف من التغيير في المناخ شيء فعلي وفي بعض الحالات يوصف بالرهاب فلما أصبحت الأمور تحتاج لإطار عمل متفق عليه دوليا. في عام 2005، بعد كارثة التسونامي الآسيوية تعهدت 168 حكومة بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية الثلاثة لإطار عمل سُمّي (هيوجو)، الا وهم: إدراج الحد من خطر الكوارث في السياسات والخطط الإنمائية المستدامة، إنشاء وتقوية المؤسسات والآليات، القيام بإدراج نهج الحد من المخاطر في تنفيذ التأهب لحالات الطوارئ.
من الأمثلة على الأزمات التي كانت في وضع وتوقيت حرج هو ما حدث في ميناء بيروت في الرابع من آب للعام الحالي 2020، حيث انفجر مستودع في المرفأ كان يحوي كمية هائلة من نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون اتباع اجرائات سلامة. هنا يظهر أسلوب التصدي المرتجل الذي تطرقنا له في بداية المقال حيث أنه لم تكن هناك خطط مسبقة احترازية تحول دون انفجار المادة المخزنة و ايضا لم تظهر عمليات تدراك الموقف بل تم ارسال عناصر اطفاء في بداية الحريق الأمر الذي ادى لوفاتهم في الإنفجار حيث ذهبو للقاء حتفهم عوضا عن اخماد الحريق وتأدية عملهم باعتياد. لكن، تم مشاهدة مبادرات محلية ودولية لمساعدة المواطنين والدولة على النهوض بدءا من الدعم الطبي الذي كانوا بحاجة ماسة له، وصولا لقيام الشعب بتنظيف الشوارع من الشظايا والزجاج وعرض استضافة الذين تقطعت بهم السبل.
الخوف هو شعور أساسي وغريزي في الإنسان، ومن الطبيعي أن يعبر عنه، ولكن في حالات الأزمات والكوارث لابد من ضبط النفس والحفاظ على رباطة الجأش لتجنب القرارات الخاطئة وتفادي الخسائر. لذلك تعمل الحكومات على طمئنة شعبها والحفاظ على هدوئهم وتوفير المعلومات اللازمة والتعليمات اللازم اتباعها في كل حالة معينة حيث تختلف اجرائات الوقاية والسلامة مثلا في أزمة عن أخرى. تعددت الأزمات وأرتنا أن الحالات الإنسانية تتجاوز كل اعتبارات السياسات وأن الشعوب تقف متكاتفة دوما للتصدي للأوجاع التي نعبر عنها بالخوف أو الذعر والتي أيضا تقوم الحكومات بلعب دور مهم جدا أيضا في الحفاظ على هذا التماسك المجتمعي. ختاما، أتمنى السلام والأمان للجميع وأن تعم الطمأنينة على الشعوب أجمع، الرخاء والصحة النفسية والحياة الخالية من القلق حق للجميع.
يوسف النسور