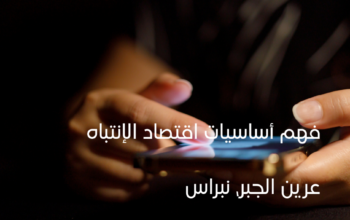(خبز، حرية، عدالة إجتماعية)؛ هذه كانت شعارات، نداءات، آمال ومطالب العالم. هذا جُل ما يسعى إليه البشر منذ الأزل؛ أن يكونوا شعبا أحرارا ومنصفين في أوطانهم. هذه الشعارات لا تُفنى ولا تُستحدث من العدم ولكن يمكن تحولها من صورة لأخرى. هذا ما يقوله قانون حفظ الطاقة الفيزيائية وينطبق على الإحتياجات الإجتماعية والحياتية الموجودة في كل فرد من أفراد هذا المجتمع الإنساني، يمكن أن تتغير أسماءها أو مفاهيمها لكنها تسعى نحو الهدف نفسه منذ بدء الخليقة إلى الآن.
“إنّ العدل أقل تكلفة من الحرب، ومحاربة الفقر أجدى من محاربة الإرهاب”.
اعتبرت العدالة الإجتماعية أساس هذه الإحتياجات؛ حيث أن ماركس عد العدالة الإجتماعية على أنها الفضيلة الأولى التي ينبغي أن تتجه إليها الحياة الأخلاقية. من خلال إقامة العدالة الإجتماعية، تتحقق ذات الإنسان على أساس الإنسانية. وتأتي العدالة الإجتماعية تطبيقاً لمفهوم المساواة الذي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ معتبراً أنّ الأفراد يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق. أي ينبغي أن يتقرر لكل إنسان قدر معين من الحقوق الأساسية بغض النظر عن إسهامه في العملية الإجتماعية.
تعرف العدالة الإجتماعية أو المدنية على أنها أحد النظم الإجتماعيّة والإقتصادية التي تهدف إلى إزالة الفوارق الإقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع. كما يتم من خلالها تحقيق المساواة من حيث فرص العمل، وتوزيع الثروات، والإمتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة والمساواة بين الأشخاص من ذوي الإعاقة والأصحاء من خلال دمجهم وتوفير المكاسب والفرص العادلة لهم وغير ذلك من الصور. بالتالي، يتمتّع جميع أفراد المجتمع بغضّ النظر عن (الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الإقتصاديّ) يعيش حياة كريمة بعيداً عن التحيّز أو التمييز.
للعدالة الإجتماعية أربعة أركان: (العدالة الإقتصادية، العدالة التشاركية، العدالة التوزيعية، العدالة الإنتقالية) ومن أهم مقوماتها: المحبّة، تحقيق الكرامة الإنسانيّة، ونشر المساواة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع، ومبدأ التوازن الإجتماعي في مستوى المعيشة وليس في مستوى الدخل، ثم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم العدالة. تعتبر العدالة الإجتماعية مبدءا أساسيا من مبادئ العيش السلمي وبغيابها ينمو التطرف والعنف. لا يمكن تحقيق العدالة الإجتماعية إلا عن طريق التنمية، وهو الطريق إلى إعمال القانون. العدالة تدل على علاقة الدولة بمواطنيها ولا تتحقق العدالة في هذا الإطار إلا إذا كان جميع المواطنين يتمتعون بنمط عيش مشترك يلبي حاجاتهم الأساسية، ويوفر لهم إمكانية الإستقلال الذاتي والحرية والمساواة في جميع مجالات الحياة. العدالة بمفهومها العام تعني الحياديّة في إطلاق الأحكام على الآخرين مهما كانت مراتبهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل شخص وبيئته المحيطة التي دفعته إلى القيام بفعل ما. قد يكون لمصطلح العدالة معانٍ أوسع، فهو يشير أيضاً إلى توزيع الموارد بالشكل الصحيح بين الناس؛ لأن العدالة الإجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعدالة الإقتصادية.
لأهمية العدالة الإجتماعية في المجتمعات الإنسانية، يحتفل العالم في الـ(20 من شهر شباط/فبراير) من كل عام بـ “اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية”، الذي تم إقراره من قبل الأمم المتحدة بشكل رسمي خلال(العام 2007).
“العدالة، يا سيدي، هي المصلحة الكبرى للإنسان على الأرض. هي الرباط الذي يحمل الكائنات المتحضرة والدول المتحضرة معا، وأينما يقف معبدها، وطالما تم تكريمها على النحو الواجب، سيكون هناك أساس للأمن العام، والسعادة العامة، وتحسين وتقدم عرقنا”. دانيال وبستر
تبنى العدالة على أساسان، هما تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي، المقصود بتكافؤ الفرص؛ أنه لا يوجد تمييز بين المواطنين مهما كانت خلفيتهم الإجتماعية عندما يتعلق الأمر في المشاركة في العملية الإقتصادية ولهم نفس الدرجة والمكانة عند الإنتفاع بالخدمات التي توفرها الدولة، كالصحة والتعليم والقضاء. هذا يكون له إنعكاس إيجابي على جميع الأطراف المتداخلة في المجتمع. أما التمييز الإيجابي فيكون باعتماد آليات إنعاش ملائمة في التعامل مع الفئات المهشمة بهدف السعي لإصلاح التمييز الذي مورس ضدهم في السابق. تنص الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (في المادة 2) على أن سياسات التمييز الإيجابي قد يكون متطلبا على الدول التي وقعت على الإتفاقية، من أجل تصحيح التمييز المنهجي.
تنص على أن مثل هذه البرامج لا يجب أن تضمّن بأي حال كنتيجة لرعاية الحقوق غير المتساوية أو المنفصلة لمجموعات عرقية مختلفة بعد تحقيق الأهداف المرتبطة بها. تنص لجنة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أن مبدأ المساواة يتطلب أحياناً أن تلتزم أحزاب الدول بالتمييز الإيجابي لكي تقلل أو تقضي على الحالات التي تتسبب أو تساعد في دوام التمييز الممنوع بالميثاق. مثلاً، في دولة ما عندما تكون الأوضاع العامة لجزء محدد من السكان يمنع أو يضعف من استمتاعه بحقوق الإنسان، يفضل للدولة أن تتخذ إجراءً محدداً لتصحيح تلك الأوضاع. ذلك الإجراء قد يتضمن منح ذلك الجزء المعني من السكان معاملة تفضيلية مؤكدة في مسائل محددة مقارنةً ببقية السكان. لكن، مادام ذلك الإجراء مطلوباً بإصلاح التمييز، فهو في الحقيقة تفاضل شرعي حسب الميثاق.
يعتبر موضوع حقوق المرأة من الموضوعات الأكثر اهتماما لدى الباحثين والدارسين المهتمين بالعدالة الإجتماعية والتمييز الإيجابي على المستويين السياسي والقانوني، كون المرأة عانت ولا زالت تعاني في بعض الدول من الإنتهاكات الخطيرة لحقوقها وحرياتها الأساسية. لذلك سعت المجموعة الدولية إلى محاولة إيجاد آليات وسبل للنهوض بحقوق المرأة ولعل أهمها هو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)؛ التي تعتبر الشرعية الدولية لحقوق المرأة، والتي من خلالها حاولت الدول الأطراف أن تحدد الأطر القانونية للاعتراف بحقوق المرأة وتمكينها من التمتع بها وحمايتها. تشكل إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أهمية خاصة، كون الهدف منها هو العمل على تحقيق مبدأ المساواة، وإزالة أي تمييز يتم على أساس الجنس من شأنه أن يؤدي إلى عدم الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والإقتصادية واإجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر. يعتبر مبدأ عدم التمييز ضد المرأة حجر الأساس لاتفاقية سيداو التي تبنتها الأمم المتحدة، حيث انتبه المجتمع الدولي للانتهاكات التي تطال حقوق المرأة حول العالم، لذا حرص على وجوب تمتع المرأة بحقوقها كاملة دون انتقاص وجعلت أساس هذه الحقوق هو حث الدول المصادقة عليها على إلغاء كل معاملة تمييزية ضارة بالمرأة في قوانينها الداخلية تحت إشراف لجنة أنشأتها الاتفاقية بغية كفالة العدالة الفعلية بين الرجل والمرأة وتحقيق المساواة في الفرص بينهما ويتم اللجوء إلى إتباع تدابير خاصة (التمييز الإيجابي).
صادقت الحكومة الأردنية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز التنفيذ (عام 2008)، وتعهدت بموجبه بحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين من دون التمييز على أساس الجنس. كما نصّت المادة السادسة من الدستور الأردني على أنّ الأردنيين أمام القانون سواء. يجب التعامل مع المرأة كشريك فعال على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وليس ضمن ما تقره نسب وأرقام محددة سلفا. يعتبر مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة استثناءا على مبدأ المساواة أمام القانون بينها وبين الرجل. ويهدف إلى ترقية حقوقها في الواقع من خلال تكريس العدالة الفعلية بينهما. قد كرس المشرع هذا الإجراء وأعمله في مجالين أساسيين هما ترقية مشاركتها في المجالس المنتخبة وحمايتها في سوق العمل. ولضمان مشروعية مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة وعدم خروجه عن هدفه، فقد أحيط بشروط صارمة تتعلق بمضمونه وهدفه و بمدته، كما أخضعه القضاء الدستوري لرقابة مشددة تستهدف التثبت من عدم وجود تمييز تعسفي، وفي مرحلة ثانية التحقق من مدى توافر الشروط المبررة لإعماله.
“نحن نسعى إلى بناء العالم الذي نصبو إليه، على تكثيف جهودنا لشق طريق للتنمية يكون أكثر شمولاً وإنصافاً واستدامة، ويقوم على دعائم من الحوار والشفافية والعدالة الإجتماعية”. بان كي مون
زين الصبح