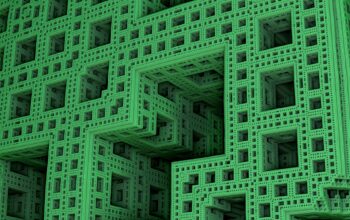مع اتساع الرقعة البشرية وانتشار الإختلاف في حياة الأفراد واقترانهم في مجتمعات متشابهة، مختلفة أو بالأحرى هجينة، يرافق ذلك أهمية وجود المجتمعات التي تحتضن وتسمح بمشاركة وتعبير كل أفرادها باختلافاتهم. وهنا أتى تعريف ومصطلح المجتمعات المتماسكة؛ فالمجتمع المتماسك هو المجتمع الذي يسعى إلى ازدهار أفراده كافة، ويحارب الإقصاء والتهميش ويخلق شعوراً بالانتماء ويعزز الثقة، ويوفر لأعضائه فرصة النمو والتقدم إلى الأمام في كل المجالات. فهو باختصار العلاقات الإيجابية في المجتمع. في مجتمعاتنا العربية والشامية بالتحديد، تتعدد الهُويات الفردية في المجتمع وبالأفراد أنفسهم، معطيةً الحاجة -في عصرنا هذا- إلى الحديث عنها والإشارة لقوتها وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات مع بعضهم البعض. ومن أهم وأولى هذه الهويات هي الهوية الجندرية.
- النوع الإجتماعي أو الجندر أو الجنوسة (Gender): هو مجموع الصفات المتعلقة والمميزة ما بين الذكورة والأنوثة. اعتمادًا على السياق يمكن أن تشمل هذه الصفات الجنس الحيوي المعيّن (أي كون الإنسان تشريحيا ذكر أو أنثى أو ثنائي الجنس)، وتشمل البنى الإجتماعية المعتمدة على الجنس (بما فيها من أدوار جندرية وأدوار اجتماعية أخرى)، أو الهوية الجندرية.
- الهوية الجندرية (gender identity): تشير إلى الرؤية الخاصة بالشخص إلى جنسه. أي أنه إدراك وشعور الشخص الخاص بكونه ذكرا أو أنثى، ويتضمن إعترافه بالإنتماء إلى أحد التصنيفين الرئيسيين من الناس: الذكور والإناث.
في غالب الحالات يُرى أن المرأة هي النوع الإجتماعي الذي يحتاج إلى تعديل دوره الإجتماعي. فإن الحديث عن توضيح واستيعاب مفهوم الجندر وتضمينه إجتماعياً هو موجود، ولكن هو ربما محصور على تضمين وتفعيل دور الجندر الأنثوي فقط. للوعي والحاجة التامة لترسيخ مفهوم المساواة في الدور الإجتماعي لكلا الجندرين. لكن، هذه المبادرات والجهود المبذولة حُصرت واقتُصرت على تفعيل دور المرأة فقط؛ باعتبار أن الرجل/الذكر دوره مرسوم، ويكمن تفعيله بمجرد الوجود. لكن هذا ليس بصحيح، فالحرية التي ترسم وترتسم على الوجود الذكري إنما هي بالحقيقة مرتبطة بواحدة من أكبر وأشهر وأشد الصور النمطية القديمة والمعاصرة. فمفتاح الحرية هذه هو في الحقيقة سجن لا تجد أحداً يتطرق إليه!
الرجولة
الوجود الذكري جنسياً، ارتبط بدور وصورة اجتماعية متعارف عليها عالمياً ومحلياً. وهي الرجولة! الرجولة هي ما يُرى من الذكر من تصورٍ جسماني وفعلي مرتبطاً على القوة والهيمنة والتسلط وهي أيضاً مرتكرةً على معاداة الأنوثة؛ مقتطباً بذلك الدور الإجتماعي لكلاهما. أما الرجولة فسيولوجياً فهي اكتمال نمو ذكر الإنسان واكتسابه المعالم الجنسية الثانوية مثل ظهور اللحية والشارب ونمو شعر الجسم على الصدر والأذرع والأرجل وحول الأعضاء التناسلية وتغير الصوت نحو الخشونة. والمصطلح بحد ذاته مرتبط بمعاني الفحولة (virility)، والذكورة (masculinity) بحكم اكتمال الدور التناسلي له أيضاً. فالقوة والهيمنة و السلطوية وعدم إظهار الخوف أو الضعف والجمود والبرود العاطفي وما يرافق ذلك من تحامل وثقة بالنفس كان ولا يزال لهم الأثر في صنع الحضارات كافة. القوة البدنية كانت ولا تزال وستبقى العنصر الأهم في صراع البقاء الإنساني والمجتمعي.
يجدر بالذكر أيضاً أن الرجولة اقترنت بصفات وخصائص جعلت منها مقتصرة ومرادفة للرجولة، مثل: الكرم والشجاعة والقوة والصبر والثقة بالنفس والكفاءة والقيادية والحكمة وأخراً كثيرات، واخرى غير حميدة، مثل: اللبادة، القسوة، الوقاحة و العنادة وسرعة تقلب المزاج. في حديثي مع محمد وهو طبيب مقيم في الأردن، عن دور الرجل (الزلمة) في المجتمع الأردني، أشار أن جزءاً كبيراً من الإنفلات الأخلاقي والمجتمعي وقضايا الشرف العديدة التي أصبحنا نتصبّح بها، كلّها بسبب ضياع دور الرجل في المجتمع. فهو يعتقد أن دور الرجل يكمن في السلطة؛ أكان ذلك في منزله أو محيطه وبالتالي فهو بذلك يؤدي إلى تماسك المجتمع، مؤشراً أن الرجل هو القادر. وعند سؤاله ب “لماذا؟” أجاب: “هيّ هيك، الزُّلُم هيك! هيك العادات والتقاليد. فهكذا ولدنا!” فمثل هذه التعابير منحوتة بعمق في عقول وأفكار بعض الأفراد ميسرة آراؤهم واتجاهاتهم في مجتمعاتنا. ولكن عند السؤال مرة أخرى عن ما يقصده، أعاد نفس الجواب مستغرباً أنّي لم أفهم أو لم استوعب ما قاله! فهذه الصيغة المبطنة والضبابية التي نتحدث بها بصيغة يومية ومتكررة أنشأت هذا الفهم؛ ذلك الذي يأتي تعريفه بالتوكيد لا بالمنطق. بالرغم من أهميتها التاريخية والفعلية في العصور كافة -ولا لإنقاص مفاهيمها وأبعادها- يأتي السؤال، هل هذا التعميم المُقصي هو الصورة الصحيحة والواحدة للرجل؟
التمييز الخفي
هنالك بالتأكيد تحامل وتمييز ضد الرجال الذين يعبرون عن مشاعرهم ويعترفون بضعفهم ويرفضون السلطوية ’الممنوحة’ لهم. فمغايرة الصورة النمطية للرجل والرجولة تعرض فاعلها للإقصاء والتهميش والتنمر، صانعةً بذلك مساراً إجبارياً للوجود. بحسب المنظمة الأمريكية لعلم النفس، فإن الأيديولوجيا الذكورية التقليدية نجمت عنها محدودية تطور نفسية الذكور، وكبح سلوكهم، و أدت إلى التأثير سلبياً في صحتهم الذهنية والنفسية. لكن، ماذا لو تمردنا على ذلك، وكنّا كما نحن؛ مزيج من عقل وجسد وروح. ففي حديثي مع بعض من الشباب الذين تخلوا عن ما فرض المجتمع عليهم.
أولهم خالد، مهندس وفنان اردني مغاير للصورة الشكلية المتوقعة منه -مع أنه شاب ملتحٍ بملامح عربية وقاسية، فهو أيضا يرتدي ما يريد من ملابس مواكبة للموضة، واضعاً حلقاً ويطلي أظافره من وقت لآخر. فعند سؤاله ماذا تعني لك الرجولة قال: “الرجولة مصطلح مهين، فبتعريفه المتعارف عليه يعطي الوصف السلطة للظلم والتمييز بالأخص للنساء. فلماذا أعزز ذلك؟ ففيه تحكم وغضب وجمود وغريزية! فلن أعزز ذلك في الواقع الحالي. وأضاف عبد الله -شاب يدرس الفنون التشكيلية- “أن مصطلح الرجولة هو بيولوجي بحت، يعطي الذكر ميزاته الفيزيائية. حتى استعمالنا له في غالب الأمر يكون لإشباع وإيصال صورة الفرد ليكون جزء من المجتمع. ولكنّا لو نظرنا إلى ذلك الرجل/الزلمة في غرفه النوم، كونها أكثر مكان يكون فيها الشخص على سجيته، هل يكون هو ذلك الرجل هو نفسه خارجها؟ ” فهنالك اعتراف ضمني، بأن مفهوم الرجولة الصارمة هو للوجود المجتمعي ولكن لا يعبر عن الوجود الطبيعي.
كيف تتخلص من الصورة النمطية؟
خالد: “أعرف ماذا تريد وابدأ بالتجربة؛ وبنفس الوقت عبّر عن حالك لعائلتك والمقربين منك لتكونوا على صفحة واحدة. ما عندي مشكله من الضعف، هاي الجملة لحالها تملك الكثير من الشجاعة الّي الكل بتغنى فيها بهالمجتمع الصلب”. وأضاف بأن قرار الوجود بعد الولادة هو قرار شخصي وليس بعام! “صحيح إنك لازم تحاول وتبني بيئة مناسبة تعيش فيها إنت و غيرك، بس برضو مش مجبور على انك ترد على المجتمع في امور خاصه بكيانك”.
لكن، هذه الحقيقة تعتبر غريبة وغربية، فمجرد الحديث عن تلك الأمور تخلق حاجزاً يستقطب التقليدي بجهة صالحة والجديد بجهة مُسقطة ضمن إطار التقليد الأعمى. فبنظر عبدالله: “لمّا حدا يحكيلك هذا فكر غربي مش فكرنا ولا بلائم عاداتنا ولا تقاليدنا بحكيله انه معاك حق وبنفس الإشي لأ، هاي العادات والتقاليد ما نزلت مرة وحدة هيك، لا عنّا ولا عند الغرب، كلنا بناخد وبنعطي وبنبني عليها. كثير محتاجين نفهم ونحترم الاختلاف، مش لنكبر… لنعيش!”.
“فصل الدور الإجتماعي بناء على الجندر واستخدام ال labels يعدان أساس المشكلة، فيجب النظر إلى الدور الإجتماعي بصفته العامة والحيادية”. يضيف عبدالله، يجدر بالذكر إن الجندر والعدالة الجندرية وتضمينهما لا تعني الدعوة إلى أن يكون الجنسان متماثلين أو صورة طبق الأصل، وإنما تعني الدعوة الى إزالة المفاضلة بينهما لأنهما مختلفين بيولوجياً، والأخير سبب لا يبرّر التمييز بينهما في أي مجال ولا في أي حال؛ فلا يولد جنس الذكور متميزاً ومتفوقاً على جنس الإناث، نحن من نجعله كذلك ونصنعه صناعة عندما نميز بينهما من المهد الى اللحد.
ماذا الآن
من الضروري أن نتعامل مع هذا المفهوم من منظور الأبعاد الاجتماعية والثقافية للمجتمع العربي، المجتمع قائم على الجنسين لا على جنس واحد فقط من حيث المكتسبات والحقوق والإمتيازات كما يحدث في المجتمع الذكوري. وتبرز أهمية العمل على تضمين مفهوم الجندر في حياتنا اليومية ومأسسته في مؤسساتنا هو لخلق مجتمع متوازن قائم على الإختلاف، ثم توظيف هذا الإختلاف بين الجنسين لتحقيق (التكامل والتكميل) بينهما وليس للمفاضلة أبداً.
فلا المرأة أفضل من الرجل ولا الرجل أفضل من المرأة؛ فقد يكون هناك فروق بين النساء أنفسهنّ تفوق الفروق بينهنّ وبين الرجال، وكذلك الأمر بالنسبة للفروق بين الرجال أنفسهم. المفاضلة الإنسانية من المفروض أن تكون من باب الفروق الفردية المرتبطة بالمؤهلات والإنجازات وسمات الشخصية لا على أساس الجنس، لذلك من الطبيعي لا بل من البديهي أن يكون هناك مساواة في القوانين وعدالة في الأعراف والحياة اليومية.
فجدر الحديث أن الرجال لا يقعون بصورة واحدة، وأن الرجل لا يساوي الكمال الإنساني. مجرد الإشارة بالمساواة بين الرجل والمرأة بتحديد وتفعيل دور المرأة فقط هو منظور صعب وشائك، فهو يعطي الرجل حرية غير محدودة إلا بصورة يجب أن يكون بها، أمام الناس. لا يمكن أن ينضج المجتمع وينضح بالعدالة إلاّ عندما يتحرر من القيود التي تكبّله، أهمها التحرر من ازدواجية الخطاب، والتعامل مع الإنسان بإنسانيته لا بجنسه، أما التحرر من الأساطير والصورة النمطية والذهنية التقليدية هي ما تقود المجتمع الى الارتقاء فعلاً، عندئذ فقط ننعم بمجتمع متوازن وصحي، ونضمن أجيالاً صحيحة نفسياً ومستقرة ذهنياً ومشبعة وجدانياً وعادلة اجتماعياً في أي موقع يشغلونه لاحقاً” – د. عصمت حوسو
أسامة مبيضين