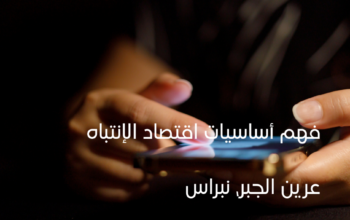في عامِ 1933 في مدينَةِ عكَّا، وُلدَ الفنَّان التَّشكيليّ الفلسطينيّ إبراهيم هزيمة وعلى إِثرِ حربِ النَّكبةِ عامَ 1948 لجأَ معَ عائِلتهِ إلى سوريا -اللَّاذقية. منذُ نُعومةِ أظافِره، وفي سنِّ الخامِسةِ تَحديدًا، ظَهرت مَوهِبتُه الفنيَّة عِندما كانَ يجلسُ في مقهى والدِه، كانَ يُراقبُ فنَّانةً أوروبيَّة أثناءَ عَملِها وهُناكَ تَطوّرت موهِبَتُه. تَتلمذَ على يدِ الأُستاذِ عبد الرَّحمن قبَّاني، وبعدَ ذلكَ انضمَّ إِلى نادي الموسيقى الفنِّي في اللَّاذقيَّة، شاركَ في النَّشاطاتِ الفنيَّة للنَّادي. في عامِ 1952 فازَ بِجائزةِ النَّادي الموسيقيّ الفنِّي وتَسلَّمها من قِبلِ مُصطفى فُروخ. في عامِ 1960 حَصل َعلى مِنحةٍ من جامعة لايبتزغ الألمانيَّةِ وتَخرَّجَ مِنها عامَ 1967، وحصلَ على الجِنسيَّة الألمانيَّة وقامَ بإقامةِ معارضٍ فنيَّة مُتعدِّدة في ألمانيا تُبرِزُ من خِلالِها سرديَّتهُ الفلسطينيَّة في الفنّ.

استُخدمَت العَديدُ من أعمالهِ كطوابع ومُلصقات فِلسطينيَّة وصورةٍ خارجيَّة لمجلة شؤون فلسطينية، ومن لوحاتِه لوحةُ الانتِفاضة، لوحةُ الانتِظار، ولوحةُ القُدسِ بعدَ المَطر وفِلسطينُ بَلدُ أحلامي. عام 1979 انتُخبَ عُضوًا في الأمانةِ العامَّة لاتِّحادِ الفنَّانين التَّشكيليينَ وأصبحَ مسؤولًا للعلاقاتِ الخارجيَّة فيه، وبينَ الأعوامِ 1968-1947 عملَ في إذاعةِ برلين الشرقية كمسؤولٍ للصَّداقةِ الألمانيَّة العربيَّة ومذيعٍ لبرنامِج الفنّ والأدبِ وعملَ مع الصليب الأحمر في برلين بينَ الأعوامِ 1974-1991 يَرسُمُ وجوهَ المَرضى لِيُشخِّصها الأطبَّاءُ بدقَّةٍ ويعَلِّمُ المرضى الرَّسم، انتُخبَ في اللَّجنةِ الوطنيَّة الفلسطينيَّة التَّشكيليَّة في اليونسكو عامَ 1998.
– حازَ على جائِزةِ الخريفِ من مُتحفِ دمشق للآثار عامَ 1958.
– حازَ على جائِزةِ المعرَضِ الكويتيّ العاشِر للفنِّ التَّشكيليّ الشرِّاع الذَّهبي 1987.
– حصلَ على المركزِ الثَّالث في المُسابقةِ الدَّوليَّة للطَّوابعِ البريديَّة في فيينا 2003.
– حازَ على جائِزةِ صالون القاهِرة.
 يعيشُ هاجِسُ فلسطين التي تَسكُنُ بِداخِله، وشَكَّلَ التُّراث الفِلسطينيّ الرَّاسخ في ذاكِرتِه نُقطةَ تَجاذبٍ بينَ ريشَتِه وألوانِه، فقامَ بِتشكيلِ وبِرَسمِ الصُّور لِتُعبِّر عن بُنيانِه الوجوديِّ كإِنسانٍ مُشتاقٍ ومُتعطِّشٍ لِوطنِه المَفقودِ وطُفولَتِه المَسلوبة وشَبابِه المَنثور في البِلادِ المُختلفة. لقد مثَّلت البيوتُ الرِّيفيَّة عُمقاً كبيرًا في أعمالِ هزيمة، فكانَت بِمثابةِ بَصيصِ أملٍ لانفِعالاتِهِ الحسِّيَّة والعاطفيَّة والانفِعاليَّة التي تَصنَعُ من الشَّجرِ والنِّسوةِ حاملاتِ الأطباقِ بِمثابَةِ ولائمَ بصريَّةٍ لمِكوِّناتِ الحالةِ والموقفِ التَّشكيلي. بالنِّسبةِ للمرأةِ فَقد تَجسَّدت بِعُمقٍ في أعمالهِ الفنيَّة، فهيَ تُشكِّلُ الأمَّ والعطاءَ والصَّبرَ والمحبَّةَ والارتِباط بِالجذور، فهذهِ الصِّفاتُ تُجسِّدُ الملامحَ الجماليَّةَ والمعنويَّةَ التي تتحلَّى بِها المرأةُ الفِلسطينيَّة. قالَ الفنَّانُ إبراهبم هزيمة: مواضيعُ أعمالي الفنيَّة تُصوِّرُ ترجمةً لونيّةً لِمشاعري وأحاسيسي الدَّفينة الحيَّة لِلحياةِ في فلسطين الحبيبة، بِإيقاعاتٍ واضِحةٍ مُتكرِّرة، عناصِرُها الإنسان، والأرض، والبيت، والشَّجرة، والضَّوء.
يعيشُ هاجِسُ فلسطين التي تَسكُنُ بِداخِله، وشَكَّلَ التُّراث الفِلسطينيّ الرَّاسخ في ذاكِرتِه نُقطةَ تَجاذبٍ بينَ ريشَتِه وألوانِه، فقامَ بِتشكيلِ وبِرَسمِ الصُّور لِتُعبِّر عن بُنيانِه الوجوديِّ كإِنسانٍ مُشتاقٍ ومُتعطِّشٍ لِوطنِه المَفقودِ وطُفولَتِه المَسلوبة وشَبابِه المَنثور في البِلادِ المُختلفة. لقد مثَّلت البيوتُ الرِّيفيَّة عُمقاً كبيرًا في أعمالِ هزيمة، فكانَت بِمثابةِ بَصيصِ أملٍ لانفِعالاتِهِ الحسِّيَّة والعاطفيَّة والانفِعاليَّة التي تَصنَعُ من الشَّجرِ والنِّسوةِ حاملاتِ الأطباقِ بِمثابَةِ ولائمَ بصريَّةٍ لمِكوِّناتِ الحالةِ والموقفِ التَّشكيلي. بالنِّسبةِ للمرأةِ فَقد تَجسَّدت بِعُمقٍ في أعمالهِ الفنيَّة، فهيَ تُشكِّلُ الأمَّ والعطاءَ والصَّبرَ والمحبَّةَ والارتِباط بِالجذور، فهذهِ الصِّفاتُ تُجسِّدُ الملامحَ الجماليَّةَ والمعنويَّةَ التي تتحلَّى بِها المرأةُ الفِلسطينيَّة. قالَ الفنَّانُ إبراهبم هزيمة: مواضيعُ أعمالي الفنيَّة تُصوِّرُ ترجمةً لونيّةً لِمشاعري وأحاسيسي الدَّفينة الحيَّة لِلحياةِ في فلسطين الحبيبة، بِإيقاعاتٍ واضِحةٍ مُتكرِّرة، عناصِرُها الإنسان، والأرض، والبيت، والشَّجرة، والضَّوء.

الفنَّانُ الأردنيُّ ذو الأصلِ الفلسطينيّ عِماد أبو اشتيَّة، يَنحدِرُ أصلاً من قريةِ القباب في قضاءِ الرَّملة، إلا أنّه مولودٌ في عمّان عامَ 1965 لأبوَين فلسطينيَّين، وتعلّم الرَّسم بالمُمارسة. الذي بَدأَ رِحلتَهُ الفنيَّة مع اللَّوحاتِ والرَّسم، وهو في العقدِ الأوَّلِ من عُمرِه، ويُعتَبرُ الرَّسمُ مُتنفَّسهُ الوحيدُ لِما يَختلِجُ في نَفسهِ من تأثيراتِ شخصيَّتِه ومُحيطِه به، وعن لوحةِ حربِ غزَّة يَقول: “كُنتُ في كلِّ مرَّة أرى مَشهدَ الأحياءِ وبُيوتِهم سوِّيَت بالأرض، يَعودُ من جديدٍ لتدبّ فيهِ الحياة، ويُعلِنُ بِكلِّ قوَّةٍ أنَّ هذهِ الأرض، وتلكَ القُدسِ المُحتلَّة التي تَظهرُ لنا من بعيدٍ هي قريبةٌ وستعودُ مجدّدًا لأهلِها وأصحابِها”. وِفقًا لِما نَشرَ بِصحيفةِ البوَّابة نيوز. بدأَ أبو اشتيَّه بِعُمرِ التَّاسعةِ بِهوايةِ رسمِ الحيواناتِ كما كُلُّ الأطفالِ في عُمرِه، ثمَّ الطبيعةُ فالوجوه. يَتذكَّرُ مُمازِحاً أنَّهُ اختصَّ بِرَسمِ العُيونِ تَحديداً، لشدَّةِ تأثُّره بِمقالٍ في إحدى الصَّفحاتِ عُنوانه: “العينان مرآة النفس”.
لأن الصمود لا يكون بالصاروخ والبندقية وحدها، كان الفن عاملاً مساهماً وداعماً للفكرة ذاتها، ولا بد من أن الجملة هذه قيلت آلاف المرات، لكنها ما زالت شديدة الدقة في وصف الحالة الفلسطينية تحديداً. تأتي لوحات عماد أبو اشتيه تكريساً لذلك. الفنان الفلسطيني الأردني لم يعرفه رواد الشبكة العنكبوتية إلا أخيراً من خلال لوحته التي تجسّد بناءً مهدّماً متجسداً داخل جسد امرأة ترتدي الثوب الفلسطيني التقليدي. اللوحة تحوّلت فجأة إلى «كنزٍ» معنوي لمتابعي شبكات التواصل، فتناقلها الجميع وتبادلوها، وإن لم يعرف كثيرون من هو صاحبها. انتقد الفنان، لإغفال اسم الصاحب اللوحات الفنية التي تناقلت بكثرة على مواقع التواصل،موضحاً أنه لم يشارك بأي منافسات لاستحقاق أي جائزة على هذه اللوحات.
حول رسومات “عماد” التي تحتوي عل الطابع الأنثوي ودلائل استخدم هذا الطابع، قال الفنان إن المرأة هي العنصر الفعال الأكبر في المجتمعات فإذا اردنا أن نخلق مجتمعاً واعاً مثقفاً ومتعلم، علينا أن نبدأ بتعليم المرأة، مبيناً أن حضور المرأة في اعماله أكثر من الرجل، للتقدير الذي لابد أي يقدمه لها خصوصاً حينما يتعلق الموضوع بفلسطين. لكن يقول عن نفسه: لا أجيد الحديث عنها (أعماله) لأنّها بكل بساطة تتحدث عن نفسها وتخاطب الصغير والمسن، الميكانيكي والدكتور، الأمّيْ وأستاذ اللغة. لو أجمع النقاد على عمل من أعمالي، وجاءني عامل نظافة ليقول: “أنا مش حاسس فيه”، حينها أعتبر أنّ العمل لم يرق إلى المستوى المطلوب. أما بالنسبة للمدرسة الفنيّة التي ينتمي إليها، فيقول أبو اشتيه: أنظر إلى الكثير من المدارس الفنيّة ولا أرى نفسي مقيداً في مدرسة ما، فأنا أحب السريالية والفانتازيا والكلاسيك والرمزية وغيرها، وأرى أعمالا أو لوحاتي، أحياناً خليطا من هذه المدارس، فأنا أرسم ما يمليه عليّ إحساسي، وأحياناً ينتابني شعور بضرورة طرح موضوع يشغلني، أشعر أنه لا يمكن تفريغ ذلك إلا من خلال السريالية أو الفانتازيا، فأقوم بتنفيذه.
 عن مشاريعه المستقبلية، يقول: “لا مشاريع لديّ لأنني أنظر لما يحدث حولنا بمتغيراته فأجد أنه لا يمكن التوقع بنجاح مشروع ما أو فشله، لذلك فمواكبة ومتابعة ما يحدث ينقلني للمستقبل بكل مشاريعه وتفاصيل يومياته”. يرى أبو اشتيه أن الريشة للفنان المتفرغ كالماء والهواء وهي القلب النابض الذي يزوده باحتياجاته الحياتية، وبالنسبة له كفنان غير متفرغ، فالريشة هي مُتنفس يحاول من خلاله ترجمة ما يحدث حولنا إلى ألوان مرسومة أو نقل صورة ما قاتمة إلى صورة ما مُشرقة، وليس بإمكانه اختيار اللوحة الأجمل فكل ما يرسم يشكل جزءاً لا يتجزأ من أحاسيسه وانفعالاته الشخصية. أما عن الصعوبات التي واجهها في حياته فهي نادرة لأنه غير متفرغ للفنّ، ولو لم يكن في مجال الفن لاختار أن يكون في مجال الموسيقى، ولكنه الآن وحين أصبح اسمه معروفاً ضمن محيطه العربي، فهو يفخر بأن كثيراً من لوحاته أصبحت مُعلقة في متاحف لبنان وبريطانيا ومقتنيات شخصية، وأن هناك الكثير من الشعراء والكتّاب قد استخدموا لوحاته كأغلفة لكتبهم.
عن مشاريعه المستقبلية، يقول: “لا مشاريع لديّ لأنني أنظر لما يحدث حولنا بمتغيراته فأجد أنه لا يمكن التوقع بنجاح مشروع ما أو فشله، لذلك فمواكبة ومتابعة ما يحدث ينقلني للمستقبل بكل مشاريعه وتفاصيل يومياته”. يرى أبو اشتيه أن الريشة للفنان المتفرغ كالماء والهواء وهي القلب النابض الذي يزوده باحتياجاته الحياتية، وبالنسبة له كفنان غير متفرغ، فالريشة هي مُتنفس يحاول من خلاله ترجمة ما يحدث حولنا إلى ألوان مرسومة أو نقل صورة ما قاتمة إلى صورة ما مُشرقة، وليس بإمكانه اختيار اللوحة الأجمل فكل ما يرسم يشكل جزءاً لا يتجزأ من أحاسيسه وانفعالاته الشخصية. أما عن الصعوبات التي واجهها في حياته فهي نادرة لأنه غير متفرغ للفنّ، ولو لم يكن في مجال الفن لاختار أن يكون في مجال الموسيقى، ولكنه الآن وحين أصبح اسمه معروفاً ضمن محيطه العربي، فهو يفخر بأن كثيراً من لوحاته أصبحت مُعلقة في متاحف لبنان وبريطانيا ومقتنيات شخصية، وأن هناك الكثير من الشعراء والكتّاب قد استخدموا لوحاته كأغلفة لكتبهم.
يقدم الفنان عماد نصيحته للناشئين من الفنانين فيقول: دائماً أردد مقولة أحبها وهي: إن لم تتأثر لن تؤثر أبداً، فعلى سبيل المثال إن لم يتأثر الفنان بما يحدث حوله ولم يضع إحساسه بصدق في لوحته فلن تؤثر بمن ينظر إليها، ستكون مجرد ألوان خالية من أي رسالة أو مضمون أو تأثير، فالإحساس هو هالة من الطاقة تفرغ في اللوحة ومن ثم تنتقل إلى المتلقي، الذي يراها بمنظور آخر مكمّل لرؤية الرسّام الذي رسمها، فهناك تبادل يجب أن تكرسه حرفة الرسم بين الأشخاص، لتصل الرسالة أو المُتعة باللوحة إلى أبعد ما نريد.  من أبرز الأعمال الفنية المعروضة لوحة “وفاة طفل” للفنان محمود صبرى، وتقدر بـ891 ألف جنيه إسترلينى.
من أبرز الأعمال الفنية المعروضة لوحة “وفاة طفل” للفنان محمود صبرى، وتقدر بـ891 ألف جنيه إسترلينى.

 رائد فن الباستيل الفنان الكبير محمد صبرى، ولد عام 1917، في مدرسة عباس الابتدائية الأميرية، وحصل على دبلوم فى العلوم الاجتماعية من إنجلترا عام 1949 كان محمد صبري يملأ كراسة الرسم بكل ما يراه فتزين صفحاتها في النهاية حجرة الناظر لتكون أول معرض له وهو في العاشرة. يشير إلى ذلك بقوله: كانت المدرسة بالسبتية وما زالت قائمة للآن. كانت تمثل نموذجا فريدا في الانضباط والنظام. كنا ندرس الإنجليزية من السنة الأولى وكنت أتبادل التفوق مع المرحوم د. محمد عماد إسماعيل أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس. اطلع الأول في شهر وهو في الشهر الذي يليه. وتكون الجائزة عادة مجموعة من الكتب بالإنجليزية والفرنسية برسوم بديعة وألوان زاهية تحتوى قصصا من أدب الأطفال العالمى مثل “اليس في بلاد العجائب” و”سندريللا” و”الأميرة والأقزام السبعة”. وكنت أنقلها طبق الأصل مع ما أراه من صور حية في مولد سيدي أبوالعلا في كراسة خاصة. وفي يوم من الأيام رآها مدرس الفصل فتعجب ومن فرط دهشته أخذها إلى ناظر المدرسة الذي أمر بعمل معرض من تلك الرسوم داخل حجرته وكان أول معرض لي وأنا في العاشرة!
رائد فن الباستيل الفنان الكبير محمد صبرى، ولد عام 1917، في مدرسة عباس الابتدائية الأميرية، وحصل على دبلوم فى العلوم الاجتماعية من إنجلترا عام 1949 كان محمد صبري يملأ كراسة الرسم بكل ما يراه فتزين صفحاتها في النهاية حجرة الناظر لتكون أول معرض له وهو في العاشرة. يشير إلى ذلك بقوله: كانت المدرسة بالسبتية وما زالت قائمة للآن. كانت تمثل نموذجا فريدا في الانضباط والنظام. كنا ندرس الإنجليزية من السنة الأولى وكنت أتبادل التفوق مع المرحوم د. محمد عماد إسماعيل أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس. اطلع الأول في شهر وهو في الشهر الذي يليه. وتكون الجائزة عادة مجموعة من الكتب بالإنجليزية والفرنسية برسوم بديعة وألوان زاهية تحتوى قصصا من أدب الأطفال العالمى مثل “اليس في بلاد العجائب” و”سندريللا” و”الأميرة والأقزام السبعة”. وكنت أنقلها طبق الأصل مع ما أراه من صور حية في مولد سيدي أبوالعلا في كراسة خاصة. وفي يوم من الأيام رآها مدرس الفصل فتعجب ومن فرط دهشته أخذها إلى ناظر المدرسة الذي أمر بعمل معرض من تلك الرسوم داخل حجرته وكان أول معرض لي وأنا في العاشرة!
هنا يتذكر محمد صبري بائع البراويز الذي كان يأتى إليه الهوانم من الزمالك أثناء التنزه عبر كوبري ابوالعلا. يأتين لشراء تصاوير شعبية أو تزيين صور العائلة في إطارات مذهبة. وكان الكوبرى نقطة التقاء وتجمع أولاد الذوات مع أولاد البلد. ويضيف: وكانت سينما رويال هنا بمنطقة ابوالعلا مسرحا شعبيا شاهدت فيه عرضا بديعا للكلاب في أزياء مبهجة الطراز، تكاد تضىء من شدة لمعانها. يكبر محمد صبري وتكبر معه موهبته ويلتحق بالمدرسة العليا للفنون التطبيقية. وهناك يتلقى تعاليم الفن ومدارسه على يد أساتذة كبار مثل محمد عزت مصطفى وحسني خليل وأحمد راغب. في عام 1936 بدأ نشاطه في الحركة الفنية باشتراكه بلوحتين في معرض صالون القاهرة السادس عشر الذي تنظمه جمعية محبي الفنون الجميلة. وكان يرأسها محمد محمود خليل بك. اشترك وهو مازال طالبا بالفنون التطبيقية. كما حرص على المشاركة في هذا الصالون لعدة سنوات بجانب أعمال رواد الفنون الجميلة الأوائل: محمد حسن، وراغب عياد، وأحمد صبري، ومحمود سعيد، مع الفنانين الأجانب المقيمين بمصر، مما زاد ثقته بقدراته الفنية.
 وفي عام 1937 تخرج الفنان محمد صبري، وكان الأول على دفعته. وقد نشرت صحيفة الأهرام صورة فوتوغرافية له وهو يرتدى الطربوش، وذلك بصفحتها الأولى تقديرا لنبوغه وتفوقه. وظل محمد صبري يمارس الفن بقوة وانقطاع دائم. وأقام أول معرض خاص لأعماله عام 1943 بقاعة جولدنبرج بشارع قصر النيل. وعندما زاره الفنان الرائد أحمد صبري أعجب بأعماله ودعاه ليلتحق بالقسم الحر المنشأ حديثا في ذلك الوقت بكلية الفنون الجميلة تحت إشرافه، وقد لبى دعوته في نفس العام. وجاء معرضه الثاني في عام 1946 بقاعة فريدمان بشارع قصر النيل أيضا ومن بين لوحاته التي قدمها بالألوان الزيتية والباستيل لوحة “الزوجة الشابة” و”شارع البحر” و”نصف الليل” و”الدرس الديني” و”صباح الخير” و”السائل”. سجل بريشته منظر تلك الزوجة الشابة التي طال انتظارها لزوجها فوقفت تطل من النافذة ليلا ترقب عودته في رداء يموج بألوان زاهية، ومن خلفها ضوء ينبعث من حجرتها يشعر المشاهد بالفرح الحديث العهد. فيما يبدو عليها القلق على زوجها الذي لم يعد إليها بعد. أما لوحة “الدرس الديني” فتصور في جو من الصفاء والتألق الصوفي مساحة من الخشوع داخل المسجد. يطل منها الشخوص بعيون ملؤها الدهشة تسمع وتعي وتنصت.
وفي عام 1937 تخرج الفنان محمد صبري، وكان الأول على دفعته. وقد نشرت صحيفة الأهرام صورة فوتوغرافية له وهو يرتدى الطربوش، وذلك بصفحتها الأولى تقديرا لنبوغه وتفوقه. وظل محمد صبري يمارس الفن بقوة وانقطاع دائم. وأقام أول معرض خاص لأعماله عام 1943 بقاعة جولدنبرج بشارع قصر النيل. وعندما زاره الفنان الرائد أحمد صبري أعجب بأعماله ودعاه ليلتحق بالقسم الحر المنشأ حديثا في ذلك الوقت بكلية الفنون الجميلة تحت إشرافه، وقد لبى دعوته في نفس العام. وجاء معرضه الثاني في عام 1946 بقاعة فريدمان بشارع قصر النيل أيضا ومن بين لوحاته التي قدمها بالألوان الزيتية والباستيل لوحة “الزوجة الشابة” و”شارع البحر” و”نصف الليل” و”الدرس الديني” و”صباح الخير” و”السائل”. سجل بريشته منظر تلك الزوجة الشابة التي طال انتظارها لزوجها فوقفت تطل من النافذة ليلا ترقب عودته في رداء يموج بألوان زاهية، ومن خلفها ضوء ينبعث من حجرتها يشعر المشاهد بالفرح الحديث العهد. فيما يبدو عليها القلق على زوجها الذي لم يعد إليها بعد. أما لوحة “الدرس الديني” فتصور في جو من الصفاء والتألق الصوفي مساحة من الخشوع داخل المسجد. يطل منها الشخوص بعيون ملؤها الدهشة تسمع وتعي وتنصت.
وتتنوع اللوحات تعكس الحس الاجتماعي ونبض الشارع المصري كما في لوحته “صباح الخير” التي صور فيها الريفيات بملامح الحسن يقبلن كالفراشات على ملء الجرار، من حنفية المياه التي يقف عليها شاب ريفي يتبادلن معه الحديث. وقد صورهن بألوان هادئة منسجمة ترتعش على سطح اللوحة توحي بالحيوية والبهجة والإشراق مع أول خيط من خيوط الفجر. وقد عالج موضوع “السائل المحروم” بألوان في تركيبات مؤكسدة ذات صبغة خضراء معتمة يسودها الشحوب بإحساس شاعري يفيض بالشفقة. في هذه الأثناء أقامت كلية الفنون الجميلة مسابقة فنية والفائز فيها يمنح بعثة لمدة عامين بمرسم الأقصر. تقدم صبري بلوحة “النحاسين” وهي لوحة صرحية ضخمة ومعها 16 دراسة للوجوه والأشخاص بحركاتهم المختلفة، وهي لوحة برهن فيها على أنه فنان بارع في توزيع الضوء الذي ينبعث متوهجا لينعكس بنسب مدروسة على العاملين بالنحاس، في تكوين رصين متكامل تذكرنا أضواؤه الملتهبة وألوانه الدافئة بسحر الأضواء والظلال للفنان الهولندي رمبرانت أشهر من روض الضوء.
قد أثارت إعجاب الأستاذ يوسف كامل عميد الكلية في ذلك الوقت والأستاذ أحمد صبري رئيس القسم، والذي علق عليها بقوله: إنني أشعر بحرارة وصهد النار حين أشاهد هذه اللوحة. وفاز أحمد صبري ببعثة مرسم الأقصر. وكان يقضي الشتاء هناك، أما الصيف فيقضيه بالقاهرة في منزل أثري بحارة “حوش قدم” بين التراث الإسلامي والحياة الشعبية. في الأقصر كانت معابد الكرنك تتلألأ بشمس الصباح وتنحسر أضواؤها بين جنبات وادى الملوك عند الغروب. فبهرته الآثار الفرعونية والأضواء التي تتكسر على أعمدتها والمناظر الطبيعية هناك .. للنيل وزوارقه والحياة الشعبية والاجتماعية. وقد صور كل هذا في لوحات كثيرة “معبد الرمسيوم بالأقصر”، و”العودة” لفلاح يحمل فاسه، و”بصرة” لمجموعة من الفلاحين يلعبون الكوتشينة، و”ساقية ابو حنفي” بالأقصر و”دودة القطن التي تصور مأساة فلاح مع ضياع جهوده وآماله وخسارة القطن، و”وابور الطحين” لفلاحات بين جالسة وواقفة بسلال الحبوب في انتظار الطحين.
البطل في كل هذه اللوحات هو الضوء. ضوء مصر الذي يتألق في أبهى صورة في جنوب الوادي ينساب في الأماكن والزوايا والمساحات والمسافات التي تروي قصة حضارة عريقة قامت على ضفاف النيل الخالد. وفي فترة إقامته بـ “حوش قدم” صور قاهرة المعز بمذاقها الشعبي العتيق ومآذنها وقبابها المغلفة بظلال المغيب. في لوحات عديدة تبدت فيها قدرته على التقاط الصور والجزئيات والتغلغل في أعماق الحياة. وتصور أجمل ما فيها بجانب إحساسه اللوني البالغ الرهافة وحرصه الشديد في توزيع الضوء بحساب دقيق، وقد ساعده في ذلك دراسته للتصوير الضوئي في كلية الفنون التطبيقية. وقد استهوته المناظر وأصبحت عالمه المفضل.
رزان الظاهر